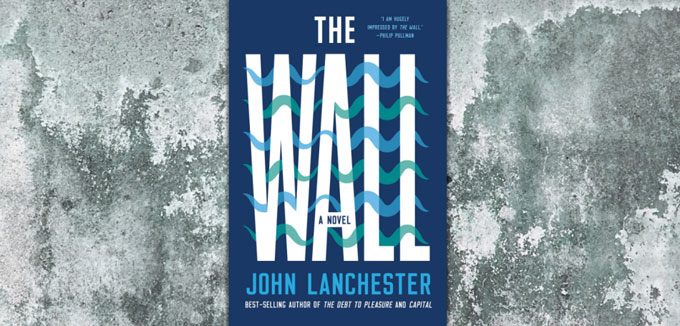على امتداد التاريخ الإنساني كانت الهجرة هي التعبير الشجاع عن عزم الأفراد على تجاوز الصعاب. هكذا وضعت الأمم المتحدة تعريفًا لذلك السعي الذي يضطر إليه بعض البشر في سبيل الوصول إلى الأفضل. ذلك الأفضل الذي يواجهون في الطريق إليه مختلف ألوان المعاناة. وهي معاناة وإن اُختلف على بداياتها فقد تفاقمت في السنوات الأخيرة ووصلت إلى حد لا يمكن معه إلا الاعتراف بـ 18 ديسمبر يومًا دوليًا للمهاجرين.
مع كل ما تشير إليه الأشهر القليلة الماضية من دور في مواجهة فيروس كورونا تصدره المهاجرون في البلاد التي ارتحلوا إليها. يبقى لهجرتهم وجه آخر، قد لا تستعوبه أرقام الإحصائيات حول مآسيهم. بينما تضمه كتب الأدب في طيات صفحاتها. تتحدث عن العذابات واشتباكها مع واقع عاناه ولا يزال يلاقيه 272 مليون إنسان، دفعتهم الظروف دفعًا نحو رحلات رحيلهم عن أوطانهم.
أدب الهجرة.. فن نضالي
لأدب الهجرة ميزة تحرير الرواية من رتابة النظام البلاغي المجرد. فهو يدفع بالأساليب الإبداعية إلى حيز المعيشة ومعطيات الحياة وملامسة الهم الإنساني اليومي في البلاد الغريبة على الوافدين إليها. وقد نجح أدب الهجرة في خلق فضاء للتعبير العمومي، ليس بعيدًا فقط عن قضايا السياسة والاقتصاد الجامدة. وإنما عن رهانات الحياة بشكل عام. وذلك في قالب إبداعي حوّل الكتابة في أحيان عدة إلى “فعل نضالي”.
شكل أدب الهجرة نهج شديد الأهمية ساهم في إثارة قضايا اللجوء وأزمات المهاجرين، والبحث عن حلول إنسانية لها. واستخدم في ذلك أشكال أدبية روائية وشعرية، برعت في ربط الخيال بالواقع، ودمجت الماضي بالحاضر، متسلحة بقوة الكلمات وقدرتها على جمع المبعثر بالواقع المؤلم لكثير من البشر، ممن وجدوا أنفسهم وأبناءهم أمام أزمة الترحال والإندماج والخيبات الثقافية والحضارية بفعل الاستعمار والشتات.
وهنا، يضعنا أدب الهجرة أمام معادلة فريدة، بـ”التفكير بالمهجر وليس في المهاجر”، عبر إبداع حاول أن يكون بمثابة “فعل تغيير” لا “فعل تعبير”.
الأديب السوداني الطيب صالح: “كتبت حتى أقيم جسرًا بيني وبين بيئة افتقدتها”
الجدار.. أسوأ كوابيس الهجرة
في أوائل الشهر الجاري، صدرت عن دار “الرافدين” في بيروت، ترجمة حديثة لرواية “الجدار” لمؤلفها الإنجليزي جون لانكستر. وقد نقلتها إلى العربية المصرية إيناس التركي. وهي واحدة من أكثر روايات أدب الهجرة سوداوية وكابوسية. تعرض لثلاثة فصول في حياة بطلها “كافاناه”.
“الجدار” وهو ذلك المكان الصلد الخرساني، الذي يلتف بطول ساحل البلد الخيالي حيث تدور أحداث الرواية. والذي يحرسه “كافاناه” وجنود دُفعوا إلى التجنيد لحراسة الجدار مثله.
و”الآخرون” فصل ثان في الرواية، عن هؤلاء اليائسين التائهين وسط البحار الهائجة والذين يحاولون الوصول إلى “أرض الجدار”. آخر ما تبقى من يابسة هذا العالم. بينما الفصل الثالث ذلك البحر الذي يبتلع من الجانبين؛ الساعين نحو لحظة حياة مستحيلة في “أرض الجدار”، والجنود الذين أخفقوا في حراسته على حد سواء.
و«البحر»، وكل عنوان هنا يشي بتطور جديد في حركة الحكاية، فالجدار هو المكان الصلد الخرساني الذي يلتف بطول ساحل البلد الخيالي الذي تدور فيه أحداث الرواية، حيث يتم تجنيد أمثال «كافاناه» لحراسته في ورديات متصلة ليل نهار، والدفاع عنه ضد هجوم اليائسين التائهين وسط البحار الهائجة في محاولة للوصول إلى ما تبقى من أرض يابسة في العالم أو أرض «الجدار»، فهؤلاء اليائسون هم «الآخرون»، وهم الأعداء الذين يقوم مجندو الجدار بالتدريب لساعات لمواجهتهم، إذا قاموا بالاقتراب من الجدار وعالمه البارد.
رغم سوداويتها، نالت رواية “الجدار” احتفاءً نقديًا كبيرًا، إذ نجح كاتبها في دق ناقوس خطر لما نحن بصدد معايشته من موجات هجرة اضطرارية قد يحدثها تغير مناخي وأمور أخرى، تدفع جميعها بالبشرية إلى مستقبل مظلم، أظهر لانكستر في روايتها أسوأ صوره.
حينما ترك العرب أدب الرحلة
يمكن اعتبار مطلع القرن العشرين، بمثابة سطوع شمس أدب الهجرة. وذلك في أعقاب ضلوع حركة الاستعمار في احتلال بقاع كثيرة من العالم النامي. هذا الأمر دفع الجموع بمن فيهم من المبدعين جبرًا إلى الهجرة وطلب اللجوء. حيث تعرضت الكثير من الجماعات العربية للتهجير القسري، نتيجة التمييز العرقي أو الديني. وشرع الكثير من الكتاب العرب في الهجرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وهي محطة بدأ معها الانفصال نحو أدب جديد مأساوي يختلف عن الشكل التقليدي لأدب الرحلة. المعروف بطابعه التوثيقي الاكتشافي السعيد لأرض جديدة.
وقد ترافق مع ظهور هذا الأدب الجديد الذي عُرف لاحقًا بأدب المهجر بروز مفهوم فلسفي أثرى الإبداعات الأدبية. وهو مفهوم “فكر المنفى” بكل مقتضياته ومعطياته، التي رسخت لمنظور خاص للعالم، يخيم عليه الإنكسار والهزيمة والطوق إلى العودة. الأمر الذي لاقى صدى بالكتابات الأدبية. إذ وضعت الفلسفة أسس مفاهيمية للصراعات الوجودية، فتلقاها الأدب في صورة صراعات ثقافية أسست لأزمات الهوية وصراع الحضارات والأديان. وكل ذلك انصب إجمالاً في خانة تدوين الهموم اليومية للكتاب المغتربين في المدن الأجنبية.
فكر المنفى وأزمات الهوية
بالنظر إلى ما أطلق عليه “أدب المهجر” فإننا نجد حضوره قويًا في مدرسة المهجر في الأدب العربي. وهي التي انبثقت عنها عدة روابط أدبية، كان أشهرها وأكثرها استمرارًا، الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية. حيث كان رموز كل اتجاه وأعلامه هم الأشهر وسط المهجريين. وعرِف من أعضاء الرابطة القلمية جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبوماضي، ورشيد أيوب ونسيب عريضة.
وقد خاضت الرابطة القلمية رحلة سبر أغوار الحياة وتأملها خلال تأمل النفس البشرية ومراقبتها على عواهنها. ومن هنا كانت العناصر الإنسانية جلية في سمات أعمالهم وإنتاجاتهم. وهي الميزة التي قد أسبغت على أدبهم وغرست في نفوسهم نتيجة معاناتهم في الغربة والتعلق بأوطانهم.
وأبرز ما يتضح حين نقوم بتفكيك أيٍ من أعمال المهاجر، هو الحضور القوي والطاغي للـ”طبيعة” والامتزاج بها. وأيضًا بث روح الحياة في مظاهرها. فكانت تقلبات ومناظر الطبيعة هي الصور المعبرة بحق عما يجول بخواطرهم ويدور في نفوسهم وعقولهم من مشاعر الخوف والحب والراحة والقلق والسعادة. ومثال ذلك ما تغنى به جبران خليل جبران في قصيدته المواكب بحياة الغابة، وما فيها من صفاء وراحة.
وحديثًا، عاود الإبداع في أدب المهجر الظهور بكثافة خلال العقود الأخيرة، حيث سافرت مجموعة كبيرة من الأدباء، تاركين أوطانهم في مختلف الأقطار العربية، بسبب ظروف الحرب ونزعات الاضطهاد السياسي والعرقي وصعوبة التعايش تحت وقع التفجيرات وأصوات الرصاص في العراق ولبنان. الأمر الذي بلوره وبرع في التعبير عنه المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، الذي اكتمل “فكر المنفى” في كتاباته. وخلق من المنفى والترحال موقفًا أدبيًا وإبداعيًا واجه به عالم متخبّط في أزمات الهوية.
المفكر والمنظر اللبناني ميشال شيحا: “بدون هجرة لا يمكننا الحياة، لكن إذا أضحت الهجرة كبيرة فيمكن عندها أن نموت”
باريس واللاجئين.. رماد تناثرت معه المصائر
في نوفمبر الماضي، صدر كتاب “باريس الوجه الأسود للاجئين” للسودانى الطيب محمد جادة، الذي رصد في 100 صفحة قسوة الظروف الإنسانية التي يعيشها اللاجئون في فرنسا. ليظهر أوجه التناقض بين الأحوال على الأرض وما تظهره الآلة الإعلامية الجبارة عن أرض الفن والجمال. وقد استخدم في كتابه كافة الأدوات الأدبية التي أظهر بها شخصيات حقيقية عاشت معاناة الهجرة واللجوء.
يذكر المؤلف الطيب محمد جادة أن كلمة الهجرة باتت الأكثر تداولاً بين الشباب وعلى رأس طموحاتهم. وأن أحلامهم الوردية يتم تلخيصها في السفر إلى عالم ما وراء البحار. وأن دور الأدب في هذه الحالة، هو نسج القصص الإنسانية ونقل معاناة أجيال كاملة تهاب المستقبل، وتشعر بأن أحلامها ووظائفها وأسرها قد تم نسفها، وأن نيران الحرب جعلت من قواربهم رمادًا تناثرت معه مصائرهم.
الهجرة.. سمة عربية وشعر مرتحل
كان الشّعر هو ديوان العرب، دون باقي الفنون من النحت والعمارة والمسرحية. وهي الأشكال التي قامت عليها باقي الحضارات القديمة. لكن الشعر فله خصوصية عند هؤلاء الذين سكنوا الشرق الأوسط، لارتباطه بمكونات الهجرة وحياة الترحال والتنقل الأساسية في تشكيل الشخصية العربية. ومن هذا المنطلق برز ما يمكن الاتفاق على تسميته بـ”أدب الهجرة”.
برع العربي في صياغة “أدب الهجرة” لطبيعته المرتحلة التي تهوى حمل فكرها معها أينما ذهبت. لذا جاء الشعر متمتعًا بالقدرة على حفظه بسهولة وبشكل متاح لكل عربي في الصحراء، لتنطوي تحت لواءه باقي القنون من موسيقى وغناء وتمثيل مسرحي. وهو ما لا يمكن إخفاءه عن مطالع القصيدة العربية القادرة دومًا على تحريك العنصر التراجيدي الذي أصّله الترحال في كينونة العربي.
وقد ارتبط صعود وذيوع “أدب الهجرة” لدى العرب بامتداد الفضاء الإمبراطوري الإسلامي، واتساع مساحة الدولة وكثرة الأسفار. حيث كان هذا الفضاء الشاسع الحديث مؤديًا بشكل طبيعي لظهور الكثير من الأنساق المعرفية. ومنها سياق تاريخي ازدحم بمؤلفات رحلات “ابن بطوطة” والحسن بن فضلان، وحسن الوزّان (ليون الإفريقي)، الذين عززوا من الأدوات المعرفية المعاصرة حينها.
ومن عجائب المفارقات، أن الرحلة والهجرة كانتا علامات قوّة وهيمنة في العصر الإسلامي الأول، قبل أن تتبدل بشكل غريب لتصبح علامة ضعف وأزمة إنسانية وتاريخية في العصر الحديث.
وهذا كله ينقلنا على الفور إلى تجليات “أدب المهجر” مطلع القرن العشرين، كنتيجة مباشرة للتهجير الجماعي الذي تعرّضت له أقليّات دينية وثقافية عربية، جرى نفي العديد من كتّابها إلى روسيا والدول الغربية، فسطرت هناك ملاحم من الإبداع وتجارب الهجرة.

ظاهرة ثرية
رغم ما أفرزه أدب الهجرة من أعمال مميزة لجيل سابق من الكتاب، منها “عصفور من الشرق” لتوفيق الحكيم، ومؤلفات لأنيس منصور، و”موسم الهجرة” للطيب صالح، و”الأيام” لطه حسين. يبقى مفهوم الارتحال في الأدب الحديث ذو طابع أكثر حيوية، يتلمسه القارئ في عديد من المحطات كرواية اللبنانية حنان الشيخ “إنها لندن يا عزيزي”. وكذلك في المجموعة القصصية الخاصة بالكاتب الجزائري عبد الحميد بن هدوقة، والتي تناولت هجرة العمال الجزائريين إلى فرنسا. وأيضًا كتاب العراقي صموئيل شمعون، الذي يتحدث عن حياة المهمشين والفقراء في باريس.
والهجرة هنا لا تقتصر على الارتحال من بلاد العرب إلى الغرب، بل بعضها يكون من وطن عربي إلى آخر. كما صوّر الأديب المصري إبراهيم عبد المجيد في تحفته الأدبية “البلدة الأخرى”. والتي تناول فيها سردًا ليوميات المصريين والمهاجرين بشكل عام في مدينة تبوك السعودية، قدم الأديب المصري فيه وصفًا ساحرا وبارعًا لطبقات المجتمع السعودي والمجتمع الموازي من المهاجرين الهنود والعرب، والعلاقات بين الجانبين.
أيضًا، لا يمكن إغفال رواية “رجال تحت الشمس” لغسان كنفاني، التي أبدعت في معالجة تيمة مغامرة مجموعة من الفلسطينيين يحاربون للذهاب إلى الكويت. وذلك بخلاف كتب تناولت هجرة العرب إلى أفريقيا، مثلما فعل عباس بيضون في رواية “تحليل دم”، التي تطرق فيها إلى تفصيلات مبهرة عن لبنان وأفريقيا، وما كتبه اليمني أحمد عبد الولي في “يموتون غرباء” عن الجالية اليمنية المستقرة في إثيوبيا.
تفاوت الأجيال
كما هو ملحوظ، فإن هناك أجيال مختلفة عبرت بصدق عن تجارب هجرتها وترحالها. لكن المتتبع للأجيال القديمة والمعاصرة، يرى في أصحاب الأعمال المبكرة ميل ونزوع إلى تلوين أعمالهم بصبغة غلبت عليها صورة الضعيف المنبهر بالقوي، أو الغارق في المقارنات الساخطة، أو المتفجر بشحنات تغذيها الرغبة في الانتقام من مستعمر ما يزال جاثم على صدره. الأمر الذي شهد تحول على مستوى الكتابة والمعالجة والرؤية، حتى وإن كان القالب هو نفسه الذي يتحدث عن الهجرة.
وفق هذه الملاحظة، فإن الأجيال الأحدث تغيرت كتاباتها، بعدما صار للكاتب أو المتلقي فكرة مسبقة عن البلدان التي يكتبون منها. وكان لوسائل الإعلام الأثر الأكبر على نوعية أدب الهجرة. حيث خففت من وقع صدمة الاختلاف، حتى وإن كانت هناك أزمات جديدة تطل برأسها تؤرق الأدباء وتطغى على أعمالهم.