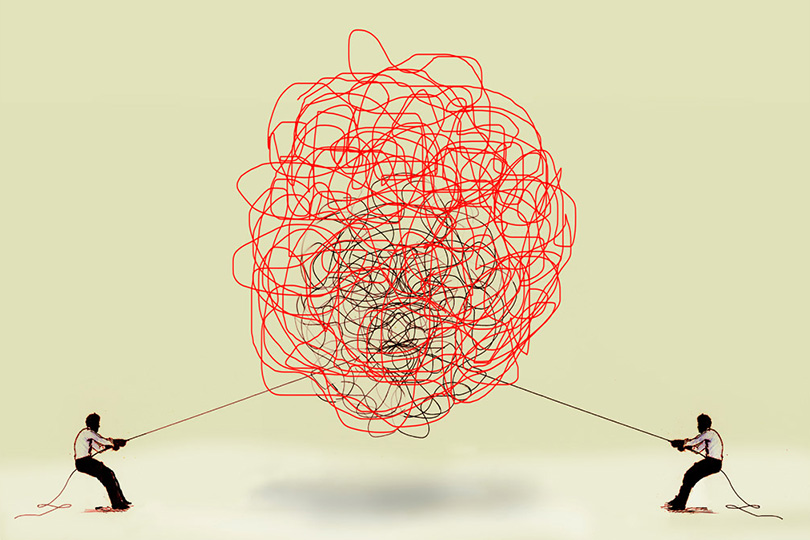منذ بدايات القرن التاسع عشر والحديث عن تجديد المجتمع وتحديثه حديث لا ينقطع، ويشغل صراع الهويات مساحات كبيرة من الفضاء الفكري، في أوساط المفكرين وأولوا الأمر، وكذلك في أوساط (رجل الشارع). احتدمت النقاشات بين مؤيد ومعارض، واتخذت المواقف، وعلت الأصوات، ومازال الأمر ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين محتدما، بل لعله أكثر حدة واستعارا.
ربما كان السبب وراء هذا أننا ولهذه اللحظة لم نتخذ موقفا واضحا، إزاء قضايانا الرئيسية وكأن كل جيل من الأجيال يشفق على نفسه من اتخاذ مواقف نهائية وحاسمة، ويرجئ لمن بعده اتخاذ مثل هذه المواقف. ففي كافة المجتمعات تناطح الجديد والقديم وتصارعت معطياتهما بأسلوب أو بآخر، أما في المجتمعات العربية فلقد ظل القديم والجديد متجاورين بلا تفاعل حاسم كالماء والزيت في كوب واحد.
ربما يؤثر أحدهما على الآخر قليلا ولكنهما منفصلين في معظم الأحوال، ويسهل على المرء فصلهما في كل الأحوال، وهو الأمر الذي أدى بدوره لتراجع واضح في كثير من القضايا والمشكلات، فيعاد فتح ملفاتها من جديد، وكأن النضال السابق جميعه ما كان له وجود ذات يوم، والسبب الواضح وراء ذلك ــــ فيما أظن ــــــــ هو الحلول المائعة التي من شأنها أن تجنب صاحبها عناء المواجهة والتحدي، دائما ما كانت تنجح هذه الحلول ونغلق الجرح على ما فيه.
يتواكب إذن القديم والجديد، وتتجاور معطياتهما، فيتحد العلم والخرافة أو يكادا، ليس في المجتمع فحسب بل في أفراده أيضا، فيلجأ الطبيب إلى المشعوذ، ويلجأ العالم إلى العراف، ولا يجد أحدهما غضاضة في ذلك، بل أحيانا ما يمارس بعض الأطباء الشعوذة، وبعض العلماء العرافة، وتختلط الأمور، ولا يجد أحد غضاضة في ذلك.
نخبئ مشكلاتنا مثلما يخبئ الأب ابنه خوفا من الحسد، (حتى تظل صورة مجتمعنا ناصعة)، وكأن أفراد المجتمع ليسوا بشرا، وكأنهم لا يخطئون، فلا نواجه مشكلاتنا، ومن ثم لا نبحث عن حلول، وتظل المشكلة قائمة في الخفاء، بل وتتفاقم، وتزداد حدتها، ونعول هذا على أسباب غير الأسباب الواقعية، فلا نصل إلى حل، وتستمر مسلسلات العجائب والغرائب، دون أن نجد حلولا ناجعة، وجميعنا متواطئ في هذا، ولا أستثني من ذلك أحدا.
ومن الغريب حقا أن ينظر البعض لهذا التجاور بوصفه استقرارا، ويرى في الصراع توترا ومشاكل، يجب أن ننأى جميعا بمجتمعنا عن مثلها، فيصبح الذين يتحدثون عن وجود مشكلات وأمراض اجتماعية داخل المجتمع، قلة لا تريد لهذا الوطن العظيم استقرارا، أناس لا يحبون وطنهم، بل أحيانا ما يصبحون مخربون لمسيرة المجتمع، ومعوقون لتطوره، ونسوا جميعا أن الاختلاف هو سنة الحياة، والسبيل الوحيد للتطور والنمو، والتعارض في الرأي لا شك أمر صحي يثري الفكر، ومن شأنه أن يصل بنا إلى حلول لقضايانا ومشكلاتنا.
ومن المهم أن نلفت النظر هنا لأهمية الثقافة ودورها على المستوى الفردي والجمعي، إذ تشكل عبر مكوناتها المتعددة جوهر الشخصية الاجتماعية للفرد والمجتمع، ولا تعنى الهوية هنا ذلك التكوين الجامد الذي ينتقل عبر الأجيال، دون أن يطرأ عليه عوامل التغيير، متحديا الزمان وتحولاته التي يطرحها عبر ملابسات التاريخ والجغرافيا، وتسم مجتمعاً ما في مكان محدد بسمات مطلقة لا يعتريها التحول. بل تعنى ذلك التكوين المنفتح الذي ينبني من جملة عناصر تنشأ نتيجة مجمل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. الخ، وعبر عوامل الدين واللغة والتاريخ، وعمليات التأثير والتأثر الفاعلة (الداخلية والخارجية) التي تساهم في تشكيل هذه الهوية. فتعطى المجتمع خصوصية وتمايزاً، من خلال عملية دينامية مستمرة، تتبدل فيها الثوابت والمتغيرات وفقاً لأولويات المجتمع، وما يواجهه من تحديات، وفقاً لمعطيات الواقع وطبيعته، وطبقاً لمواقف تعبر عن طبيعة العلاقة بين الذات الموضوع (الأنا /الآخر) وطبقاً لمواقف تعبر عن نقاط قوة أو ضعف، وتبرز إمكانات وقدرات، وتطرح بدائل تعبر جميعها عن رغبة عارمة – من قبل المجتمع – في البقاء، ورفض حاسم للاندثار أو التحلل.
إنها عملية جامعة مانعة عادة ما يؤديها المجتمع في ظروفه المختلفة، ويهدف من جرائها إلى تشكيل وعى أفراده، بالأسلوب الذي يكفل بروز بدائل عديدة ومتنوعة للوجود والاستمرار وضمان الترابط، تتخذ ملامحها في إطار الثقافة العامة التي ينمو في إطارها الفرد، وما يشتمل عليه المجتمع من نظم ومؤسسات، وتتبلور وتتضح في إطار ممارسات الأفراد خلال حياتهم اليومية وما يزاولون من أنشطة، إذا تشكل المقومات الثقافية المتنوعة عناصر الهوية الرئيسية حيث تتماس وتتعامد مع الثقافة بمفهومها العام.
ولا بد لنا من التمييز بين نوعين من خطابات الهوية لدعاة الخصوصية”، خطاب الخصوصية الثقافية المنغلقة، الذي يتمركز حول أصول ثقافية (نقية)، ويتشبث بأنساب فكرية قارة/ثابتة لرفض الآخر وثقافته المغايرة، ظناً منه أن الخصوصية الثقافية ذات جوهر خالص غير قابل للتغيير. وخطاب الخصوصية الثقافية النقدية المناوئ لنزعة التمركز الغربي، وكذلك نزعة التمركز الشرقي، بل جميع أشكال التمركز التي تلغى الآخر.
يرى في الخصوصية الثقافية مجموعة من الخصائص والسمات التي تشكلت نتيجة تفاعل عوامل مركبة، وعديدة مع الواقع المحلي/الوطني من طرف، ومع الآخر الخارجي من طرف ثان. فالخصوصية الثقافية لا تمثل جوهراً ثابتاً ولا تعبر عن معطى جاهزاً، بقدر ما ينظر إليها بوصفها حصيلة تفاعل مع متغيرات ومعطيات الواقع الثقافي المتحولة في إطار الزمان والمكان.
لا يكشف هذا الطرح السابق عن رغبة في القطيعة أو بحث في التغريب، بل عن طرح – غير وسطي – لإمكان مقبول يهدف إلى إثارة تساؤلات مشروعة حول ضرورة البحث عن رؤية جديدة لمجتمع جديد، دون أن تعترضنا معوقات الخوض في إشكاليات الأصالة ومراوغات الحداثة، باعتبارهما الاختيارين الوحيدين للتقدم، ليس تحت دعوى رفضهما، أو رغبة في التهوين من شأنهما، بل تحت زعم –قد يصدق– يؤكد وجودهما المستمر في ثنايا عملية الانتقاء التلقائية التي يقوم بها الوعي الجمعي، بغرض الحفاظ على العناصر الخاصة التي تجمع أفراده دون أن تفصلهم عن معطيات العالم والواقع.
إننا نرى العالم من منظورنا الخاص، وليس هناك شخص قادر على التأثير في رؤيتنا، ما لم نكن فارغي العقل، أو نميل قليلا إلى التشكك في رؤيتنا الراهنة، محتويات رؤيتنا، طريقة تفكيرنا، منهجيتنا التي دأبنا منذ الصغر على تكوينها، عبر آلاف المواقف، المعلومات، الخبرات، والأشخاص، كل هذا في مرحلة عمرية بعينها، حتى نتخذ قرارا ما، هنا والآن، يدفعنا إلى تكوين رؤيتنا الخاصة، والتي لا تتعلق في مضمونها، ومحتواها، ومنهجها، بما هو صحيح أو خطأ، بل بميلنا نحو طريقة تفكير بعينها، تجعلنا سعداء، أو هكذا نظن.
أحدنا يميل إلى اعتبار وتقدير المدركات الحسية ويتخذها أولوية في وضع أسس رؤيته الخاصة، بينما آخر يرى في المفاهيم العقلية المنطقية طريق للوصول إلى (الحقيقة) وهذه الكلمة هنا تعني (رؤيته الخاصة) ولا تعني شيئا آخرا، بينما يميل بعضنا إلى الحدس الروحي، يطمئن إليه، ويتوقع منه كل طيب ف الحياة.
وهكذا يختار كل منا طريقه بوصفه الطريق إلى السعادة والطمأنينة، وهما مسألتان مهمتان في تبنينا لرؤية ما، أو اتخاذنا لموقف ما، أن نكون على يقين بأنه قادر على منحنا السعادة من ناحية، وأن نكون مطمئنين لسلامة رؤيتنا ومن ثم موقفنا. وعندما أتحدث عن ميل لاتجاه بعينه/ سواء أكان ماديا، أو عقليا، أو روحيا، لا أنزع عنه بقية الجوانب، بل هي جزء لا يتجزأ من صميم مكونه العام، بل السمة الغالبة عليه تدفعه نحو اختيارات من نوع ما.