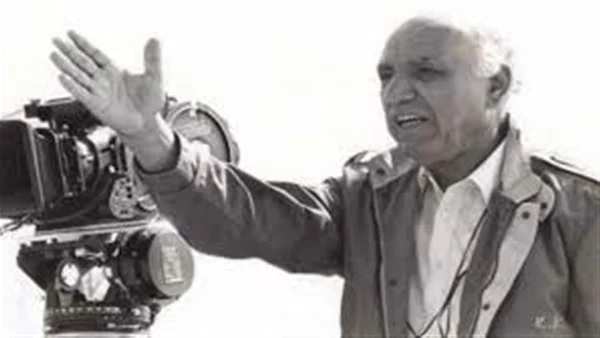كان لا يزال طفلاً صغيرًا عندما تساءل صلاح أبو سيف (1915 – 1996) بالصدفة أثناء حوار مع عائلته: لماذا لا يعطي الأغنياء ما يزيد عن حاجتهم للفقراء؟ وربما هو تساؤل فارق في فهم شخصيته؛ مؤسِس، سهل كالماء، وبسيط حد السذاجة، بعد سنوات وسنوات سيجيب على ذاته. فيقول: “لم أعرف إلا فيما بعد أن سؤالي كان أصعب سؤال واجهته البشرية طوال تاريخها الطويل. وإنه سيظل بلا إجابة شافية إلى أن تقوم القيامة”. وهي إجابة تبلورت على مدار سنوا عمره. وربما كانت سببًا في كونه أحد مؤسسي الواقعية السينمائية الجديدة في مصر.
في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 صدرت نسخ محدودة من “مذكرات صلاح أبو سيف“. التي كتبها الصحفي عادل حمودة عن تسجيلات مطولة خاضها مع المخرج الكبير لنشر سيرته وحكايات. هذه السيرة تتضمن أسرارًا تنشر لأول مرة.
هذا العام فوجئ المهتمون بسينما صلاح أبو سيف مرة أخرى بكتاب “أكثر تنقيحًا وإثراءً بالمعلومات عن الكتاب السابق”. تنشره دار “ريشة” للنشر للصحفي.
الكتاب يضم 12 فصلاً؛ يستهله الناقد طارق الشناوي الذي يحكي عن رحلته مع أستاذه عادل حموده وأستاذهما صلاح أبو سيف. ثم يعلن عن الكثير من التفاصيل وعن بداية صلاح أبو سيف وطفولته وأسباب كرهه لوالده. ثم كواليس دخوله عالم السينما. وأيضًا تفاصيل تأسيس “ستوديو مصر” والحديث عن كواليس أهم أعماله.
المذكرات باب الواقعية
ولدت لدى أبو سيف فكرة “المذكرات” التي حاول فيها أن يحكي سيرته. وذلك قبل أن تولد لديه فكرة “المواطن مصري” الذي اعتبره آخر أفلامه الحقيقة المؤثرة، متناسيًا “السيد كاف”. ليكن بذلك من بين قلة من فنانين العرب الذي لا يخجلون من نشر سيرهم الخاصة. وربما يفسّر ذلك أيضًا ولع صاحبها الشديد بالواقعية التي تعني له “الصدق مع المشاهد”، كما أكد في حوار قبل سنوات كثيرة.
رغم أن أي متابع جيد للسينما والأدب ومشاهيرهما في كل مكان سيصبح على علم أن تقريبًا ثلاث أرباع نجومهما من اختراع الصحافة أو تطريزها، فإن تجربة صلاح أبو سيف تقف ضمن تجارب قليلة هامة ومؤثرة في كل دارس ومهتم بالسينما أو بالمجتمع المصري بشكل عام. وقد يبدو من الغريب حقًا إذا لم تكن في ذاكرتك كمصري فيلم واحد من بين أفلام أبو سيف الكثيرة.
الحارة والعائلة
ولد في مايو 1915 في حارة “قسوات” (جمع قسوة) التي حملت اسمها بسبب كونها مركزًا قديمًا للتعذيب من قبل الإنجليز. يقول إن الناس في الحارة آنذاك كانوا جميعًا عائلة واحدة “لا سواتر، لا أسرار، كل شيء مكشوف، العلاقات مستوى المعيشة رائحة الجنس، ورائحة الطهي، كانوا يتضامنون في المصائب، الرحمة دستورهم”. هكذا تشكلت نظرته الأولى للمكان الذي نشأ فيه.
وُجدت المرأة في سينما صلاح أبو سيف كمحرك أساسي للأبطال والأحداث. شكّل علاقة أكثر واقعية بحقيقة تواجدها وتأثيرها في مختلف أدوارها. يقول “لقد شممت رائحة المرأة مبكرًا، ورائحة المرأة في الأحياء الشعبية نفّاذة شهية تفتح المسام وتجعل الصبي يشعر بالرجولة قبل البلوغ”. الحارة الكبيرة كانت عالم صلاح أبو سيف الحقيقي. التنقل بين هذا العالم كان مخزنه الطفولي الذي استمد منه واقعيته للسينما كأول فرسانها، وواقعية أبطاله ومركزية تواجد المرأة كمحرك للأحداث والحياة.
سألته أمه بعد المرة الأولى التي شاهد فيها فيلمًا في السينما وهو لا يزال طفلاً: “رجعت من المدرسة بدري ليه؟”. فأجاب: “خلاص مفيش مدرسة، هاشتغل مؤلف”. سيطرت السينما على عقله سريعًا في سياق حياته وزمنه الذي كان وحده الأكثر سحرًا بين كل الفنون. خصوصًا لشاب فقير يحاول الهروب من واقعه. تساءل وقتها: “كيف أصبح ذلك الرجل الذي يجلس في الاستديو ولا أحد يزعجه؟” قبل أن يصبح كذلك بالفعل.
الديكتاتور الغني في حياته
تربّى أبو سيف في بيت والدته الفقيرة التي تركت والده “الديكتاتور الغني القاسي”. كان والده “عمدة” في أحد القرى، وكان يريد أن يجبر أمه القاهرية ابنة حي بولاق الشعبي على الذهاب للقرية. لكنها ظلت رغم حرمانها وفقرها في المدينة فقط من أجل تعليم أولادها.
انقسام حياته بين والده الغني الذي يرفض الإنفاق عليه ووالدته شديدة الفقر، ولّد لديه رغبة حقيقة في محورية الحديث عن الطبقات الاجتماعية والفروقات المجتمعية الكبيرة في مصر.
تخرج في مدرسة التجارة، وكانت الكتابة وقتها في المجلات الفنية هي الخطوة الأولى في عالم الفن. ثم وُظّف كمساعد مونتير في ستديو مصر الذي أوجد للصناع المصريين مكانًا للإنتاج والعمل الفني. ذلك جعله يشاهد حوالي أربعة أفلام أسبوعيًا. وكان لديه ورقة وقلم يسجل بهما ملاحظاته الفنية. “كانت دراسة معمقة عملية وجهًا لوجه من دون معلم ولكن برغبة جادة في التعلم، وكنت إذا فاتني شيء أعود في اليوم التالي لأفحصه”. امتلك أبو سيف من وراء هذه التجربة مفكرة ضخمة وثروة من المعلومات السينمائية عن عدد يصعب حصره من الأفلام.
كانت وفيقة أبو جبل صديقته في قسم المونتاج هي التي ساندته. وقفت إلى جانبه عندما كان يدبر له البعض مؤامرات لـ”تطفيشه”. تطورت تلك الصداقة للزواج الذي استمر على مدار سنوات حياته. عناده الشديد وواقعيته التي كان يريد التأسيس لها واستكمالها جعلت في رصيده أول فيلم تمنعه الرقابة؛ “العمر واحد” الذي غيره إلى “نمرة 6” والذي بسببه اتهمه الأطباء بتشويه سمعتهم.
ساعد صلاح أبو سيف في إخراج فيلم “الحارة” الذي تحول اسمه إلى “العزيمة” وأصبح فيما بعد زاوية الواقعية المصرية وركنها الأهم والمؤسس لتاريخها الممتد.
فرنسا.. السينما والحياة
سافر صلاح أبو سيف إلى فرنسا لدراسة السينما. عرف أنهم هناك ينظرون إلينا آنذاك على أننا لا نزال نتسلق الغابة. وكان يواجه تساؤلات من نوع: هل في بلادكم سينما؟ هل تصورون الأفلام في الفيديوهات؟ هل تسمحون للمرأة بالتمثيل؟
لاحظ صلاح أبو سيف وهو يعمل كمساعد مخرج أن سائق التاكسي فتاة متنكرة في ملابس رجالية. وذلك وقت استعمالها المنديل الذي كانت تتمخط فيه كسيدة لا كرجل. “الرجل يفتح المنديل ويدس أنفه أما السيده فتستعمله برقه”. أعجبت الملاحظة المخرج الفرنسي، وبدأ يعامله كشخص له وجهة نظر.
يقول إن باريس لم تعلمه السينما بل الحياة عمومًا “لقد جعلتني ألقي الكثير من خجلي الذي أحمله دائمًا في صدري وأتعامل مع الحياة حسب عمري، وقد كنت أشعر أنني دائمًا أكبر من سني، وجعلتني أنتبه إلى أن الكتب وحدها لا تكفي لكي نبدع وكي نصنع أفلامًا جيدة”.
وقت تواجد صلاح أبو سيف في فرنسا كانت السينما هناك تحاول خلق أسلوب أقرب للواقعية من هوليود الحالمة. بدأت موجة التعبيرية الفرنسية قبل اقتحام الحرب العالمية الثانية على العالم وظهور أسلوب “الفيلم نوير”.
حلم الانتقال في سينما صلاح أبوسيف
عرف الفقر والكبت والمعاناة. وكانت نقوده هزيله. فكان كل ما حوله في فرنسا يبهره: الحرية، الفتيات، الثياب، السينما، كل شيء. وهذا ما رسّخ فيه مرة أخرى محورية الحديث عن الطبقة الاجتماعية في تشكيل الفرد ومحاولات وأحلام الفرد “للانتقال” من طبقة إلى أخرى أكثر راحة.
وربما كان الانتقال عمومًا هو عقدة أفضل أفلام صلاح أبو سيف: في فيلم “الأسطى حسن” ينتقل البطل حسن (فريد شوقي في أول بطولاته) من حي بولاق الفقير المزعج ومن شقته الضيقة بزوجته وطفله وحماته إلى براح حي الزمالك الواسع الرحب المليء بالطعام الذي تقدمه سيدة لا ترغب في شيء سوى الجنس.
وربما هو انتقال إمام (شكري سرحان) في فيلم “شباب إمرأة” من قريته الفقيرة الساذجة الميتة إلى روح المدينة وأحلامها وفرصها الكبيرة والجنس الوافر مع المرأة التي توفر له كل شيء ولا تريد سوى الجنس. وربما أيضًا هو انتقال محجوب عبد الدايم (حمدي أحمد) في “القاهرة 30” من وظيفته الخاملة الفقيرة غير المستقرة إلى الأمان النسبي في العمل والمنزل المريح مقابل موافقته على بيع زوجته صوريًا يوم واحد في اليوم إلى رئيس عمله.
“عقد مع الشيطان” يعرضه صلاح أبو سيف لمشاهده قد يسبق أو يتبع هذا التنقل، بأن يقف في وجه صاحبه الذي يبيع ذاته بالفعل في تلك النقلة الحياتية غير المبررة نوعًا ما. هو ذاته يشبّه انتقاله من القاهرة إلى باريس بأنه أشبه بانتقال إمام في شباب امرأة من القرية إلى المدينة. “كان مثلي فقيرًا ساذجًا على نياته بلا خبرة يسهل توريطه، ويسهل استغلال ظروفه إنه لا يملك سوى البراءة في مواجهة الخداع”.
سنة أولى إخراج وما بعدها
أخرج صلاح أبو سيف أول فيلم روائي طويل عام 1945 السنة ذاتها التي انتهت فيها الحرب العالمية الثانية. ورحل فيها كمال سليم مخرج فيلم “العزيمة”.
كان الفيلم من النوع العاطفي الغنائي، على النمط الذي كان سائدًا في ذلك الوقت. وهي أفلام فقيرة الإنتاج، تصور في أسرع وقت، وتحقق أرباح خرافية، زاد إنتاجها مع ظهور جمهور جديد في السينما غير مهتم كثيرًا بالثقافة، أقبل على الميلودراما وأعرض عن الأفلام “الجادة”. حتى أنه العديد من النقاد يرجع ذلك إلى الزيادة المفاجئة في صناعة الأفلام تلك الفترة عن سابقيها. لكنه ظل يردد في داخله وفي أحلامه كما سيحكي بعد ذلك: “كنت دائمًا أحلم باغتيال الفقر، كانت السينما هي وسيلته لمحاربة الفقر باعتبارها الفن البسيط المؤثر الذي يفهمه الجميع”.
موقف الوقوف إلى جانب الفقراء “لم أختره ولم أفكر فيه، ولم يكن يقنعني به أحد… إنما وجدت نفسي منحازًا إليه دون تردد ودون جدل، فهو انعكاس لحياتي التي عشتها والظروف التي عانيت منها فلا تسألوني بل إسألوا الفقر، سعى إلى السينما من أجل استعمالها في النقد الإجتماعي والسير على الخطوط الواقعية وتصوير البيئة كما هي حتى أنه أقنع وعلّم “نجيب محفوظ” كيف يكتب السيناريو فقط لأنه يشبه واقعيته.
“لا يمكن أن أصبح مخرجًا دون أن أفهم باقي الفنون وأفهم حدود كل منهما والفروق بينها، فلا أتصور وجود مخرج لا يحس الموسيقى ولا يجيد توظيف الإضاءة أو لا يقرأ الأدب أو لا يستوعب متاعب الناس في الصحافة أو لا يلتقط ومضان الفن التشكيلي إن السينما تحتاج إلى كل الفنون وتفرض اللجوء إلى كل الثقافات”. هذه النظرة التي حكى عنها عادل حمودة ضمن ما حكى يمكن أن تفسّر لنا كفاح وصرامة وثقل سنوات من العمل الدؤوب على كافة مستويات الفكر والقراءة وتعلم المونتاج والإخراج السينمائي للتحدث عن الفقر ومن خلاله، عن واقعية أبناء وطنه، لا يمكن اختصار تجربته في كتاب أيًا كان حجمه لكنه يظل يحمل شذرات يمكن لكل مهتم الاستفادة منها.