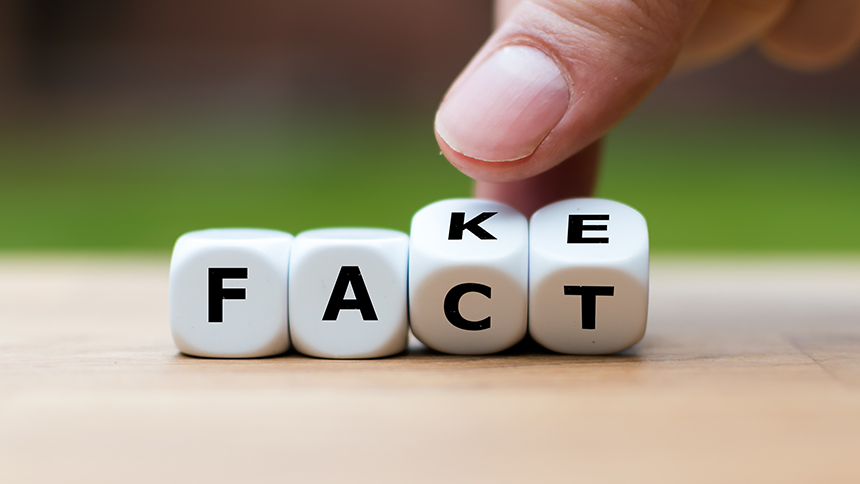ولدت عقب هزيمة يونيو 1967م. كانت أجواء الهزيمة تملأ الفضاء وتخيم على رؤوس الجميع. لا كهرباء ولا طبيب في القرية، رغم وجود الوحدة الصحية، لذلك عندما كان الأطفال يمرضون، وكثيرًا ما كانوا يمرضون، كانت الأمهات تلجأن إلى طرق التداوي البدائية الموروثة، وإذا فشلت هذه الطرق أو تأخر الشفاء، كانت الأمهات تحملن الأطفال المرضى إلى “سيدنا طه” ليفتح له “الكتاب” وليعرف -بطريقته- ماذا أصاب الصبي وكيف نداويه.
كان سيدنا رجلاً طيبًا، يخدم المسجد ويرفع الآذان للصلوات الخمس، وبالإضافة إلى ذلك، كان يعلمنا القرآن، وقليل من مبادئ القراءة والكتابة وعلم الحساب.
أعترف، أنه رغم محاولاتي المتعددة، لم أعرف أبدأ ما هو الكتاب الذي كان سيدنا يفتحه، ولا على أي صفحة كان يفعل، وإن كنت أشك أنه كان المصحف، صحيح أنه كانت لدى سيدنا كتبًا أخرى قديمة في صندوقه الخشبي. لكنه لم يكن يسمح لأحد بالاقتراب منها، ولم أعرف أبدًا، ماذا كان سيدنا يكتب في هذه الورقة الصغيرة، التي كانوا يسمونها حجابًا.
كانت وصفة سيدنا للعلاج، تصيب وتخطىء، فلنقل بنسبة 50%، بعض المرضى كانوا يتعافون، وبعضهم كانت تتدهور أحوالهم، ومنهم من كانوا يموتون. مات أربعة من أخوتي في مثل هذه المباريات قبل أن يصلوا العاشرة من العمر، ولا أدرى، هل من حسن الحظ، أم من سوءه، أن أحمل نفس اسم آخرهم. المهم أنني- وبفضل الصدفة- نجوت. كان الذهاب إلى المستشفى في البندر يتطلب سيارة، وليس في القرية سوى واحدة غريبة اللون والشكل والصوت من ماركة “دودج”، كانت واسعة لدرجة أن حملت في باطنها عشرة أشخاص، أوهكذا رأيتها.
كانت أول مرة أرى فيها الطبيب، الترمومتر والسماعة وجهاز الضغط، وغرفة العمليات، كان طبيبًا جراحًا، لكنه بالنسبة لي كان ملاكًا من السماء، يكفي أنه أنقذني من الموت. وكانت المرة الأولى التي أكتشف فيها حبي لرائحة الصابون والفنيك والأدوية. وقتها تمنيت أن أدرس الطب، لكني لم أحصل علي درجات تؤهلني لذلك، لكن ابن عمي الأكبر تخرج في كلية الطب وعمل جراحَا، و تخرج ابن عمي الثاني طبيبًا للنساء والتوليد، أما أنا فدرست الفيزياء والرياضيات.
الآن، وبعد مضى أكثر من نصف قرن على هذه اللحظة، وهي فترة كانت كافية لدخول المياه والكهرباء والتليفزيون- والواي فاي- إلى قريتنا، تطور العلم والطب بخطوات واسعة، وصولاً إلى الأشعة المقطعية والعلاج بالمناظير. لكن في المقابل، تطورت- ربما بنفس الدرجة- الخرافات والعلوم الزائفة، حول كل علم حقيقي، هناك على تخومه، علم زائف مزيف مضلل، ويتعايش العلم جنبًا إلى جنب مع العلوم الزائفة.
حول الطب والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا، تجد علومًا زائفة كثيرة، وهذه قائمة مختصرة: التنجيم، الأرض المسطحة، نبوءات نوستراداموس، الطب البديل، السحر وتحضير الأرواح الربط، العلاج بالأعشاب، تفسير الأحلام، العلاج بالطاقة، العلاج بالمغناطيس، التنويم المغناطيسي، العلاج بالإيمان، التأمل المتسامي، قراءة خطوط الكف، قراءة الفنجان، قراءة أوراق التاروت، وشوشة الودع، ضرب الرمل، قراءة أوراق اللعب، قراءة المرايا والبلورات، الإتصال بالموتى، الأشباح، والعين الشريرة والحاسة السادسة، والتخاطر، مثلث برمودا، تحريك الأشياء عن بعد، رؤية ما يحدث في الأماكن البعيدة، والاعتقاد بأن أنصال الأمواس تظل حادة إذا حفظت داخل شكل هرمي، وأن تعليق فردة حذاء قديمة على الحائط يجلب الحظ السعيد، وبأن الكثير من الجرائم ترتكب عندما يكون القمر في مرحلة البدر، واعتبار الطفرات والولادات الشاذة والمذنبات نذر شؤم. ويمكننا الاسترسال في سرد ضروب من الخرافات التي تحاول أن تتخذ شكل العلم وصورته، لكنها على النقيض تماما منه، لذلك تسمى بالعلوم الزائفة أو العلوم الكاذبة (Pseudoscience) .
لا يقتصر انتشار العلوم الزائفة على بلد دون آخر، بل ربما يشمل العالم كله، ويبدو أن الأصل كان هو الخرافة. وللخرافة جاذبية هائلة، ومهما تقدم العلم فسوف تظل الخرافة تحتل أعز الأمكنة في قلوب البشر، ذلك لأنها هي الأصل وهي العلم الأقدم، وهي التي قدمت للإنسان الوعد والسلوى يوم كان ملقى هملاً في عالم موحش ملغز وخطر. والوعد- حتى لو كان كاذبا- ليس بالشىء الهين، فهو للنفوس المغلوبة على أمرها أنيس الأيام وسمير الليالي. الملايين في العالم، ممن يستخدمون الكهرباء والهواتف الذكية والواي فاي والأقمار الصناعية واللقاحات، لكنهم أيضًا يؤمنون بالخرافات والعلوم الزائفة، فلماذا يفتتن الناس بالخرافات؟ ولماذا تتعايش العلوم الزائفة مع العلوم الحقيقية؟ وكيف نميز بينها وبين العلوم الحقيقية؟ وما هي مخاطر انتشار العلوم الزائفة وشيوعها على المجتمع والمستقبل؟
فلكل عصرعلومه، ولكل عصر خرافاته، وإذا كان السحر والسيمياء هما دجل العصور الغابرة، فالعلوم الزائفة هي دجل العصور الحديثة. عاش النوع البشري لآلاف السنين تحكمه الأساطير والخرافات والعلوم الزائفة، وجرب كل الطرق المتاحة، وعن طريق المحاولة والخطأ راكم المعارف تدريجيا، وعن طريق الكتابة أصبح بإمكانه نقل معارفة إلى الأجيال الجديدة، العلم إذن هو ظاهرة حديثة نسبيا، ولا يتجاوز بضعة قرون، وهنا يجب أن نميز بين التكنولوجيا، باعتبارها طريقة في صناعة الأدوات، وبين العلم الحديث، الذي يقوم على المنهج والتجربة والدليل.
أما العلوم الزائفة، فهي مباحث تحاول أن تنتحل صفة العلوم الحقيقية ومكانتها، وتنسخ شكلها وملامحها الخارجية، لكنها تقصر كثيرًا عن الوفاء بمعايير الممارسة والتحقيق المقبولة في العلوم. لا تصمد العلوم الزائفة للتمحيص ولا تقدر النقد، ونتائجها تناقض القوانين الطبيعية الراسخة، مثل قانون بقاء الطاقة، وقانون التربيع العكسي، وقوانين الديناميكا الحرارية، وسهم الزمن، وغيرها.
يفتتن بعض الناس بالخرافة، لأنها مثيرة للدهشة زاخرة بالغرابة، لكن العلم يفوقها في هذا المضمار، ويزيد عليها بأن غرابات العلم حق، إن نظرة في تلسكوب أو مجهر، لتلقي بالمرء في عوالم فاتنة بديعة ملونة أنعم من أهداب الحلم و أغرب من نسج الخيال، غير أنها حق. أطراف الكون القصية، تشكيلات النجوم والمجرات، تلافيف الدماغ، العالم دون الذري، قصة الوراثة، نظرية التطور، أعاجيب لم يجد بمثلها خاطر ولم تتفتق بمثلها قريحة. يفتتن الناس بالخرافة لأنها تدغدغ عواطفهم وتبعث فيهم النشوة. لكن للعلم أيضًا مقاماته وأحواله وطربه ومواجده وروحانياته، التطهر بالاختبار، والاعتراف بالخطأ، التبتل للحقيقة، الولاء الخالص للدليل، التنزه عن الغرض، التمهل في الحكم، الانفتاح على الأفكار، الانتشاء بالكشف، والابتهاج بالزمالة.
مع ذلك، ينظر بعض العلماء إلى العلم الزائف باستخفاف ولسان حالهم يقول: هذا عبث أطفال، ولن يضر العلم شيئًا. نعم، الدجل لن يضر العلم شيئًا، ولكنه يلحق أفدح الضرر بالمجتمع، قد يكون الضرر في الحالات الفردية هينًا محتملاً، ولكن ضرر الانتشار الواسع للعلم الزائف هو ضرر فادح، وعواقب تفشي الدجل في أوصال المجتمع هي عواقب وخيمة. لأن العلم الزائف يرتبط التفكير السحري، أي توقع أن التخيل وقوة الإرادة- بذاتهما- سوف يحققان الآمال ويأتيان بالرغائب ويجلبان المطلوب. هذه الرؤية للعالم تقوم على الاعتقاد بأن الاستبصار، الحدس والإلهام الذاتي المباشر، هي مصادر المعرفة اليقينية، وإذا تضارب الحدس مع العقل، فإن الحدس هو المرشد الأوثق إلى الحقيقة. الحكمة والإستنارة، أمر مفاجيء ومكتمل، والسبيل إليها أخلاقي لا فكري، وبالتالي فإن الجهد الفكري لا يجدي بل ربما يعيق طلب الحكمة، وهذا بالطبع مناقض للنظرة العلمية التجريبية، التي تتخذ الملاحظة والإستدلال المتدرج والتحليل والحجة والاختبار، كمصادر أوثق للمعرفة.
تخاطب العلوم الزائفة العواطف، وتدغدغ الاعتقادات المريحة، وتخدع الناس، وتزرع الأمل الكاذب والرجاء غير المستجاب، وعند خيبة الوعود ينقلب المرء على نفسه بالتأنيب والتقريع واللوم، فيضيف الإهانة إلى الأذى. إن الشفاء يمكن تحقيقه دون ألم ودون انتظار ودون جهد، المعرفة والحكمة والموهبة يمكن اكتسابها للتو واللحظة، بطرائق سرية، لا تتطلب تضحية أو مجهودا، هناك طرق مختصرة للتكهن بحقيقة الأشخاص والتنبؤ بما سوف يفعلون، ليس ثمة حدود للقدرة البشرية والإنجاز الإنساني، وبوسعنا أن نحصل على تنبؤ تام بالمستقبل يتيح لنا أن نؤمن سلامتنا ورفاهنا المادي نحن ومن نحب، أزمة الطاقة يمكن حلها نهائيا للأبد.
ما أكثر وعود العلوم الزائفة وأحلاها: الثروة، الصحة، السعادة للجميع، وبأقل جهد وأقل تضحية، وفي مواجهة ذلك يذكرنا “عادل مصطفى” في كتابه “الحنين إلى الخرافة”، نقلاً عن باري بيرششتاين، بأن على المشتري أن يتحمل المسؤولية. إرادة الاعتقاد -هذه- هي ما كان يعنيه الفيلسوف ديموسثينيس منذ أكثر من ألفي عام عندما قال: “لا شيء أيسر من خداع النفس، فما يرغب فيه كل إنسان فهو يعتقد أيضا أنه حق”.
من حق الناس أن يتلقوا معلومات صحيحة ليبنوا عليها اعتقاداتهم وقراراتهم، لن نرتقي بنشر المعلومات الكاذبة، سواء حسنت النية أم سائت، وهي مضيعة للوقت، وخسران لمال كان يمكن أن ينفق في المضمار الصحيح، حين يمتنع المرضى عن إلتماس العلاج الطبي الموثوق، ويملئون جيوب الدجالين باموالهم، بينما حالتهم المرضية تتفاقم ولا تعود تستجيب للعلاج الطبي الصحيح. يخلف الدجل الطبي موتًا مجانيًا ومعاناة يمكن تفاديها، والعلاج النفسي الزائف قد يزرع ذكريات كاذبة، وتحليل الخطوط قد يلوث سمعة أبرياء، إن تفشي الأمية العلمية في المجتمع يضعضعه ويحط به. وتفشي الأمية العلمية في الحكومات قد يفضي إلى استراتيجيات تعود بالضرر على الأمة ككل.
ومن شأن الأمية العلمية أن تسلب المواطن قدرته على الاختيار في القضايا السياسية الملحة والاقتراعات المصيرية الطارئة، إن غياب الفكر النقدي يجعل المواطن ريشة في مهب الدجل يقذف بها حيث شاء، المواطن الأمي علميًا يصوت للقرار الخطأ والشخص الخطأ، والمجتمع الأمي علميًا مؤهل دائمًا للتصويت المدمر، يمضي به إلى الهلاك الآجل مثلما يتهادى قطيع السوائم بثقة وخلو بال..إلى المذبح. يقول الفيلسوف والرئيس الهندي السابق سارشيبالي راذا كريشنان: “عندما نعتنق الأباطيل نرتكب الفظائع”.