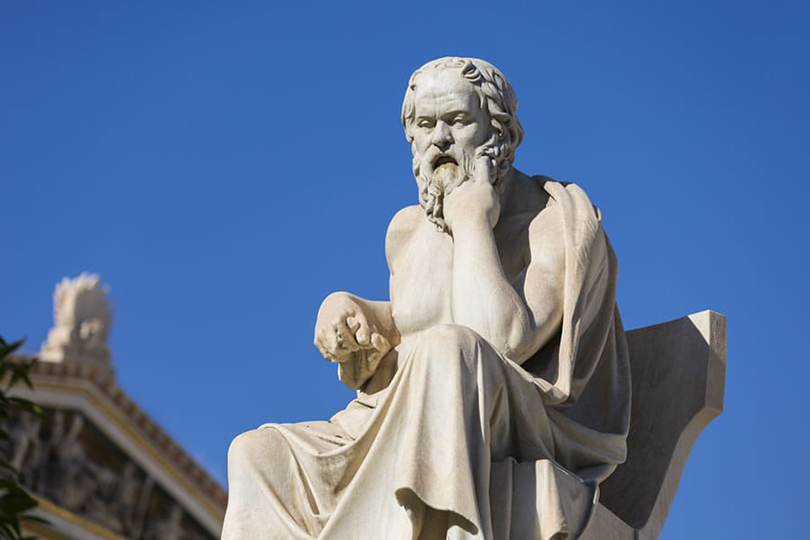يقول “نيتشة“: إن من يبتهج بمعاشرة الرجال الكبار، يبتهج أيضا بالتعرف على أنساقهم الفكرية. حتى إن كانت (خاطئة) كلية. ذلك أن هذه الأنساق تتضمن نقطة غير قابلة للدحض، نغمًا معينًا، محة شخصية، تسمح لنا بإعادة تركيب أوجه الفلاسفة. بحيث يمكننا أن نقول: إن هذه الطريقة في الحياة سبق لها أن وجدت، فهي إذن ممكنة، فالنسق أو على الأقل جزء منه هو النبتة التي انبثقت من هذه الأرض.
نشأت الفلسفة نتيجة لاحتياج الإنسان لصياغة رؤية (عقلية) للعالم، يمكنها أن تجيب على الأسئلة التي تشغل باله منذ أن ظهر على الأرض وحيدًا تملؤه الدهشة. ولم تكن وسائل التواصل تسمح بتبادل المعارف والمعلومات كما هو الحال اليوم. تمكن الإنسان في البدء من توفير القدر الكافي من احتياجات الحياة الأولية، مثلما تمكن من توفير الرفاهية والحضارة لبعض البشر. فالفلسفة ابنة الحضارة والازدهار، لا تنمو إلا في بيئة آمنة، ومجتمع متحضر، حيث تمثل درة التاج الحضاري، وذروة المنتج العقلي للإنسان. هي آخر ما يزدهر في المجتمع وحضارته، وأول ما يتراجع ويخبو في حالات التدهور والتراجع. هكذا نشأت الفلسفة منتجًا فرديًا متعاليًا، مثلما هي منتجًا جمعيًا في تمثلاته ودلالاته المجازية والفكرية. ورغم ذلك لم تكن الفلسفة ابنة الطبقات النبيلة، بل تجلت في أوساط الطبقات المتوسطة في أغلب الأحيان، مثلها مثل كثير من الفنون والآداب. وهو أمر يتضح في نشأة الفلسفة، وإن كانت هناك استثناءات هامة على مدار تاريخها.
نشأت الفلسفة رغبة في استخدام العقل، وجاهدت للابتعاد عن المشاعر أو العواطف من ناحية، مثلما كانت خشيتها من استخدام الحواسن والتشكك في نتائجها من ناحية أخرى. وهو الأمر الذي عانت منه كثيرًا في بداياتها المتعثرة في بلاد اليونان تحديدًا، كما يرى بعض المؤرخين. وهو أمر ربما أصبح محل شك عند البعض، نظرًا لما آلت إليه أمور الفلسفة في الآونة الأخيرة. فحينها يمكن أن تصبح معارف المصريين، وحكمة الصينيين جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الفلسفة.
بدأت الفلسفة اليونانية بسؤال حول الطبيعة، وبدأ الفلاسفة اليونان بالتساؤل حول “أصل” الأشياء، والمادة الأولى التي خرج منها العالم، وكيف يمكن لهذه المادة أن تتحول ليحدث التنوع الموجود في هذا العالم. وفي واقع الأمر لم يكن هدفهم الأساسي ينحصر في الوصول إلى المادة التي تشكل أصل العالم، بقدر ما كان محاولة الوصول إلى فهم/تفسير لهذا العالم المليء بالتغيرات الذي كان/ومازال غير مفهوم بشكل قاطع.
ما الذي يحكم هذا العالم.. النظام أم الفوضى؟! العقل أم الإحساس؟!
كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى فهم العالم؟! من خلال الحواس والمدركات الحسية، أم من خلال العقل والتصورات العقلية؟!
ما الذي يسبق الآخر من حيث الأهمية ومن حيث الأولوية.. العقل أم المادة؟!
في البدء تساءل الشعراء فأخرجوا لنا “الإلياذة” و”الأوديسا” و”الأعمال والأيام”، وغيرها من الملاحم الشعرية التي تضمنت “الحكمة الأخلاقية”، مثلما تضمنت “التفسيرات الخيالية” حول العالم وأصله، وكيف نشأ. ثم تبدلت الأحوال، وتطورت الظروف لاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليظهر هؤلاء الرجال المتفرغون للعلم والحكمة، يجمعون المعلومات والمعارف جنبًا إلى جنب، ليجيبوا عن السؤال الأول حول أصل العالم وعلل ظواهره. ومن بينهم ظهر فلاسفة “أيونيا” الملقبين بفلاسفة الطبيعة (طاليس – انكسماندر- انكسمينس)، في مدينة يونانية تدعى “ملطية” ليجيبوا عن السؤال حول المادة الأولى التي نشأ منها العالم بكل تنوعاته المادية، وظواهره الطبيعية.
وفي الوقت الذي توجه فيه الفلاسفة الطبيعيون لدراسة “المادة”، ولى فيثاغورس وأتباعه وجوههم شطر “الفكرة”، وانتصروا للعقل على حساب الحواس، كل شيء يفنى وتبقى “الفكرة”، كل شيء يختلف، ويتنوع، ويتبدل، ويبقى “العدد”، استخدم الفيثاغوريون الهندسة، والرياضيات، والموسيقى لإثبات أسبقية العقل على المادة، وللوصول إلى جوهر الأشياء. وخلال عقود تالية تبلورت معالم الرؤية الفلسفية، وتأصلت تقاليدها، وتحددت مباحثها حتى جاء”هراقليطس” ليدلو بدلوه، ويعيد النظر في القضايا الفلسفية الكبرى، ويكتب كتابه الشهير “في الطبيعة” بصيغة تقريرية أشبه بكلمات العرافين وكتبهم “المقدسة”، وبغموض بلاغي يكاد يستعصي على الأفهام حتى قال عنه “سقراط”: إن ما فهمه من كلامه كان قيم وعظيم، وما لم يفهمه يجب أن يقاس على ما فهمه.
والباحث في القضايا الفلسفية التي طرحها فلاسفة اليونان يجد كثيرًا من تلك القضايا أثارت جدلاً واسعًا وتركت أثرًا واضحًا في الفلسفات على مرِّ العصور منذ نشأة التفكير الفلسفي. ومن القضايا التي ينطبق عليها ذلك “مفهوم التغير والثبات” ومؤداها: هل الوجود متغير أم أنه ثابت؟
لقد كانت فلسفة التغير والثبات في الفلسفات الطبيعية قبل سقراط، هي محور التفكير الفلسفي منذ بدء التفلسف، ولا تزال لها أهمية عند الفلاسفة والعلماء حتى اليوم. فقد بدأ الفلاسفة قبل سقراط بالرد على التساؤلات التي طرحها عن أصل الكون وتغير ظواهر الطبيعة من حولهم ذلك بالملاحظة والتأمل العقلي المجرد غير التجريبي فقد اتجه هذا الاهتمام ليعالج المشكلات التي تتعلق بطبيعة العالم وتغير ظواهر وثباته.
ولقد تناول كثير من فلاسفة اليونان هذه القضية الفلسفية بالتأمل والبحث وخاصة الفيلسوفين اليونانيين هيراقليطس (475 – 535 ق. م.) وبارمنيدس (حوالي 500 ق. م.)، فقد أشار الأول إلى أن الوجود متغير أما الثاني فقد بيَّن أن الوجود على العكس ثابت، فبعد أن تنوعت القضايا الفلسفية التي تناولها الفلاسفة بدت ظاهرة الاستقطاب بين تغير هيراقليطس (كل شيء في تغير مستمر)، وبين ثبات بارمنيدس (الوجود واحد لا يتغير)، وذلك ربما لزم نتيجة ما رآه تنافر مصدري المعرفة: الحواس والعقل، ومن ثم بدأت أصول التفكير في مبحث المعرفة (الأبستمولوجيا) كما وضعت بذور المنطق. واستفاد الفلاسفة في العصور اللاحقة من طرح هذين الفيلسوفين، بل إن الفلسفة بعدهما اختطت طريقها طبقًا لهذين الاتجاهين.
يرى هيراقليطس في الفلسفة والحكمة تحصيل “الكليات”، فهو لا ينكر المعرفة الحسية، لكنه يصفها بأنها معرفة تحتاج إلى بصيرة تفهم مضمونها، وتؤوله تأويلاً صحيحًا؛ لذلك يذهب كما فعل بارمنيدس إلى أن المعرفة هي المعرفة العقلية وحدها، أما المعرفة الحسية فهي معرفة ظن، ولا تؤدي إلى اليقين، فقد جعل الحواس مصدرًا لمعرفة الوجود المحسوس، والمعرفة التي تأتينا من هذا الطريق عنده لا تمثل حقيقة الأشياء، فهي معرفة قاصرة، ومحدودة، ونسبية. وجعل العقل أيضًا مصدرًا آخرًا للمعرفة ولكنه وحده الذي يستطيع أن يصل إلى معرفة حقيقة الأشياء، إنه وحده الذي يمكنه أن يدرك التضاد القائم بين الأشياء، ووحده الذي يستطيع أن يدرك القانون العام (اللوجوس) الذي يحكم هذا الوجود.
كان هيراقليطس يتوق كما يتوق معظم الفلاسفة للكشف عن الوحدة المستترة وراء الكثرة، عن وحدة تثبت العقل، كان يبحث عن نظام بين ما في العالم من زحام، وفوضى، وكثرة، فالأشياء كلها وحدة واحدة، والمعضلة التي تواجهها الفلسفة هي أن تعرف ماهية هذه الوحدة، وقد أجاب هرقليطس عن هذا السؤال بأنها هي النار، وأكبر الظن أنه كان يستعمل هذا اللفظ استعمالاً رمزيًا مثلما نستدل على هذا من جمعه بين (النار، والنفس، والله) في معنى واحد.
ميز هيراقليطس بذلك بين العالم الحسي والعالم غير الحسي على نحو ما فعل بارمنيدس، الذي جعل الثبات هو الطابع العام للوجود، عكس هيراقليطس الذي أكد على تدفق الوجود وسيلانه باستمرار. حيث يري أن العقل الكائن في الإنسان جزء من العقل الإلهي، وحتى يتمكن العقل الإنساني من معرفة حقيقة الوجود من الضروري أن يتحد بها وعندئذ يصل الإنسان إلى السعادة.