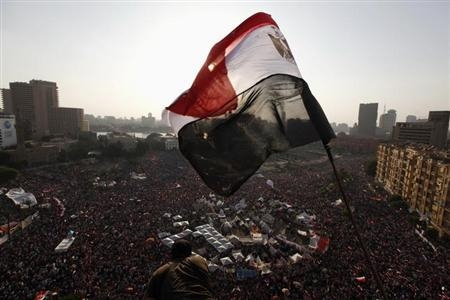لهذا عُدت إلى الداخل:
الآن أقول ما قلته مراراً من قبل عن الصدام المؤذي بين الدولة والثورة، لكنني هذه المرة سأكون مباشراً في الرسالة وفي الأفكار، لن أكتب وعيني على أجيال المستقبل بغرض التطهر الشخصي من خطايا المرحلة، ولن أكتب نصاً أدبيا ليبقى في سجلات التاريخ كمجرد شاهد على معركة فات أوانها، أو نصاً تحريضيا لمجرد إثبات المعارضة ومكايدة السلطة، بالعكس سأكتب للسلطة نفسها بكل الود والإخلاص، راغباً في الاستماع والتفهم والحوار، وموضحاً أن الصراع الدائر ليس معركة بين أعداء، لكنه خلاف صحي داخل البيت ينبغي قبوله أولاً، ثم النقاش حوله بنزاهة من أجل مصلحة الوطن وناس الوطن، وربما تقتضي الدعوة للنقاش وضع مجموعة من التوضيحات للتأكيد على حسن النوايا وضرورة الاتفاق على أفضل وضعية للاقتراب من التوافق السياسي والمجتمعي الغائب:
سأكتب هذه المجموعة من المقالات من غير مشاعر ذاتية، ومن غير رأي خاص أتحمس له ضد آراء الآخرين في السلطة وخارجها، سأكتبها كقراءة للوضع العام، ومساعدة للبحث عن طريق آمن لتحقيق نهضة وطنية نحلم بها جميعاً، ونتحدث عنها جميعاً، لكننا بكل أسف نكتفي بالصراع تحت اسمها من غير أن نتفق على رؤية للطريق ولأساليب السير فيه معاً.
بدأت فكرة هذه المقالات بعد إيقافي عن النشر في الداخل، وخروجي بحثاً عن منابر حرة للتعبير عن رأيي، وفي المنفى اكتشفت أن أي كتابة من الخارج لن تصل نزيهة إلى هدفها، لأن المعارضة الخارجية تم شيطنتها بدعوى الاستقواء غير الوطني.. و”اللي عاوز يعارض يعارض على أرض مصر”، وأنا ممن يبادرون بتصديق الجميع حتى يثبت العكس، لذلك قررت تأجيل هذه الرسائل حتى أعود، وكانت بين الحين والآخر تضغط على تفكيري فأنشر بعض الأفكار مجتزأة أو في التعليق على أحداث تجري، خاصة وأن فترة اغترابي القسري شهدت غزارة في المبادرات المتباينة في لغتها، وفي أهدافها، والتي تراوحت بين المثالية الشديدة أو التعجيز الواقعي، وأحيانا كانت للاستهلاك الإعلامي أو لإحراج السلطة القائمة، أو للتعبير عن رغبة نفسية في إزاحتها من دون أن يكون للطلب مقدمات على الأرض تجعل منه «ضرورة» تتفق عليها شبكة القوى الرئيسية التي يقوم عليها أمن واستقرار الدولة.
المقالات لا تعادي سلطة وتنحاز لأخرى، ولهذا يجب قراءتها كمشروع وطني وليس كمشروع سياسي، والمقصود بالمشروع الوطني هو «صناعة اتفاق» يصلح كنواة لاستراتيجية مصرية تخدمها كل السلطات مهما تبدلت، وبالتالي فإن الموقف من قضية عزل السلطة (أي سلطة) لن يكون مزاجياً، أو في إطار صراعات قوة خارج هذه الاستراتيجية، وهي بالمناسبة مطروحة دائما كشعار نتكاسل عن تنفيذه بجدية وإخلاص (لأسباب كثيرة ومعقدة)، ولا مانع أن تكون هذه الاستراتيجية هي نفسها «الجمهورية الجديدة»، وبرغم أن الاصطلاح يذكرنا بنموذج «السالازاريزم» في البرتغال (ستادو نوفا)، إلا أنه مقبول إذا كان الجوهر هو الأساس، فالمهم أن نعمل معاً بإخلاص من أجل تجاوز «مفاهيم الجمهورية القديمة» لصالح «مفاهيم الجمهورية الجديدة» وهي كما تبدو في الخطاب الرسمي تشير إلى مصالحة مع الدستور الطبيعي في الداخل ومصالحة مع الحريات وحقوق الإنسان من أجل اندماج أفضل في الأسرة الدولية، لهذا تم تدشين استراتيجية لحقوق الإنسان، كما تم إلغاء العمل بقانون الطواريء، وتم الحديث عن حق النقد بشروط لا (خلاف عليها) تعلى من قيمة الوعي ومن أهمية المعرفة بالقضية التي يتم النقاش أو الخلاف فيها… لكن هل لدينا جدية واقعية في تحقيق هذا الشعار؟
إجابة هذا السؤال تحدد للجميع سمات «الجمهورية الجديدة»، هل هي هدف عظيم ومستحق.. نطلقه لنحققه؟ أم أنها مجرد شعار؟ مثل عشرات الشعارات التي طرحتها الجمهورية القديمة في عناوين براقة انتهت إلى لاشيء، بل وتحولت إلى موضوعات للسخرية ومنها «دولة العلم والإيمان».. «الصحوة الكبرى».. «الثورة الخضراء».. «من أجل; أنت».. إلخ.
إن أي نقطة انطلاق نحو «الجمهورية الجديدة» يجب أن تبتعد عن إثارة مشكلات الماضي (القريب أو البعيد)، ويجب أن تبتعد عن خطيئة الإقصاء السياسي والاجتماعي والمؤسساتي (وأقصد اتساع الجمهورية الجديدة لمشاركة كل الأحزاب والتيارات وكل فئات وأطياف المجتمع وكل مؤسسات الدولة)، ويجب أن تعترف “نقطة الانطلاق” بالواقع كما هو عليه الآن، من غير مرجعيات قديمة يتصارع كل طرف في تحديد تاريخ خاص لمرجعيته التي يعتبرها «جمهوريته الفاضلة أو الجديدة»، هذا يعني أن السلطة القائمة ليست محل نزاع على شرعية البقاء بأثر رجعي، لكنها يجب أن تكون محل مساءلة أمام مواطنيها وقوانيها، ويجب أن نقيس أداء مؤسساتها على اساس الالتزام بالدستور، وليس على أفكار حزبية أو مشاحنات سياسية، ويظل السؤال المهم هو: كيف نسعى بإخلاص نحو ذلك؟.. كيف نصل إلى دولة صادقة تحترم تعهداتها، وتحترم دستورها وقوانينها، وتحترم المعايير الدولية في كل شيء: من الاستيراد الآمن للغذاء إلى الاستيراد الآمن لمعايير الشفافية والحريات والمباديء الإنسانية؟
قد تغضب فئات كثيرة من الاتفاق (ولو نظرياً) مع سلطة جاءت لاعتبارات «الضرورة»، ومارست قدراً من العنف في تعاملها مع خصومها السياسيين، وتوسعت في حجب المعارضة لأسباب تم تبريرها بتحديات تهدد الاستقرار والأمن القومي، لكن هذه السلطة، التي اعتبرت نفسها انتقالية ومنحت نفسها حق الخروج على الدستور الطبيعي لأسباب «وجيهة» هي التي أعلنت بنفسها انتهاء هذه الأسباب، وأكدت في إعلان إنهاء حالة الطوارئ أن الأمور عادت لطبيعتها، وان الدولة صارت قادرة على تحقيق الاستقرار والأمان بصورة طبيعية لا تحتاج إلى طوارئ واجراءات استثنائية، وهذا الإعلان يضع مصداقية الدولة أمام نوعية السياسات الجديدة التي تتلاءم مع خطابها الجديد، وأزيد فأقول إن بعض الديكتاتوريات أفضت إلى مداخل جيدة للتحول الديموقراطي، وهي القضية التي سأناقشها في مقالات لاحقة، لكن من المهم الآن أن أوضح على عجالة أن «حالة الضرورة» التي يكون عليها المريض أثناء الجراحة (تخديره ومنع حركته ومصادرة حريته عموما) تقاس بالهدف من الفعل نفسه، فالخاطف الذي يشل حركة إنسان ليسرقه، ليس كالجراح الذي يشل حركته ليعالجه، والهدف والنتيجة تحدد لنا المجرم من الطبيب، لذلك انتهت ديكتاتورية فرانكو الوحشية إلى «ملكية جديدة» من رحم الملكية القديمة، وساعدت تربية الجنرال الدكتاتور للملك على استقرار أسبانيا الجديدة، وهو الأمر الذي تحقق في البرتغال بعد موت سالازار (سياسيا وبيولوجيا) حيث تحققت الديموقراطية بعد مصالحة الجيش والشعب في «ثورة القرنفل»، لأن الجيش هناك لم يعد حامياً للديكتاتور المدني الذي ظل يحكم طويلا، بل تحرك بإخلاص كحارس يساعد في صناعة استقرار البلاد، وحفظ حياة المواطنين، ورعاية التحول الديموقراطي.
حسب مفهوم سقراط للدولة (الذي نقله أفلاطون للعالم في كتاب الجمهورية)، لايمكن تأسيس دولة ناجحة إذا كان مثلث الدولة ناقص ضلع، والمثلث بالمصطلحات الحديثة يتمثل في: (السلطة السياسية، والمؤسسة العسكرية والأمنية، وجموع الشعب العامل)، ويصور لنا سقراط الدولة في صورة إنسان: (رأسه فيها العقل وفضيلته «الحكمة»، وقلبه فيه العاطفة وفضيلتها «الشجاعة»، أما البطن فترمز إلى الاحتياجات والشهوات وفضيلتها «الاعتدال»)، هذا يعني أن أي دولة عادلة تحتاج إلى قيادة حكيمة، ومؤسسة أمنية راعية وشجاعة، وشعب يذهب إلى معيشته ومطالبه الحيايتة باعتدال، وهذا يعني حسب تعبير سقراط أن الحاكم (العاقل العادل) يحكم، والجندي (الأمين الراعي) يحرس، والعامل (الذي تتوفر مطالبه المعيشية) يعمل، وفي كل الأحوال لا يجب أن نضع القوة في مواجهة الحق، بل يجب أن يكون الحق قوياً، وأن تكون القوة مع الحق.
تعاني مصر من أزمة فقدان ثقة خطيرة، ليس بين السلطة والناس فقط، لكن أزمة الثقة صارت وباءً يتحور ويستشري، حتى أصاب الأغلبية في كل مكان: البيوت والعلاقات الإنسانية، دواوين البيروقراطية وأماكن العمل، المحال والعلاقات التجارية، وسائل المواصلات وأخلاق الشارع، البرلمان والأحزاب ووسائل الإعلام، كل شيء.. كل شيء، وبالتالي لا يمكن بناء دولة جديدة بأحجار هشة، لابد من علاج فعال وسريع لهذا الوباء المدمر، والأمر كله في يد السلطة العليا للبلاد، عليها أن تبدأ بغرس الثقة في النفوس من خلال تقديم نموذج لخطاب سياسي صادق، لابد من وضع قواعد جديدة وحاسمة لتصريحات الوزراء والمسؤولين، وتجريم الوعود الكاذبة والتعهدات الانتخابية الموسمية، لابد أن نلتزم بالخطاب الذي نقدر على تنفيذه وفق برنامج معلن وجدول زمني، هكذا نساعد جميعا في تحويل شعار «الجمهورية الجديدة» من مبادرة طرحتها السلطة القائمة، إلى مشروع وطني يمتد سنوات طويلة بصرف النظر عن السلطة القادمة، وهذا الصدق هو الذي يساعدنا على الوصل الصحيح بين «القائم» و«القادم» حتى لا نظل ندور في الدوائر المفرغة، ونعاني من الأعراض الحضارية للنكران والنكوص السياسي، حيث يبدأ عمل كل سلطة جديدة بذبح السلطة القديمة وتشويهها والتمثيل بسياساتها وانجازاتها، ما يؤدي إلى الانقطاع وعدم استمرارية أي مشروع، والدوران في دائرة مغلقة لا تفضي إلى مستقبل ولا حرية ولا استقرار.
أكتفي بهذا المدخل المختصر، وأعود بالتفصيل في المقالات المقبلة (إذا سمح لنا المناخ السياسي والإعلامي بمقالات مقبلة).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:
* العنوان هو الوحيد الذي خرج عن المباشرة في هذا المقال، حاولت أن أكتبه بالصيغة المباشرة: من أجل «الجمهورية الجديدة»، لكن هذه الصياغة توحي لمن يكتفون بقراءة العناوين، أن المقال دعاية بدون تفكير للشعار المطروح، من غير ضمانة لتحقيقه، لذلك كان حرف (الواو) لازماً للتوقف والدهشة والبحث في معاني الكلمات ومصداقيتها، والحكاية أن فرنسا في الخمسينيات كانت تعاني من هيمنة أمريكا على سوق السينما العالمي، وخشيت أن تفقد خصوصيتها وهويتها أمام سطوة هوليوود وأساليبها الفنية، وكانت الموجة الفرنسية الجديدة في السينما في بداياتها، فرفع بعض السينمائيين شعار: «من أجل سينما فرنسية»، لكن الناقد والمنظر السينمائي «أندريه بازان»، أضاف حرف (الواو) ليصبح الشعار «من أجل سينما (و) فرنسية»، والمغزى أن تكون السينما أولا سينما، ثم تكتسب هويتها الفرنسية أو الجديدة أو أي صفة أخرى، هكذا يجب أن نتحمس لنكون «جمهورية» بمعنى الكلمة، ثم نضيف إلى الجمهورية كل الصفات التي نحلم بها ونسعى لتحقيقها.