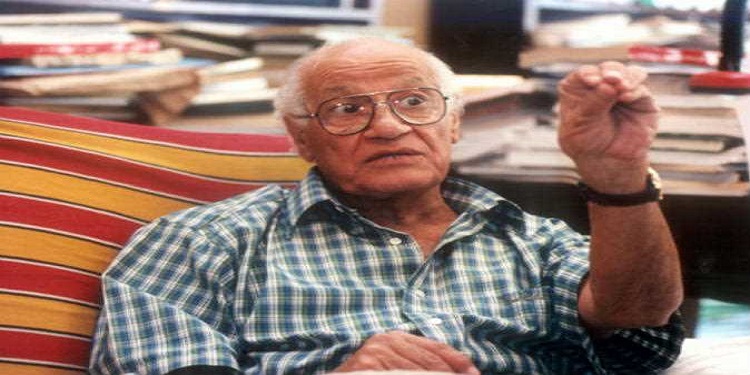المنهج والأثر
كان أهم ما جاء بمقدمة “حسين مْرُوِة” للكتاب/الوثيقة هو التبشير بمنهج جديد للنقد الأدبي العربي بأسره تطبيقًا على الحالة المصرية باعتبار أن هناك قواسم مشتركة تربط الثقافات العربية جميعها شرقًا من العراق وفلسطين والأردن وسورية ولبنان مرورًا بالجزيرة العربية، وغربًا حتى شاطئ الأطلسي حيث الشمال الأفريقي المرتبط -نوعًا ما- بثقافة أوروبية أثرت في ثقافته وتأثرت بها.
يقول “حسين مْرُوِة”: “إنك لو جعلت عنوان الكتاب/الوثيقة “في الثقافة العربية” بدلًا من “في الثقافة المصرية”، فأنت لن تخرج عن الموضوع حيث كان الحديث عن الحالة المصرية -بذاتها- لأجل تحقيق أهداف الدقة من زَاويةِ التحديد فالتعيين ثم ضبط المقاييس من خلال تجربة خاصة. لكن واقع الأمر أن دراسات الكتاب/الوثيقة “تعكس وجوهًا شتى من التقارب بين ثقافة عربية في مصر وثقافة عربية في غير مصر من ديار العروبة، كما تعكس وجوهًا أخرى أظهر دلالة على وحدة المعركة التي يخوضونها في مصر ونخوضها في غير مصر من ديار العروبة هذه”.
كان العَالَم في ذلك الوقت -وقد وضعت الحرب الكونية الثانية أوزارها- يُعيدُ بناء نفسه على أسس مختلفة، انتهت الإمبراطوريات التقليدية وظهرت إمبراطوريات جديدة بأدوات جديدة، وكانت نضالات شعوب العالم لنيل استقلالها على أشدها حيث تواكبت تلك النضالات العضوية على الأرض مع نضالات أخرى تؤكدها “فكريًا” وتحفزها في نفس الوقت لتنفض عن تركيبها الثقافي غبار قرونٍ من الجمود الذي تماهى مع الأنماط الاقتصادية والممارسات السياسية بتلك المجتمعات التي كانت ترزح تحت استعمار الإمبراطوريات التقليدية، فكان عام 1946 مبشرًا بنهاية آراء ومفاهيم وقِيم رسختها نُخَبٌ أدبية انتهى دورها التاريخي حين فشلت في طرح مشروع جديد يتواكب مع واقع مختلف أنَتَجَ طروحات ثورية أتت من قلب حركة وطنية لها آفاق وملامح اجتماعية جديدة.
“وهنا لابد من العودة إلي مسألة مفهوم الثقافة من الأساس، لنرى إلى الجهد القيم الذي اضطلع به المؤلفان، في تحديد المدلول الحقيقي للثقافة، وفي وضع هذا الأمر ضمن نطاقه العلمي الصحيح، بحيث كشفا النقاب عن محاولات المفكرين الرجعيين لأن ينحرفوا بمدلول الثقافة عن حقيقته الموضوعية المتحركة المتطورة، إلى تفسير جامد لا يقبل حركة ولا نموًا ولا تطورًا، وإنما يقف عند بعض المظاهر العرضية الثانوية المتجمدة، كما فعل ت.س إليوت بجعله الدين أساسًا للثقافة الإنجليزية، بل الأوروبية عامة.
وقد وضع المؤلفان هذه القضية وضعًا علميًا صحيحًا، وحددا جوانبها تحديدًا منفتحًا، واسع الأفق، يتقبل الهواء والنور، ويتحرك مع التاريخ بطواعية ومرونة وتوافق، ويتجاوب مع قوانين التطور الاجتماعي على أروع ما يكون التجاوب، فإذا الثقافة بمدلولها العلمي التطوري هذا، لاتنكر الدين عاملًا مساعدًا من عواملها، كما لا تنكر الوضع الجغرافي، ولا تجعل العامل الاقتصادي أساسها الأوحد، و إن كان هو العامل الحاسم في العملية الاجتماعية التي تكون الثقافة إحدى ثمارها.”… هكذا كان الوصف الموجَز “لحسين مْرُوِة” للكتاب/الوثيقة في مقدمته بالغة الأهمية.
“وماكنا في الحقيقة نقصد أبعد من تقديم رؤية للأدب تختلف عن الرؤية التي كانت سائدة، والتي كان يغلب عليها الطابع الانطباعي الذوقي من ناحية أو الطابع الكلاسيكي التقريري من ناحية أخرى. فما قصدنا أبعد من تحديد الدلالة الاجتماعية للأدب [لا الدلالة البيئية كما كان شائعًا أيضًا آنذاك] في ارتباط عضوي حميم مع بنيته التي تصوغ أدبًا.”… هكذا كانت الإشارة بالغة الوضوح “للأستاذ” وشريكه في مقدمة طبعة دار الثقافة الجديدة التي كتباها في يناير 1989، ليشرعا بعدها في عرض أحد عشر مقالًا مُزَلزِلًا، خمسة منهم “للاستاذ” وأربعة لشريكه واثنان كتباهما معًا.
المنهج إذن يتركز بالأساس على كون الثقافة كائنًا حيًا مُتعَدِد المداخل لا أحادية فيه ولا جمود، ومن هنا كان نقدهما لإليوت (خروج ثانٍ عن النص: يقول سيدنا ومولانا والد الشعراء فؤاد حداد في سخرية مريرة لوصف الجمود الفكري السائد جينها حيث رفض الدكتور عبد القادر القط -وكان رئيسًا لتحرير مجلة الشعر- نشر أشعاره بالمجلة لأنها غير مكتوبة بالفصحى: الشِعر أميرُه تي إس. إليوت، ورئيس تحريرُه ع. ق. القط”)، فالثقافة لديهما هي انعكاس للعمل الاجتماعي الذي يبذله شعب من الشعوب بكل فئاته وطوائفه، ومظهر لما يتضمنه هذا العمل الاجتماعي من علاقات متشابكة، وجهود مبذولة، واتجاهات. فالأساس الذي تقوم عليه العملية الثقافية كتعبير فكري أو أدبي أو فني ليس شيئًا جامدًا أو عقيدة محددة وإنما هو عملية لها عناصرها المتفاعلة واتجاهها المتطور.
تلك هي المسألة إذن، فأحادية مصادر الثقافة لا تخلق مجتمعات تفكر حيث لا توجد أضداد تتجادل حُجةً بِحُجة أو طَرحًا بِطَرح، لكنها تخلق حالة ذهنية جماعية تنهل من منهل واحد فتفكر بأسلوب واحد لتسير في طريق واحد وسط عالم مليء بالأفكار المتعددة التى صنعتها المجتمعات الإنسانية المتنوعة من خلال تجارب كثيرة في مسار تاريخي يتطور بلا توقف وتنتقل فيه تلك الأفكار و التجارب والقيم التي تشمل الدين والأدب والفن والقانون والسياسة والاخلاق طولًا وعرضًا مُتفاعِلَةً بشكل دائم وبالأخص بعد ثورة الاتصالات التي لم يكن لنا حظ أن يعيشها “الأستاذ” وشريكه ليدرسا أثرها على ما طرحاه طرحاه من أفكار بالكتاب/الوثيقة.
ومن هذه الزاوية تَأثرتُ بشكل شخصي -كمتخصص في عِلم إنساني مختلف- بمنهجية “الأستاذ” وشريكه فصرت أنظر للمسألة الاقتصادية والمالية باعتبارها فِكرًا إنسانيًا عالميًا متطورًا ودائم الحركة للأمام، لا يقف عند حدود المكان و الزمان. لا أنفي المدارس الاقتصادية التقليدية ولا -في نفس الوقت- اعتمدها على حرفيتها كما أتى بها أصحابها في مجتمعات لها طبيعتها المختلفة وفي أزمان لها ملامحها غير المتكررة، وإلا فهو التكلس فالضمور ثم الانزواء خارج دائرة التاريخ. تفاعل المتناقضات يؤدي إلى تراكُم خبرات يفضي إلى تغييرٍ نوعي يَحدث معه نوعٌ من التركيب الإنساني الجديد في المسألة الاقتصادية/المالية، تمامًا كما في المسألة الثقافية حسب طرح “الأستاذ” وشريكه.
وأنا لا شك عندي في أن الأفكار الاقتصادية/المالية على المستوى الكلي هي جزء من التكوين الثقافي العام كمسألة الكفاية والعدالة الاجتماعية مثلا حيث لا يمكنك انتزاع رؤية اقتصادية/مالية من سياقها الثقافي في مجتمعٍ ما، وإلا أصبح الاقتصاد علمًا لا إنسانيًا يمكنك في ظل التقدم الحالي أن تحبسه في آلات وماكينات تحتسب المعادلات والدوال بشكل أوتوماتيكي لا روح فيه ثم تتخذ القرارات دون الحاجة لعقل إنساني يفكر فينحاز ليضع أولوياته وفق ما هو متاح من موارد.
للحديث بقية، إن كان في العمر بقية.
اقرأ أيضًا: الجزء الأول: “العَالِم”