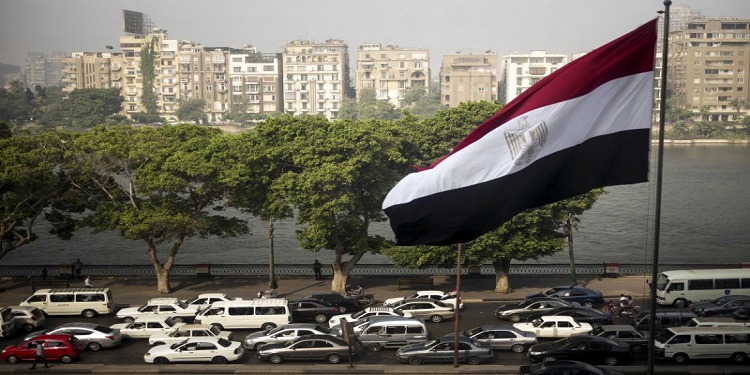إن إعلان قيام الجمهورية الجديدة ينبغي أن يستقل تماما عن تدشين العاصمة الإدارية الجديدة، لأنه أوسع بكثير منها وأكثر شمولا، لأن الجمهورية الجديدة تعنى في الأساس نظاما سياسيا جديدا بكل الأنظمة الفرعية المرتبطة به، والمترتبة عليه؛ مثل النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية. فضلا عن أن الجمهورية الجديدة ليست مرحلة يتم الوصول إليها مرة واحدة وإلى الأبد؛ إنما هي عملية متطورة؛ مرحلة بعد مرحلة، وأهداف بعد أهداف، ومراجعة مستمرة للخطط والبرامج في ضوء النتائج.
إن منطق الجمهورية الجديدة، في التجارب التاريخية التي رفعت هذا التوجه، ينطوي في جوهره على الانقطاع عن الجمهورية القديمة من حيث الجوهر. ومن هنا ضرورة البدء بتحديد، والاتفاق حول، النظام القديم الذي سيختفي، وتحديد المعالم والهياكل التي سيجرى تغييرها؟ ومن ثم تحديد ما هو النظام الجديد الذي سيجري تشييده، وما هي المعالم والهياكل المرغوبة؟
ولذلك فإن الحوار ليس مسألة حدية، إنما ينبغي تحديد مجالات الاتفاق، ومجالات التباين، ومجالات الاختلاف، ويمكن تحديد آجال زمنية للتحرك في كل مجال. يرتبط بذلك أن الحوار يقوم على التدرج في إمكانية تحقيق الأهداف؛ فهناك أهداف الأجل القصير، وهناك أهداف الأجل المتوسط، وهناك أهداف الطويل.
كذلك فإن الدعوة للحوار لا تعني أننا إزاء مباراة ذات حصيلة صفرية، إما الحكومة أو المعارضة، إنما الهدف هو البحث عن “القواسم المُشتركة” أو “الأرضية المُشتركة” بين آراء المُشاركين في الحوار، ومن ثم التوصل إلى توافق وطني (National Consensus) على قاعدة عريضة من القيم والأهداف والمبادئ، مثل النظام الجمهوري والديموقراطية العدالة الاجتماعية والمساواة والمشاركة والشفافية، ويكون الاختلاف حول السياسات والأدوات والوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه القيم والأهداف والمبادئ. إن هذا هو المعنى الحقيقي لتداول السلطة في الغرب، وفي إسرائيل، والقول مع كل انتخابات أنه لا تغيير في التوجهات العامة سواء فاز الحزب الجمهوري أو الحزب الديموقراطي يعود إلى مبدأ التوافق الوطني.
ويتطلب تحقيق ذلك الخبرة والمعرفة اللازمتين لتبني القرار القائم على التوافق الوطني بما يُرسخ “ثقافة الحوار” في العمل السياسي.
ولعل من المفارقات في هذا المجال أنه ليست هناك اختلافات جذرية عديدة بين السلطة والمعارضة؛ إذا استثنينا الصراع العربي الإسرائيلي بكل ما يرتبط به، بخاصة العلاقات مع الولايات المتحدة. السلطة تتمسك -نظريا وإعلاميا على الأقل- بالاستقلال الوطني وحرية الإرادة والعدالة الاجتماعية والوحدة العربية وحتى الحياد الإيجابي، وهذا عين ما تنادي به المعارضة، إنما الاختلاف يقع في دائرة السياسات والوسائل والأدوات. فضلا عن أن هناك حال إجماع وطني عام حول قضايا الأمن القومي العليا من نحو مسألة المياه ومحاربة الإرهاب.
يقتضي ما تقدم تأكيد أن الثقة في الشعب هي الخطوة الأولى الضرورية نحو الجمهورية الجديدة، يرتبط بذلك إيمان الدولة نفسها بمبدأ الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، لأنها في مسيرتها السابقة يبدو أنها لا تثق في الشعب، ولا تؤمن به، مهما كانت الشعارات المعلنة غير ذلك. لذلك فإن الشفافية والمشاركة من أهم أركان الجمهورية الجديدة، وهما الحل الأول أمام الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، فضلا عن مواجهة القوى الإرهابية.
إن انطلاق الحوار يستلزم تهيئة البيئة السياسية العامة لمقتضياته، كما أن فعالية الحوار تتطلب تأكيد مجموعة من المتطلبات، يمكن إدراجها على النحو الآتي:
أولا – إن إطلاق سراح المسجونين السياسيين وأصحاب الرأي ليس ثمنا لقبول الحوار، ولا يشكل جزءًا من الحوار، ولا ينبغي أن يكون نتيجة للحوار، بل مقدمة له وتمهيد يؤكد جدية السلطة في فتح صفحة جديدة مع الرأي الآخر، ولذلك فإن من المقترح أن يتخذ شكل عفو عام، لا شكل دفعات وراء دفعات، بزعم مراجعة الملفات، لأن السلطة تعلم جيدا حقيقة تلك الملفات، ولا شك في أن خروج مواطن إلى الحرية بغير وجه حق هو أكثر عدلا من بقاء مواطن خلف أسوار السجن بغير وجه حق. مع تأكيد ما عمدت إلى تأكيده كل القوى بغير استثناء واحد: إن كل ذلك لا يشمل أولئك الذين أيديهم مخضبة بالدماء، والذين احترفوا العنف.
والأهم هو تعديل القوانين غير الديموقراطية التي يتم استخدامها لتقييد حريات المعارضة؛ وعلى رأسها قانون تنظيم التظاهر، الذي لا يمت لاحترام الحريات والحقوق الديموقراطية بصلة، فوجود تلك القوانين يمكن أن يعيد مشكلة تقييد حريات المعارضة السلمية في أية لحظة، لندور في حلقة مفرغة تبتعد بنا عن درب التطور والنهوض لوطننا العظيم.
ثانيا- لا ينبغي أن تكون الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي، وهي هائلة ومقدرة، مقدمة للحوار، ولا مادة للحوار، فهذه هي مسؤولية السلطة في جميع الحالات، حتى إذا أجادت وتفوقت.. ذلك أنه “لا شكر على واجب”، وفي هذا الإطار لا للإشادة لأنها لا تليق.. ولا للمقايضة لأنها لا تجوز. كلاهما منطق لا يليق بجلال الحوار الذي يركز على مستقبل مصر.
إن المسئول الحكومي يجب أن يتوقف عن الأحاديث المرسلة، أو أحاديث الإشادة بالإنجازات التي تحققت. إن كل الأطراف المشاركة في الحوار لديها حُسن نية، وليس لديها أي نية للتربص بالحكومة، ومن ثم فعلى الحكومة أن يكون لديها معلومات دقيقة قبل عرضها وتناولها بالحوار، وعليها تقديم معلومات مؤكدة، وأن تتوقع أن هذه المعلومات يمكن تحديها بالحوار، حيث يجب أن يتحلى المسئول في الحوار بشجاعة القدرة على التصحيح، وذلك لضمان نجاح الحوار.
يرتبط بذلك سقوط فكرة المهمة التي لم تنته بعد.. تحت شعار: مواصلة المسيرة، التي رسختها النظم والقيادات السابقة على ثورة 25 يناير، بزعم استكمال المشروعات التي بدأتها. لقد جاء الرئيس السيسي في “ظرف استثنائي” خلال الفترة الرئاسية الأولى. جاء في صورة “البطل المنقذ”، الذي لولاه، ولولا استدعاء الشعب للجيش، ما أمكن الخروج من حكم الإخوان. ولكن هذا “الظرف الاستثنائي” انتهى.
إن المشروعات بخاصة العملاقة منها تمتد لزمن طويل، وهي تتعدد في حياة الرئيس الواحد، بحيث لا يتصور أن تنتهي كلها في وقت واحد مع انتهاء ولايته. وحتى إذا كانت الإنجازات هائلة.. وكانت هناك مشروعات ضخمة جاري إنجازها.. فإن الرئاسة ليست مكافأة نهاية خدمة، ولا تمثل تكريما للرئيس المنتهية ولايته. كذلك فإن تداول السلطة لا علاقة له مطلقا بالكفاءة أو الإنجازات أو الوعود، ولا يمثل تقييما من أي نوع، إيجابي أو سلبي، لمن يترك منصبه. مع تأكيد أن الحد الأقصى لولاية الرئيس السيسي ينتهي -من الناحيتين الدستورية والنظرية- في عام 2030، ولذلك فإن أمامه فرصة تاريخية، وفترة زمنية كافية، لصياغة جمهورية جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة، لا تحتاج إليه، ولا يحتاج إليها، أي إنتاج نظام لا يحتاج إلى “رئيس ضرورة”، ولا إلى “رئيس استثنائي”.
ثالثا- ينبغي تجاوز الحديث عن الدوافع التي حدت بالرئيس إلى تقرير الحوار في هذا التوقيت بالتحديد، أو مبررات إغفال أو إرجاء الإصلاح السياسي، سواء ما يتصل منها بالإرهاب أو جائحة كورونا، أو المشروعات القومية، لأن مناقشة هذه الدوافع أو تلك المبررات، مهما كانت وجاهتها، لن تفيد. بل إن الإصرار على مناقشتها قد تعطيها شرعية على غير أساس حقيقي.
يرتبط بذلك تأكيد أن الحوار ليس تخلصا من مأزق أو أزمة، رغم أن ذلك يعتبر جزءًا من دواعيه وشواغله، ولا هو محاولة لتوريط الآخرين، إنما محاولة لبناء مستقبل، وأن المعارضة ليست من أجل استبدال النظام، لكن من أجل الإصلاح. ولا شك في أن ظهور الشخصيات المعارضة في جلسات الحوار، ومناقشتها المعلومات والحقائق، سيعمق إحساسها بالمسؤولية.
رابعا- إن الجمهورية الجديدة ينبغي أن تتبنى نظاما متكاملا بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فلا يجوز مثلا اختيار النظام الرأسمالي مع ترسيخ كراهية القطاع الخاص، أو جوانبه الاقتصادية دون الجوانب السياسية مثل التعددية المؤسسية الحقيقية، بخاصة تعدد الأحزاب، وحرية الصحافة والإعلام، والمشاركة والشفافية، على أساس أن الحقوق الاقتصادية لن يخدمها إلا الحقوق السياسية.
وهناك بعض الأوهام السائدة في هذا المجال منها تصور أن ما يكسبه القطاع الخاص تخسره الدولة.. هذا خطأ لأن القطاع الخاص إذا سدد الضرائب المستحقه عليه، ووظف عمالة، وسد ما تستحقه من تأمينات اجتماعية، فإنه إضافة للتنمية. أو زرع أوهام التناقض بين القطاع الخاص والاستثمار، بإشاعة أن القطاع الخاص معناه ظلم واستغلال ورأسمالية متوحشة.
خامسا- لقد أدى إلى تفاقم الأمر أن الوطن أوقع نفسه في شراك، نصبها له الآخرون بوعي، ونصبها لنفسه بغير وعي، ووقع بسبب ذلك أسيرا لعدة تناقضات لا يظهر لها حل، ولابد من حسمها، منها مثلا:
1- تناقض بين الدين والعلم يلهي عن حقيقة أن الله الذي خلق الإنسان جعل له قلبا وعقلا في نفس كيانه، وكلاهما فاعل في اتساق مع الآخر، فالوحي الإلهي لا يمكن أن يكون إلا صادقا، والبرهان العقلي لا يمكن أن يكون إلا سليما، وأي تناقض بين الاثنين تعسف مفتعل، وباب الاجتهاد هو الجسر المفتوح –دائما– لعبور فجوة هذا التعسف المفتعل.
2- تناقض بين الوطنية والقومية كأن كل واحد منا لا يملك غير هوية واحدة تستبعد إلى حد الإلغاء كل شخصية سواها. والغريب أن الأوروبي –مثلا- يستطيع أن يكون فرنسيا، وأن يكون أوروبيا، وأن يكون غربيا، وأن يكون مسيحيا – كله في نفس الوقت، وبغير تناقض. أما نحن فمكتوب علينا أن نكون بعدا واحدا فقط، فإذا تعددت الأبعاد حل الشرك.
3- تناقض بين الأصالة والمعاصرة ناسين أن القادر على شوط المعاصرة هو ذلك الذي يملك قاعدة الأصالة، وغافلين عن حقيقة أن المعاصرة الحقيقية هي التجدد في الأصالة، وليس التنكر لها.
4- تناقض بين الحاضر والماضي يورطه باستمرار في إعادة ترتيب التاريخ وكتابته، بحيث يجعل ما وقع بالأمس، أو ما يدعى وقوعه في الأمس، مبررا لما يجري هذه اللحظة وما يتداعى بعدها. وهذا خطر يسلب الأمة تراكم تجاربها، ويحصرها في تراكم أخطائها.
5- تناقض بين القوى السياسية ذاتها حول رؤيتها لما يجرى، وبحثها عن الحلول المناسبة والممكنة، بل وصل التناقض إلى حد أن تلك القوى أصبحت مولعة بالبحث عما يفرقها أكثر من بحثها عما يجمعها. وأحيانا يصبح هذا البحث لعبة عبثية باهظة في أعبائها النفسية والسياسية والمادية أيضا. فهناك معركة لا لزوم لها بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبين العلمانية والأصولية، وبين المدنية والعسكرية. كما تحولت السياسة إلى عداوات بين المراحل التاريخية وقياداتها المختلفة.
سادسا- إن مثل هذا الحوار حتى يكون مجديا لابد له من توافر عدد من الشروط الأساسية، حددها د. مصطفى كامل السيد، نقلا عن الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس، وهي:
1- المساواة المطلقة بين المشتركين في الحوار، فلا يملك أي منهم امتيازات خاصة في مواجهة الآخرين.
2- أن يدخل الجميع الحوار بروح منفتحة، فلا يدعى أي منهم احتكار الحقيقة، كما يكونون مستعدين للتخلي عن وجهات نظرهم إذا ثبت من خلال الحوار أن حجج الآخرين أكثر صحة.
3- أن تكون الحجج الراجحة في الحوار هي الحجج الأقدر على الإقناع بسبب إمكانية أن تكون الأقدر على تحقيق المصلحة العامة.
4- ألا ينفرد أي طرف بتحديد من يشارك في الحوار، وبفرض جدول أعماله، فالحوار يجب أن يكون مفتوحا لكل الأطراف، كما أن كل القضايا العامة هي مقبولة للمناقشة.
سابعا- من المتصور أن تكون هناك لجنة تحضيرية يشارك فيها ممثلون لكافة التيارات السياسية المدعوة لهذا الحوار تحدد جدول أعماله. ونظرا لأن التحديات التي تواجه الوطن لا تحتمل حوارا يمتد لأكثر من أسابيع، لذلك فربما تقتضي الحكمة أن يركز الحوار على القضايا ذات الأولوية، والتي يحتاج صانع القرار أن يسمع فيها وجهات نظر مستقلة لا تخرج عادة من الأجهزة المسئولة عن أمن الوطن. وربما يمكن تصنيف القضايا الواجبة بالاهتمام إلى قضايا الأجل القصير، وقضايا الأجل المتوسط، وقضايا الأجل الطويل. فمن قضايا الأجل القصير الإصلاح السياسي، ومواجهة التحديات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تجعله ضحية للأزمات في الاقتصاد العالمي، وأخيرا النهج الأمثل في التعامل مع تهديدات الأمن القومي المصري من جانب أطراف إقليمية في مقدمتها إسرائيل وإثيوبيا، والحفاظ على علاقات متوازنة مع كافة الدول العربية.
قضية التعديلات الدستورية ربما تكون قضية الأجل المتوسط، وقضية المشروعات القومية التي جرى الإنفاق عليها تؤجل إلى دورات تالية للحوار، تتولاه فيما بعد المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والنقابات ومراكز الأبحاث المتخصصة، لكن تسبقها في الأهمية قضية صنع القرار في المجالين الاقتصادي والعمراني، ويمكن أن يتولاها تفصيلا مؤتمر اقتصادي ترددت الدعوة له.
ثامنا- من المتصور أن يتفرع الحوار إلى مجموعة من لجان العمل التي تناقش بدائل السياسات؛ فتكون هناك لجنة عمل رئيسية تناقش الإصلاح السياسي، وأخرى تعد الدستور الجديد، وتصب فيها كل المقترحات المتعلقة بتعديل مواد في الدستور من كل اللجان الأخرى، وإلى جانب ذلك مجموعة من لجان العمل التي تخصص لمناقشة القضايا النوعية مثل: العدالة الاجتماعية – الصحة – التعليم – الثقافة – الإعلام – الاستثمار – التنمية الاقتصادية في ظل: الأزمة المالية، كورونا، حرب روسيا وأوكرانيا – وسائل التنشئة الوطنية – سد النهضة – دور مصر الدولي حيث هناك قصد مقصود نحو تحديد إقامة مصر داخل حدودها، سواء على المستوى الإقليمي (علاقات مصر مع إسرائيل وإيران وتركيا وإثيوبيا)، والعالمي (بخاصة العلاقات المصرية الأميركية).
وفي كل لجنة عمل تقدم الحكومة المعلومات والحقائق التي صاغت على أساسها برنامجها، ثم تقدم المعارضة البرنامج البديل، الذي يقوم بصياغته مجموعة من الخبراء المتخصصين، وتجرى المناقشة الحرة بين الطرفين دون قيود أو التزامات مسبقة، على أساس أنه آن الأوان لكي تستمع الحكومة وتنصت للمعارضة، أي إلى وجهة النظر الأخرى، لأن الحوار في جانب منه يمثل مهمة إنقاذ وطني.
إن الاستجابة لهذه المتطلبات، وغيرها بطبيعة الحال، تعنى أن باب الحوار مفتوح على مصراعيه.. وباب المستقبل أيضا.
للاطلاع على مقالات أخرى للكاتب.. اضغط هنا
دكتور مجدي حماد رئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الدولية