مضى الآن قرابة نصف عام منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته للحوار الوطني الذي يؤدي إلى خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية المصرية تأسيسًا للجمهورية الجديدة، ومضى أيضا ثلاثة أشهر منذ عقدت أولى جلسات مجلس الأمناء، الذي أشرف بعضويته بين مجموعة ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية (المعارضة) التي تضم 12 حزبا، وعددا معتبرا من الشخصيات العامة، وهذه في الحالتين -أي منذ الدعوة الرئاسية ومنذ انطلاق الجلسات- فترة أكثر من كافية للتساؤل حول مسار هذا الحوار وتضاريسه ومستقبله، سواء لدى الرأي العام، أو لدى القوى السياسية المنخرطة في عملية الحوار، وتلك التي تحفظت عليه من البداية، أو لدى المهتمين خارج مصر.
اقرأ أيضا.. عن الحوار والحِواريين: تقدير موقف
من المهم للغاية قبل محاولة الإسهام في الإجابة على تلك التساؤلات الإشارة بوضوح إلى أن ما سأكتبه في السطور التالية ليس مصدره المداولات السرية في مجلس الأمناء، بما أن لائحة المجلس تلزمنا جميعا بسرية المداولات، إلا البيان الصحفي المتفق عليه في نهاية كل جلسة، ولكن مصادري هنا هي الأحاديث الصحفية، والتصريحات التليفزيونية، التي يدلي بها الزملاء الأفاضل في مجلس الأمناء، والمقالات الصحفية التي كتبها عدد لا بأس به من هؤلاء الزملاء، وكذلك بيانات الحركة المدنية الديمقراطية، وأحاديث أعضائها.
أول المعالم في خريطة تضاريس الحوار هو إصرار الحركة المدنية الديمقراطية على مفهومها بأن هذا حوار سياسي بين سلطة ومعارضة بمشاركة مستقلين، وذلك وفقا لمنطوق المبادرة الرئاسية التي وصفت الحوار المدعو إليه بأنه حوار وطني، ووفقا لما اتفق عليه في المداولات التحضيرية للحوار وأهمها تشكيل مجلس الأمناء، والضمانات المطلوبة لنجاح الحوار، إذ إن مصطلح (الوطني) يعني في الأدبيات السياسية والأعراف الدستورية في جميع بلاد العالم عملا مشتركا بين سلطة ومعارضة، ومن ذلك القبيل حكومات الوحدة الوطنية، التي تتكون عادة لمواجهة أزمة كبيرة داخلية أو خارجية، حين يعجز حزب الأغلبية عن مواجهة الأزمة وحده، أو حين لا يستطيع هذا الحزب تأمين الأغلبية البرلمانية الكافية فيشكل حكومة وحطة وطنية مع الحزب التالي له في عدد المقاعد لتفادي ابتزاز الأحزاب الصغيرة، أو لتفادي المعارضة الشرسة، أو لتجنب تشكيل حكومة ضعيفة.
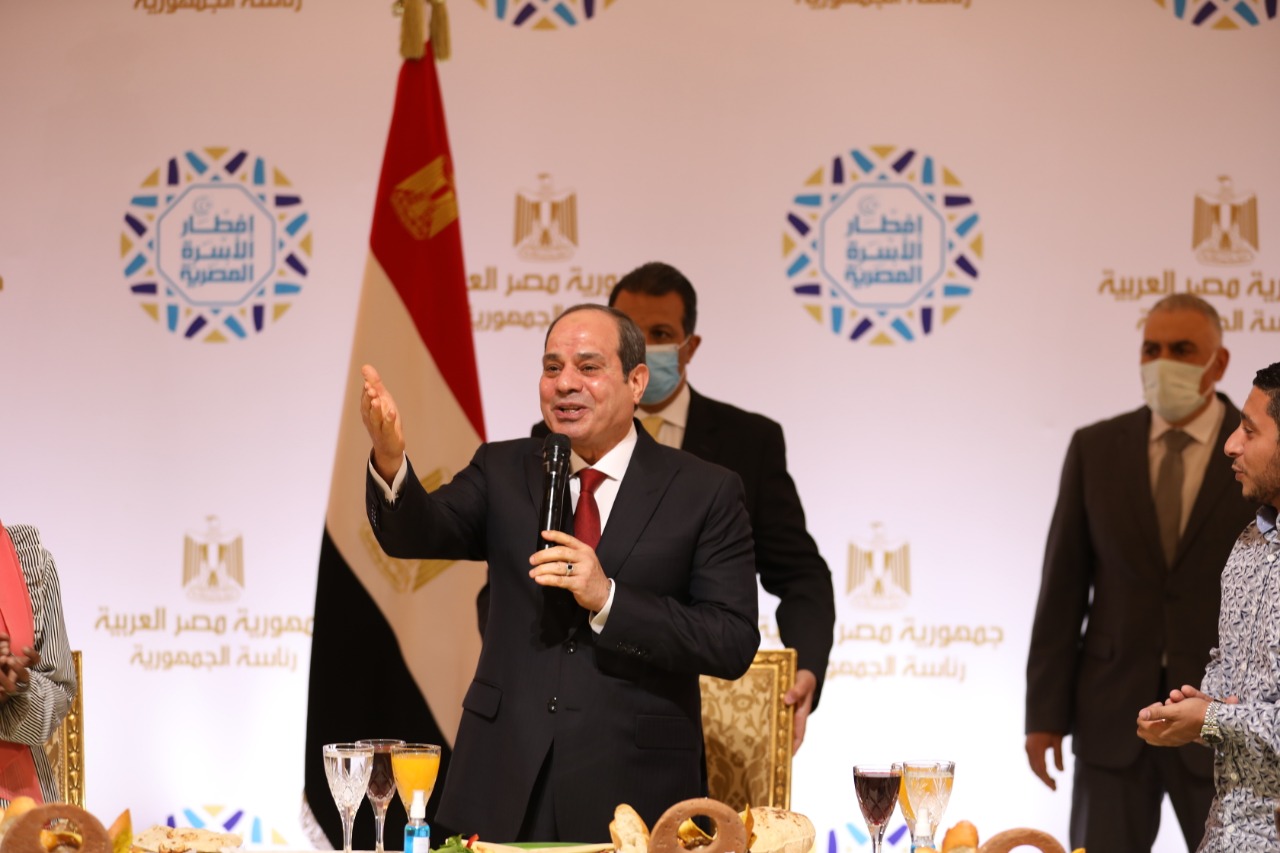
كذلك يحدث كثيرا أن تتوحد أحزاب المعارضة نفسها في جبهة وطنية لتواجه حكومة أغلبية برلمانية، تثير استياء شعبيا واسعا، ومن المؤكد أننا نحن المصريون لم ننس بعد تجربة جبهة الإنقاذ الوطني في مواجهة الإعلان الدستوري الديكتاتوري للرئيس الإخواني المرحوم محمد مرسي، قبل خلعه، ومن المؤكد كذلك أننا لم ننس بعد أن جبهة الإنقاذ الوطني هذه هي التي قادت المعارضة ضد حكم الجماعة، وأنها كانت الغطاء السياسي لجماهير 30 يونيو، إلى جانب مشاركتها في قرارات 3 يوليو.
لكن هذا الفهم البسيط والواضح لمدلول وصف “الوطني” للحوار ليس مسلما به عند الكثيرين، ومنهم أعضاء في مجلس الأمناء، فضلا عن إعلاميين وكتاب وربما سياسيون في أحزاب الموالاة، فهم يفضلون وصفه بالحوار المجتمعي، تهربا من الاعتراف بأنه حوار بين سلطة ومعارضة، وفي أحسن الأحوال يروجون لمقولة الكل في واحد، فالجميع مصريون وطنيون يريدون الخير لمصر، فلا داعي لتقسيمنا بين معارضة وموالاة، وكأن مصر من كل بلاد الدنيا يعيبها أن تظهر فيها معارضة، كما يرى البعض أن الحرص على مشاركة جميع الأحزاب الشرعية في مجريات الحوار. سواء مقررين أو مقرين مساعدين للجان المنبثقة أو كمتحدثين في اجتماعات هذه اللجان يعد نوعا من المحاصصة البغيضة، التي تئن منها العراق ومن قبلها لبنان، وهذا قياس في غير محله، أو مع حسن الظن قياس مع الفارق الشاسع جدا، فالمحاصصة تكون بنسب مقننة دستوريا ومن ثم فهي ثابته، ثم إنها محاصصة في تقسيم مقاعد السلطة التشريعية والتنفيذية وربما القضائية، وليست كما هو في حالتنا إتاحة الفرصة لجميع الآراء في حوار ليس له سلطة ولا قرار، اللهم توصيات ترفع للرئيس صاحب القرار، بما في ذلك المتفق عليه والمختلف حوله بنص لائحة مجلس الأمناء، وأخيرا في هذه النقطة فإن محاصصة لبنان والعراق هي محاصصة طائفية فقط لا غير، في حين أن التوزع في مصر أو بالأحرى في الحوار الجاري هو سياسي بامتياز فقط لا غير أيضا، ومع ذلك فالحكومات الائتلافية أو حكومات الوحدة الوطنية في كل بلاد الدنيا يتفق في تكوينها على نسب أو حصص من المقاعد الوزارية لكل حزب مشارك، لكننا على أية حال لسنا من قريب أو بعيد في وارد توزيع مقاعد وزارية في حالتنا هذه، وإنما نحن بصدد منصة لتبادل الآراء، أكرر منصة لتبادل الآراء وحسب، أو بحسب قول الرئيس السيسي نفسه لنسمع بعضنا البعض.
أما في أسوأ الأحوال فالباعث على نفي صفة (الوطني السياسي) عن الحوار هو التلميح لضعف المعارضة، بما لا تستحق معه -من وجهة نظر القائلين- أن تكون طرفا مناظرا للسلطة، أو ندا لها في حوار، وبالطبع يشمل هذا التلميح الحركة المدنية الديمقراطية، بأحزابها وشخصياتها، ومن باب أولى يشمل الأحزاب العديدة غير المنضمة لتلك الحركة، مع عدم التردد في وصف كل الأحزاب بأنها كرتونية، وليس لها رصيد شعبي حقيقي.
الرد العملي المباشر على هذه المقولة سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن دور جبهة الإنقاذ الوطني في مواجهة دستور جماعة الإخوان، وفي تصدر المشهد السياسي حتى 30 يونيو 2013، وليست الحركة المدنية الديمقراطية إلا امتدادا لتلك الجبهة بعد أن رحل من رحل، وبعد أن اعتزل من اعتزل، وبعد أن حوصر من حوصر، وشوه من شوه، وسجن من سجن، مما هو معلوم للكافة بالضرورة.
ثم إن هذه الأحزاب الموصومة بالكرتونية خاضت بأقل الإمكانات المالية والتنظيمية معركة انتخابية ثرية ومثيرة أمام الأحزاب الدينية العريقة تنظيما والمتخمة ماليا في برلمان 2012، وبعضها لم يكن مضى على تأسيسه بضعة أشهر كالمصري الديمقراطي الاجتماعي، كما كانت هذه الأحزاب هي صلب جبهة الإنقاذ، والمفترض بل المتيقن منه -لو كان قد تم الالتزام بخريطة الطريق الصادرة يوم 3 يوليو 2013- أن هذه الأحزاب مؤتلفة أو مختلفة ستحقق أغلبية برلمانية مريحة دون أي افتئات، حتى لو كانت الأحزاب الدينية شاركت في تلك الانتخابات.
وأخيرا في هذه النقطة أيضا، فهل أحزاب الموالاة هي حقا ذات الرصيد الشعبي، والقاعدة الجماهيرية الواسعة، أم أنها لا تستمد وجودها من الأصل سوى من التصنيع السلطوي؟
أظن الإجابة معروفة، إذ إنها قصة الأمس واليوم، منذ جبهة التحرير فالاتحاد القومي؟ ثم الاتحاد الاشتراكي؟ ومن بعده حزب مصر؟ والحزب الوطني، وأخير مستقبل وطن، وأترابه.
من المؤكد أنه لم يخطر ببالي تنزيه الأحزاب المعارضة القائمة، بما في ذلك الحركة المدنية الديمقراطية عن العيوب والسلبيات، فأنا ممن يدركون هذه السلبيات جيدا، وسبق لي أن كتبت كثيرا عن عيوب الحركة الحزبية. وانشغالها بالاحتجاج أكثر من انشغالها بالبناء التنظيمي والبرامجي، وتكرار الانشقاقات عند أول خلاف، ولكن الجزء الأكبر من هذه العيوب راجع إلى غياب الثقافة الحزبية والثقافة السياسية عموما. وإجهاض التجربة أولا بأول بما يحول دون تراكم الخبرات، وعزوف الجماهير عن المساندة إيثارا للسلامة.
وعليه فكما يقول الشاعر: لا تشكو من جرح أنت صاحبه”، وليتنا نتفق على أن الحوار الوطني كما فهمناه من دعوة الرئيس هو وصفة لعلاج هذا الجرح، ولكن بشرط عدم ارتطامه بتلك التضاريس الوعرة التي أشرنا هنا إلى بعضها، والتي يعرف الجميع بعضها الآخر وهو عدم كفاية حالات العفو الرئاسي عن مسجوني الرأي، وكذلك عدم كفاية حالات الإفراج من الحبس الاحتياطي، مع تقديرنا الكامل لما تحقق حتى الآن في الملفين، وشكرنا لكل جهد بذل، أو يبذل في هذا الاتجاه.






