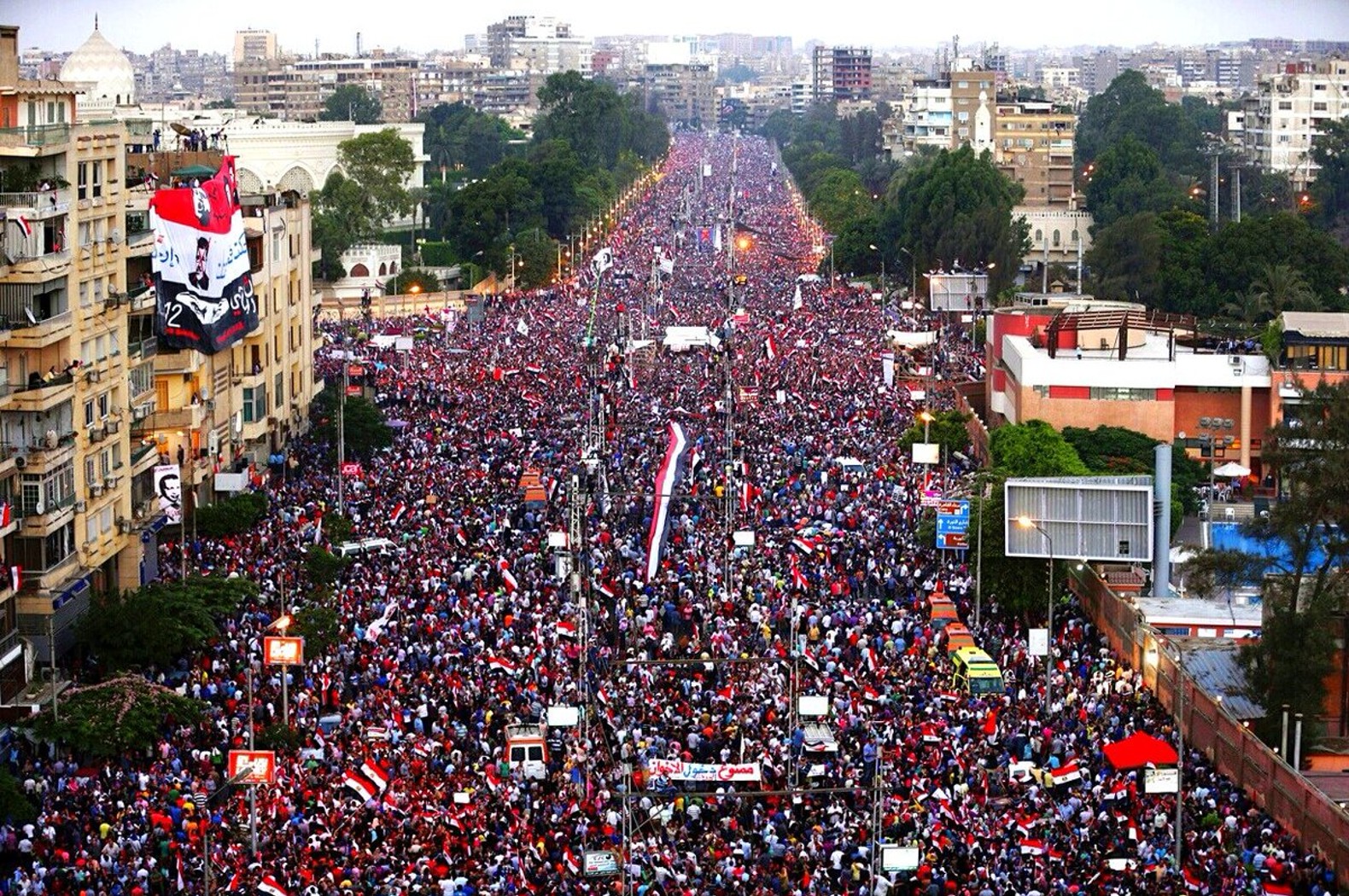ذكرنا في المقال السابق كيف استطاع نظام 30 يونيو أن يتحكم في الدولة والمجتمع عبر استراتيجية “الردع العام”، وقد حققت الاستراتيجية نتائج واضحة وملموسة أهمها قدرة النظام على تجاوز عدة أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، بفضل الهيمنة الكاملة على كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، كما نجح النظام في مصادرة المجال العام وخنق المجتمع المدني، وهو ما ساهم في توفير سلطة مطلقة للقيادة السياسية لتنفيذ خططها السياسية والاقتصادية.
ويعتبر من أهم علامات نجاح استراتيجية الردع، تقويض المعارضة عبر عدة ضربات أمنية وإعلامية، قضت على أغلب التنظيمات المعارضة. كما وأدت محاولات التنظيم في مهدها، ونتج عنها تغييب السياسة عن أجيال جديدة كان من الممكن أن تكون خلفا لجيل يناير.
ولكن الاستراتيجية المتبعة رغم نجاحاتها، إلا أنها أنتجت عددا من الآثار الجانبية التي ربما لم يضعها النظام في حسبانه وقت التنفيذ. فإن غياب المعارضة الداخلية خلق بيئة حاضنة لتشكيل معارضة الخارج، والتي كانت أكثر عنفا وشراسة وربما تطرفا من معارضة الداخل، كما أن لديها من الأدوات ما لا يمكن أن يتوفر في الداخل من قدرات إعلامية وتكنولوجية وعلمية، بالإضافة الى شبكة واسعة من العلاقات مع حلفاء الدولة المصرية الدوليين وخصومها بالخارج.
كما أن عدم وجود قناة اتصال بين بقايا المعارضة والنظام، وتراجع دور عدد من الوسطاء ممن كانوا ظهيرا سياسيا لنظام 30 يونيو في سنوات الحكم الأولى، وتهميش أدوارهم إلى مساحة محدودة من العمل السياسي، قد ساهم في “شرعنة” ما كان يطلق عليه قديما “التدخل الأجنبي”.
فقد ساهمت الوساطات الأجنبية في إنجاز ما فشلت فيه الوساطات وأحيانا الرجاءات الداخلية. كما أن الانتقادات الدولية للانتهاكات ضد المعارضين، والتي وصلت أحيانا إلى درجة العقوبة عبر تخفيض ووقف المساعدات الأجنبية، قد ساهمت في تجميل صورة الأطراف الدولية باعتبارها داعما لحقوق الشعب في مواجهة انتهاكات الدولة.
ظلت المعارضة خلال سنوات حكم مبارك تحمل غضبا تجاه الحكومات الغربية، ربما يصل إلى حالة الكراهية في بعض التيارات، ورغم كل محاولات الغرب تحسين صورتها عبر دعم المجتمع المدني، والضغط على نظام مبارك لإتاحة مساحات أوسع للمعارضة وتهيئة مناخ ديمقراطي. إلا أن المعارضة ومن خلفها قطاع واسع من الجماهير ظلت تُحمل الغرب المسئولية عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية بسبب دعمهم للأنظمة القمعية في المنطقة العربية.
وهو ما لم يعد قائما الآن، حيث تسبب نظام 30 يونيو في إضعاف قطاع واسع من المعارضة يقف في مقدمته التيار القومي الناصري، وإضعاف حجج التيار في دعم الاستقلال الوطني ورفض التدخل الخارجي بأي صورة، بعد أن تحولت الصورة الذهنية لشعارات “رفض الهيمنة الغربية”، إلى مجرد إطلاق يد النظام لاعتقال المعارضين وحجب المواقع الإخبارية وتعيين البرلمان، هل من الممكن أن ترفض المعارضة الضغوط الخارجية -المعلنة وغير المعلنة- على النظام للإفراج عن المعارضين من أجل “شعارات”؟!
كما أن غلق الأبواب أمام المعارضة، وعدم وجود حزب سياسي حاكم، وانعدام دور البرلمان، وتراجع دور الوسطاء المقربين من النظام والمعارضة، وإصرار القيادة السياسية على تنفيذ استراتيجيتها للردع العام، دون وجود أي منافذ للحوار، عزز من دور الحكومات الأجنبية سواء كانت لحلفاء أو خصوم للعب دور الوسيط، وفتح قنوات اتصال مع المعارضة، فقد تحولت السفارات إلى دواوين مظالم تقدم إليها المطالب والشكاوى وترفع إليها التقارير، كما يرد عليها النظام بشكل مباشر عبر المسؤولين الحكوميين أو عبر الإعلام بالتبرير والوعود.
كذلك فإن من أبرز الآثار الجانبية التي اتضحت خلال السنوات الماضية، صعوبة قياس الرأي العام، فإن وجود معارضة داخلية وتنظيمات تعمل داخل إطار الدستور، يمنح النظام والمعارضة أدوات واضحة لقياس الرأي العام والتنبؤ بتصرفاته، ورصد ردود الأفعال على القرارات والتشريعات التي تصدرها الدولة، ربما تقوم الأجهزة الأمنية بهذا الدور عبر تقارير أمنية وتقديرات للموقف، ولكن التقارير الأمنية ليست فعالة بدرجة كبيرة في مواجهة الهبات العشوائية للجماهير، بالتأكيد يمتلك الساسة درجة أعلى من الحساسية.
لازال هناك بالتأكيد عدد كبير من الآثار الجانبية الأخرى مثل غياب النقد للقرارات الخاطئة مما يجعل من تغييرها بعد اكتشاف الخطأ أكثر تكلفة، كما تسببت الحالة العامة في تراجع كبير لدور الإعلام بعد تأميمه وتحوله إلى إعلام تعبوي يهدف إلى دعم الدولة والترويج للإنجازات، بالإضافة إلى غياب الأمل وانتشار حالة من اليأس والخوف من المجهول، سببها الرئيسي غياب الشفافية والديمقراطية في القضايا العامة.
رغم ما حققته خطط النظام من توفير الأمان السياسي له، باعتبار ذلك علاجا قاسيا ودواء مرا لشفاء الدولة من تبعات ثورة يناير، والوقاية من تكرار تلك التجربة، إلا أن الآثار الجانبية أحيانا قد تكون أكثر خطورة من المرض ذاته.