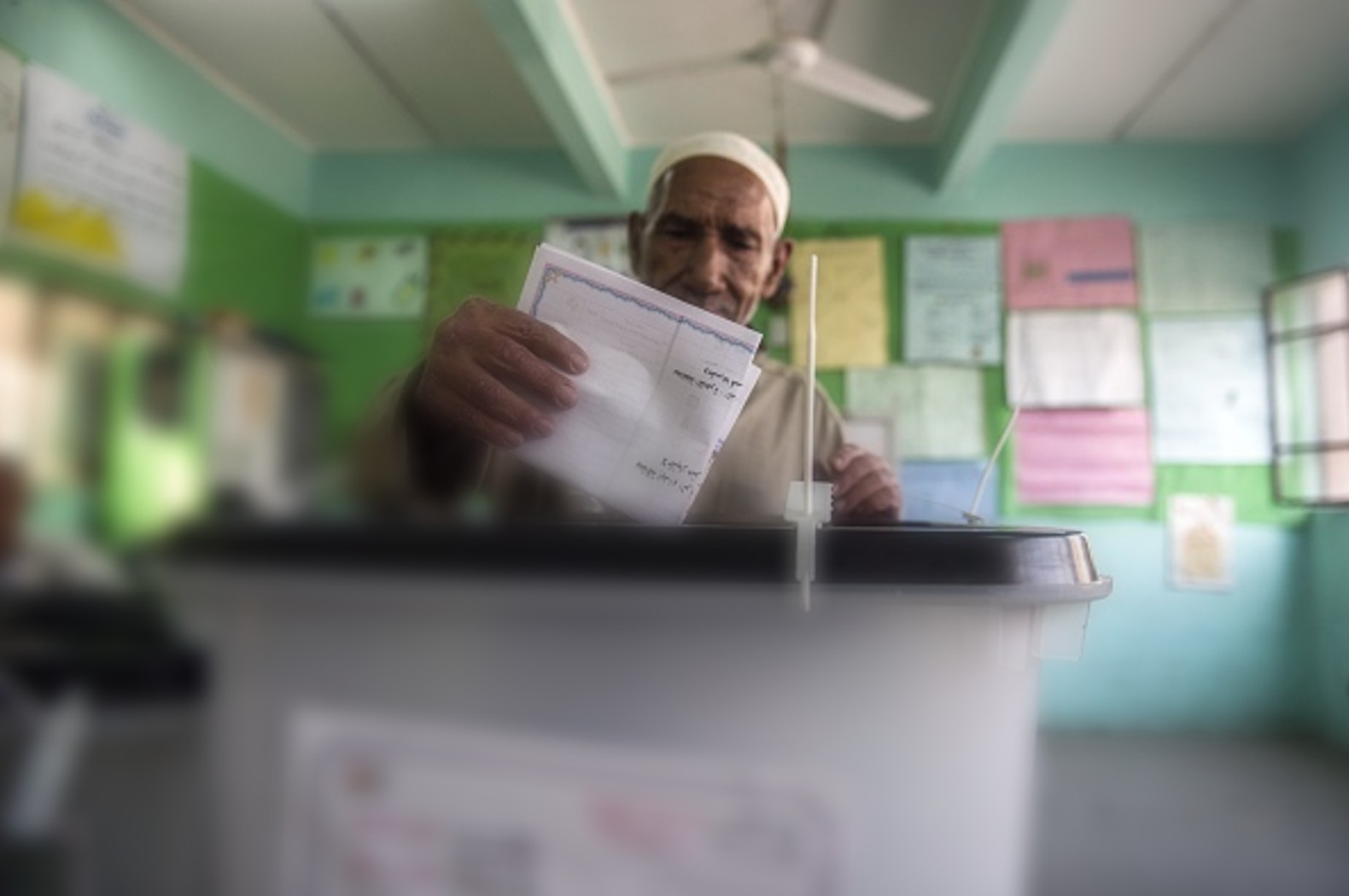بالرغم من أن الظاهرة لا تزال كلامية في معظمها حتى الآن، أو هي حركة في المكان من جميع الأطراف، في أحسن الأحوال، فإنه تطور إيجابي في حد ذاته أن يتبدى كل هذا القدر من الانشغال بانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، بعد عام من اليوم تقريبا، ومن أهم معالم الإيجابية في هذا الانشغال اتفاق الجميع – رغم الخلاف حول كل شيء آخر – علي الطريق الانتخابي السلمي طريقا وحيدا للتغيير، ولو علي المدي الطويل، فلا حاجة لثورة، ولا طاقة لنا بها، ولا رغبة في انقلاب، ولا خير يرجي منه.
هذا إذن وعي جديد، واكتشاف حميد، حتى وإن أملتهما الخيبات القريبة دفعت في سبيل الوصول إليهما أثمان باهظة من الدم، والأمن والحريات ولقمة العيش. لكن هذا هو بالضبط معنى التعلم من التجارب، ومعنى أن التاريخ يهمل الذين لا يتعلمون دروسه.
فيما عدا هذه الخلاصة الواضحة، فإن كل بقية المعالم أو الإشارات على الطريق غير واضحة بما يكفي، أو هي في حقيقة الأمر لاتزال خافتة، فضلا عن أن الطريق نفسه ضيق، إلى حد قد لا يسمح بالحركة السريعة الواثقة عليه.
لنبدأ بأطروحات الراغبين أو الآملين في تغيير سلمي بالانتخابات، وهم كل من يصنف نفسه معارضا للنظام القائم، أو لسياساته الكبرى، وهؤلاء منهم من يعارض من الداخل ، ومن يمارس المعارضة من الخارج ،ومنهم من يتمتع بصفة الشرعية الدستورية، وأبرزهم أحزاب الحركة الديمقراطية المدنية الاثنى عشر، وشخصياتها العامة، ومنهم غير المنضمين للحركة من أحزاب وشخصيات، ومن معارضي الداخل أيضًا من أسميتهم في مقالات سابقة بالمعارضين من منازلهم، وهم الأغلبية، ولكنهم أيضًا ليسوا من حزب الكنبة، وإنما هم ناشطون بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي، فيطرحون أفكارًا ومقترحات، بل ومشروعات محترمة أحيانا.
لكن كل هذه الفئات -بمن فيهم معارضو الخارج- يشتركون في نقطة اتفاق واحدة، وهي الدفع بمرشح مدني متفق عليه لمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستحقاق الرئاسي، غير أنهم مختلفون بعد ذلك على كل شيء، أو لنقل من باب حسن الظن أنهم لم يتفقوا -بعد- لا علي الشخص ولا على البرنامج، ولا على استراتيجية التحرك، وباستثناء توقع ترشح البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ليس هناك أسماء طرحت نفسها لهذا الدور (وهذه نقطة مهمة جدا سأعود إليها توا)، بل إن ما قاله الطنطاوي نفسه، هو فقط أنه سيعود إلى القاهرة من منفاه الاختياري، ليساهم في طرح البديل المدني للرئاسة، ولم يقل صراحة بعد إنه سيترشح بنفسه، وفضلًا عن ذلك، فإن المعارضة الرسمية، التي ينتمي إليها الرجل لم تعلن -بدورها بعد- موقفًا محددًا من تصريحاته.
في سياق التوقعات أيضًا، أشار ثلاثة من أقطاب الحركة المدنية -في تصريحات إعلامية منفصلة- إلى نية أو خطة، للاتفاق علي مرشح منافس للرئيس، ولكن أحدًا منهم لم يشر إلى قرار، أو إلى شخصية متفق عليها، أو يرجح الاتفاق عليها، وهؤلاء الثلاثة هم الأساتذة محمد أنور السادات، ومدحت الزاهد، وأكمل قرطام، وبوصفي من الأعضاء المؤسسين لهذه الحركة، وكذلك بصفتي الصحفية، أرجح أن الزملاء الثلاثة كانوا يتحدثون عن المبدأ، أو عما يجب أن يكون بأكثر مما يتحدثون عما هو كائن بالفعل، وذلك دون مصادرة من جانبي على إمكانية تطوير هذا الاتجاه من جانب الحركة المدنية في المستقبل القريب، أو البعيد نسبيًا.
من خارج الحركة المدنية، وبين المعارضين من منازلهم، طرحت أسماء كثيرة، بل أجريت استفتاءات فيما بينهم حول بعض الشخصيات، ومع احترامي الكامل لنيات المبادرين بالاقتراح، ولكل الشخصيات المقترحة، فإن قرار خوض أي انتخابات يجب أن ينبع أولًا: من إرادة المرشح نفسه، ومن إيمانه بالواجب العام، ومن ثقته في قدرته على أداء هذا الواجب، وتحمل تبعاته من بداية ترشحه، وحتى انتهاء مهمته بفرض سقوطه أو نجاحه، فما بالنا بانتخابات رئاسية في مصر بظروفها الصعبة والمعروفة للجميع، والتي سنتطرق إليها لاحقًا، ولذا فلا قيمة عملية في رأيي لهذه الاجتهادات، التي تبقى إيجابيتها الوحيدة هي ما ذكرناه في بداية المقال، من توافق على مبدأ التغيير الانتخابي السلمي.
هنا يغيب عن الكثيرين إحدى أهم بديهيات العمل السياسي، فعدم الرضا عن الأوضاع، أو حتى السخط لا ينتجان بذاتهما تغييرًا، – ولو بالانتخابات الحرة- مهما يبلغ انتشارهما، إذ لابد من التنظيم والحركة في الميدان، ثم القدرة على تمويل الحملات الانتخابية التي تحتاج إعلانات ومطبوعات وسفريات ومؤتمرات إلخ، ولا شيء من هذا سوف تتيحه المعارضة من المنازل، وذلك بفرض أن أحدًا ممن طرحت أسماؤهم سوف يقبل الترشح، وبفرض أن السلطة قبلت التحدي بروح المنافسة الحرة، وهما فرضان مستبعدان، بحكم المعطيات الظاهرة.
بل لا مبالغة في القول بأن إمكانات التمويل والمنافسة الحرة، لن تتوافر أيضًا لمرشح من الحركة المدنية، أو غيرها من الأحزاب، بما أنها تعاني كلها أصلًا من ضعف العضوية، ومن ثم، من ضعف القواعد الجماهيرية، لأسباب لا يجهلها أحد، سواء من داخلها، أو بفعل الحصار الأمني والسياسي الطويل عليها، لكن يبقى أن المحاولة مهمة وضرورية، من حيث المبدأ، بشرط أن نتفق جميعًا على أن الطريق طويل وضيق ووعر، وأن البدايات دائمًا صعبة.
تلك كانت الإشارات الخافتة من فصائل المعارضة، فماذا عن الإشارات من جانب السلطة؟
باستثناء الوضوح القاطع كوضوح شمس أغسطس، لترشح الرئيس السيسي للفترة الرئاسية الجديدة، فإن بقية الإشارات هنا أيضًا خافتة، على الأقل في انتظار خطاب الرئيس في الذكرى الأولي لإطلاق دعوته للحوار الوطني، إذ من الوارد والمنطقي أن يتضمن هذا الخطاب مؤشرات واضحة حول برنامجه للفترة الرئاسية الجديدة، حتى وإن لم يكن الحوار الوطني نفسه قد بدأ واكتمل.
حتى ذلك اليوم القريب جدًا، رشحت بعض التكهنات بانفراج سياسي ملحوظ، ورؤية إصلاحية محتملة.
من هذه التكهنات عفو رئاسي عام، أو جزئي واسع نسبيًا عن المسجونين السياسيين، والتوجيه بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختزال مدد الحبس الاحتياطي،
ومنها التأكيد أو الإيحاء بأن الرئيس سوف يكتفي بالفترة الرئاسية الجديدة، ولن يرشح نفسه بعد انقضائها، وأنها ستكرس لبناء حياة سياسية مناسبة، تحول بالديمقراطية دون عودة التنظيمات الدينية للسلطة، خاصة بعد أن ثبت عقم المحاولات الكثيرة منذ عام 2014 لبناء ظهير سياسي فعال لنظام الحكم الحالي.
ومن التكهنات التي رشحت أيضًا تغيير الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات اقتصادية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وما يجب إنقاذه، على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، التي تضرب المواطن، والمستثمر، والنظام كل يوم بقسوة، وقد قرأت قبيل كتابة هذا المقال تقريرا صحفيا؛ يتحدث عن ترشيح المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، وكانت قد راجت قبل ذلك تكهنات حول أسماء أخرى منها الدكتور محمود محيي الدين مثلا:
وقبل ذلك كله وبعده امتدت التكهنات إلى أن إخراج انتخابات الرئاسة المقبلة لن يعتمد على سيناريو المنع المباشر والصارم للمنافسين المحتملين للرئيس السيسي، كما حدث في الدورة السابقة، ولكن طبعًا مع التسليم مسبقا بإعادة انتخابه المؤكدة.
بما إننا نقول إنها مجرد تكهنات رشحت هنا وهناك، فليس بوسع أحد التنبؤ بتحققها من عدمه، ولكن هذه المرة لن يطول الانتظار، فخطاب الرئيس بعد أيام، و بعدها ينطلق الحوار، وفي غضون ذلك يعود أحمد الطنطاوي لنرى ما سيحدث منه وله، في حين يفترض أن الحركة الديمقراطية المدنية سوف تحسم موقفها من الحوار وحول انتخابات الرئاسة القادمة قريبًا جدًا، وعندها قد تسطع بعض الإشارات، ويتسع الطريق ولو قليلًا، وقد يخفت كل شيء، ويضيق الطريق حتى يغلق تمامًا، وهو ما لا نتمناه قطعًا.