في مطلع عام 2024م، تحتفل مصر بمرور قرنين كاملين على تأسيس الجيش الحديث في 1824م، كما تحتفل بمرور مائة عام على أول وزارة وفدية تمثل الشعب بقيادة سعد باشا زغلول، كما تحتفل بمرور مائة عام على تشكيل أول برلمان منتخب في ظل دستور 1923م، وفي أعقاب الثورة المجيدة في 1919م.
ومعنى الجيش الحديث ينصرف إلى أمرين: أولهما، أن أساليب التجنيد والتدريب والقتال باتت تجري وفق النمط الأوروبي، وبالذات الفرنسي، وأما الأمر الآخر، فهو أن الجيش مؤسسة حرب لا مؤسسة حكم، إذ كان القرار السياسي بيد الباشا كحاكم سياسي لا بيد نجله القائد إبراهيم كرئيس لأركان الجيش وقائد عسكري. أما فكرة أن يكون في مصر ثورة في 1919م ، يترتب عليها دستور في إبريل 1923م، ثم انتخابات حرة في خاتمة العام، ليكون في مصر عام 1924م برلمان منتخب وحكومة تمثل حزب الأغلبية، فهذه فكرة معناها، أن مصر لديها خبرات تاريخية في تجريب الديمقراطية، ولديها خبرات في تمكين الشعب من مزاولة السياسة، وفي التعبير عن إرادته في اختيار من يمثله، بعكس ما آلت إليه الأوضاع وقت كتابة هذه السطور، حيث لا يتمتع الشعب المصري بتجريب الديمقراطية ولا يتذوق الانتخابات الحرة، ولا يتمكن من التعبير عن إرادته الحرة في اختيار من يحكمونه، حيث من المعلوم بالضرورة أن أجهزة الدولة العميقة تتولى تستيف، وتكييف وإخراج كافة الانتخابات وفق مصلحة الحاكم لا وفق إرادة الشعب.
السؤال الآن: لماذا انتهى التحديث إلى عكس المقصود منه؟ لماذا الشعب يُحكم بالقوة ولا يحكم بإرادته؟ أين ذهب كفاح المصريين على مدار قرنين من الزمان؟ كيف نستعيد الكفاح الديمقراطي؟ كيف نسترد احترام الدستور؟ كيف نُحيي ما قد مات من دولة القانون؟ كيف يمكن إحياء مفهوم الشعب صاحب السيادة؟ الشعب الذي يحكُم ولا يُساق، الشعب الذي يملك ولا يُستعبد ولا يُستبعد، الشعب الذي يعيش في أمان الحق والواجب لا في الرعب والخوف؟ لماذا خلاصة قرنين من الحديث حالة من البداوة السياسية المحضة؟ لماذا الحكم الفردي المطلق؟ هل هذه مجرد عثرة تاريخية أم وضع مزمن؟ وهل من آفاق ممكنة للخروج؟ هل ممكن للتحديث أن يصوب مساره ويعدل وجهته في الطريق الصحيح؟. هذه وغيرها من الأسئلة جديرة بأن تكون من الأولويات المطروحة على كل من هو مهموم، ومشغول البال بمستقبل هذا البلد الأمين، خاصةً ما يدور من الأسئلة حول: التخلف السياسي الراهن، ثم التعثر الاقتصادي الحالي في عهد ما يسمى الجمهورية الجديدة من عام 2014م وما بعدها.
– مصر قبل التحديث، أي قبل استقلال علي بك الكبير 1768م، وقبل غزو ثم حكم نابليون 1798م، وقبل حكم محمد علي باشا 1805م، كانت من الناحية السياسية تتبع الإمبراطورية العثمانية التي كانت قد دخلت طور التراجع، ثم التحلل التدريجي بعد فشل القوات العثمانية في حصار فيينا الأخير 1683م، لكن من الناحية الاقتصادية كانت مصر لها فرادتها الخاصة، وكانت لها إمكاناتها التي تميزها عن باقي الإمبراطورية، صحيح لم يكن فيها حكم مركزي رشيد، لكن قوى المجتمع الحية كانت في وضع تتمكن معه من الإنتاج زراعةً وصناعةً ومن التجارة استيراداً وتصديراً، صحيح كانت ساحةً مفتوحة لصراعات المماليك، لكن لم تكن في عزلة كما تصور لنا الكتابات التي دُبجت في فضائل الغزو الفرنسي، أو دُبجت في مناقب الباشا وذريته من بعده.
أفضل شهادة تصور أحوال مصر الاقتصادية بالذات عند خاتمة القرن الثامن عشر، ومطلع القرن التاسع عشر هي، شهادة نابليون ذاته.
هنا، أنقل شهادة نابليون عن إمكانات مصر الاقتصادية، من ص 111 من الترجمة العربية لمذكراته عن مصر، يقول نابليون: ” وفي أثناء الأربعين شهراً في عهد الإدارة الفرنسية، كان على البلاد – يقصد مصر – أن تتحمل : 1 – الحرب والغزو في عام 1798م. وهو يقصد أن مصر تحملت نفقات الجيش الفرنسي. 2 – والحرب وغزو الصدر الأعظم 1800م. ويقصد أن مصر تحملت نفقات الجيش العثماني الذي جاء؛ لاسترداد مصر من الفرنسيين . 3 – وغزو الإنجليز عام 1801م. ويقصد أن مصر تحملت نفقات الجيش الإنجليزي الذي جاء؛ لإخراج الفرنسيين واحتل الوجه البحري لفترة من الزمن ” . ومعنى كلام نابليون، أن اقتصاد مصر كان يتحمل نفقات كافة الغزاة من فرنسيين وعثمانيين وإنجليز، فهل وقف الأمر عند هذا الحد؟. لم يقف الأمر عند هذا الحد.
يستكمل نابليون شهادته فيقول: ” ومع ذلك، ففي أثناء الأربعين شهراً، حصلت الخزينة الفرنسية – من مصر – على ثمانين مليوناً ، كما حصَل المماليك من جانبهم، وحصَل جيش الصدر الأعظم من جانبه، وكلف الجيش الإنجليزي البلاد كثيراً، واستفاد العرب كثيراً في هذه الأزمة – يقصد بالعرب الأعراب والعربان والقبائل الرحل الذين قدموا خدمات للجيوش – “.
ويقدر نابليون إجمالي الدخل القومي المصري في ذاك الوقت فيقول: ” ويمكن أن نقدر دخل مصر في الوضع الحالي، بخمسين مليون فرنك، وقد قدر إستيف ( Steve ) مدير المالية، دخل مصر عام 1801م، بمقدار ثمانية وأربعين مليون فرنك، رغم أن البلاد كانت في حالة حرب، وكانت تجارة البحر المتوسط، قد أعاقتها جولات الأعداء البحرية “.
ثم ينتقل نابليون من الحديث عن إمكانات مصر الاقتصادية إلى الحديث عن ترجمة هذه القوة الاقتصادية إلى قوة عسكرية، فيقول: ” تستطيع مصر من اليوم أن تساهم في إعالة جيش من خمسين ألف رجل، وعمارة بحرية – يقصد أسطولاً حربياً – من خمسة عشر سفينة، جزء منها في البحر المتوسط، وجزء منها في البحر الأحمر، وعدة أساطيل صغيرة في نهر النيل وفي البحيرات . وتوفر مصر كل ما قد يكون ضرورياً ما عدا الخشب والحديد، واللذين تحصل عليهما من ألبانيا وسوريا وأوروبا؛ مقابل منتجاتها الأخرى، وتصل مساهمتها – يقصد قيمة المنتجات المصرية – إلى خمسين أو ستين مليوناً “.
وجهة نظر نابليون أن مصر بلد ذات رخاء، ولكن مشكلتها في نظام الحكم والإدارة، كما كانت وجهة نظره أن هذا الرخاء من الممكن أن يتضاعف ويتزايد، إذا توفرت لمصر نظام حكم وإدارة فرنسية، وقد ذهب يتصور خطتين لمستقبل الرخاء الاقتصادي المصري: خطة قصيرة الأجل من عشر سنوات، ثم خطة طويلة الأجل من خمسين عاماً.
يتساءل نابليون: ” ولكن إلى أية درجة من الرخاء، يمكن أن يرقى هذا البلد الطيب، إذا كان محظوظاً بما فيه الكفاية؛ ليتمتع – خلال عشر سنوات – بالسلام ومنافع الإدارة الفرنسية؟ ”
ثم يجيب نابليون موضحاً ملامح خطته العشرية فيقول: ” في هذه المدة من الزمن، سيكون قد تم تحصين الإسكندرية، بحيث تصبح هذه المدينة من أقوى المدن المحصنة في أوروبا ( يقول في أوروبا وليس في البحر المتوسط، وهذا يفسر لك، لماذا وكيف تحولت الإسكندرية في القرن التاسع عشر من قرية صغيرة إلى مدينة أوروبية جامعة لكافة أجناس أوروبا )؟ “، ثم يستكمل نابليون فيقول: ” ويصبح شعبها هاماً جداً ( يقصد شعب الإسكندرية وبالفعل كانت الإسكندرية مسكونة بنوعية بشرية مختلفة تماماً عن باقي مصر )، ويواصل فيقول: ” وستكون قد انتهت دار الصناعة البحرية، وسيصل النيل كل عام عن طريق ترعة الرحمانية إلى الميناء القديم، بما يتيح الملاحة لأكبر عدد من القوارب، وتتركز فيها كل تجارة رشيد، وأيضاَ كل تجارة دمياط تقريباً، وكذلك كل المنشآت المدنية والحربية، وعندئذ ستصبح الإسكندرية مدينة غنية، ويخصب ماء النيل المنتشر حولها عدداً من الحقول، وتصبح في نفس الوقت مكاناً؛ للإقامة الممتعة المفيدة للصحة والآمنة “.
ثم بعد مشروعه لتطوير الإسكندرية ينتقل إلى حلم وفكرة قناة السويس فيقول نابليون: ” وسيتم فتح الاتصال بين البحرين – يقصد الأحمر والمتوسط – ويتم تشييد ورش السويس، وتقام تحصينات لحماية المدينة والميناء، ويزود ري الترع والصهاريج الشاسعة المياه لزراعة ضواحي المدينة “.
ثم ينتقل إلى منطقة البحر الأحمر فيقول: ” ستقيم قبائل، وتشيد تحصينات؛ حيث ترسو عمارة البحر الأحمر – يقصد أساطيل البحر الأحمر – “. ثم يتحدث عن إصلاح الدلتا وتجفيف البحيرات وتوسع الزراعة، فيقول: ” وتجفف بحيرات المعدية والبرلس والمنزلة أو تخفض كثيراً، وتُعاد زراعة أرض ذات أهمية كبرى، وتكفي المواد الغذائية الخاصة بهذه المستعمرات – يقصد المزارع الجديدة – كالسكر والأرز والنيلة حاجة كل الصعيد، وتنظم أسلوب الفيضان والري الكثير من السدود والعديد من مضخات الحريق “.انتهت ملامح الخطة العشرية التي وضعها نابليون؛ لزيادة رخاء مصر الاقتصادي تحت الحكم والإدارة الفرنسية، وواضح منها، أن الإسكندرية هي العصب الجغرافي للخطة؛ بما أن الاسكندرية ذات تاريخ إغريقي وروماني ومن الممكن صناعة تاريخ أوروبي حديث لها، وإدماجها في أوروبا أو إلحاقها بها كمستعمرة أو مستوطنة نموذجية في الشرق، ثم قناة السويس، ثم الرى، ثم الزراعة . ومن البداهة، أن هذه المقترحات شكلت تاريخ مصر طوال القرن التاسع عشر.
– قبل الحديث عن خطة نابليون طويلة المدى، خطة الخمسين عاماً، أود الإشارة إلى شهادة رفاعة الطهطاوي عن الإسكندرية، وهي شهادة تثبت أن تطور المدينة في عهد محمد علي باشا، لم يبتعد عن التصور الذي رسمه لها نابليون، ففي رحلة الذهاب إلى فرنسا عام 1826م، مكث ثلاثة وعشرين يوماً في الإسكندرية، في انتظار السفينة المتوجهة إلى فرنسا، وفي الفصل الأول من كتاب ” تخليص الإبريز في تلخيص باريز ” الذي صدر أول مرة عام 1834م، وتحت عنوان ” في الخروج من مصر إلى دخول ثغر الإسكندرية “، كتب يقول: ” وكان دخولنا الإسكندرية يوم الأربعاء، الثالث عشر من شعبان، فمكثنا فيها ثلاثة وعشرين يوماً في سراية ولي النعمة – يقصد قصر محمد علي باشا – وكان خروجنا إلى البلد في هذه المدينة قليلاً، فلم يسهل لي ذكر شيء عنها، غير أنه ظهر لي أنها قريبة الميل في وضعها وحالها إلى بلاد الإفرنج، وإن كنت وقتئذ لم أر شيئاً من بلاد الإفرنج أصلاً، وإنما فهمت ذلك، مما رأيته فيها دون غيرها من بلاد مصر، ولكثرة الإفرنج بها، ولكون أغلب السوقة يتكلمون ببعض شيء من اللغة الطليانية، ونحو ذلك، وتحقق ذلك عندي – يقصد تحقق كونها قطعة من أوروبا – بعد وصولي إلى مرسيليا، فإن الإسكندرية عينة من مرسيليا وأنموذج منها “.
ثم تكررت زيارة الطهطاوي إلى الإسكندرية عام 1846م – أي في أواخر عهد محمد علي باشا – فكتب يقول: ” ولما ذهبت إليها سنة 1262 هجرية – 1846م وجدتُها قطعة من أوروبا “.
خطة نابليون في 1798م، من أجل ” إسكندرية أوروبية ” صارت واقعاً في حكم الباشا، ويشهد على ذلك الطهطاوي الذي زار المدينة مرتين، بينهما عشرون عاماً، مرة في طريق ذهابه إلى فرنسا 1826م ضمن أول بعثة دراسية حديثة إلى أوروبا، ثم زيارة ثانية، وهو في قمة النضج الفكري عام 1846م، وقد شهد في المرتين أنها قطعة من أوروبا، خاصةً بعد أن عاش في فرنسا ست سنوات .
هذا يضع يدك على حقيقة التحديث الذي جرى في القرن التاسع عشر، تحديث الباشا وذريته من بعده، كما أن هذا يفسر لك نوع المشاريع الكبرى، وماذا كانت تخدم من قناة السويس إلى السكة الحديد إلى مشاريع الري إلى تحديث الزراعة؟ وقبل ذلك أوروبا الإسكندرية، فلم يكن شيء من ذلك مصادفةً أبداً .
– أول رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الإسكندرية في الثامن والعشرين من إبريل 1945م، كانت تحت عنوان ” تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي باشا ” تقدم بها من صار بعد ذلك المؤرخ الشهير الدكتور جمال الدين الشيال 1911 – 1967م، وفيها يصف إصلاحات محمد علي باشا، بأنها ” تُعتبر – إلى حد ما – استمراراً لما بدأه الفرنسيون في مصر “. نكتفي بهذا الاقتباس من الدكتور الشيال، ونعود له في موضع لاحق.
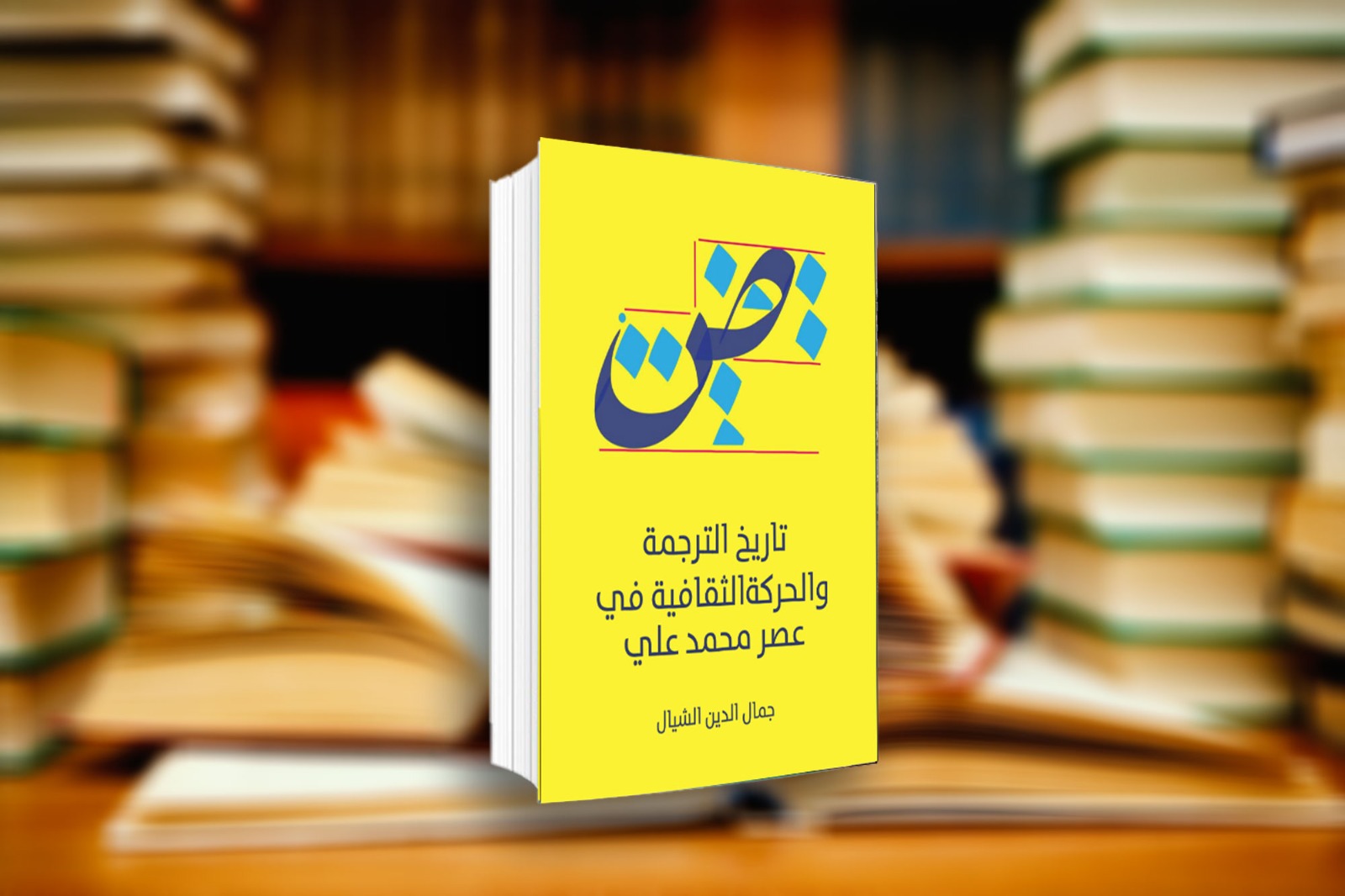
– نعود إلى خطة نابليون لمصر، الخطة طويلة الأجل، خطة الخمسين عاماً، وهنا يتساءل نابليون في ص 112 من الطبعة العربية من المذكرات – ترجمة عباس أبو غزالة – إصدار المركز القومي للترجمة – الطبعة الأولى عام 2019 م، يتساءل نابليون: ” ولكن كيف سيكون هذا البلد الطيب بعد خمسين عاماً من الرخاء، في ظل حكومة عادلة؟ ثم يجيب: ” يجد الخيال متعة في هذه اللوحة الساحرة، حيث ينشأ ألف هويس؛ للتحكم في توزيع الفيضان على كل أجزاء الإقليم، وقد كان يضيع ثمانية أو عشرة مليارات قامة مكعبة من ماء النيل في البحر كل عام، وسوف يتم توزيع الماء على كل الأجزاء المنخفضة في الصحراء، وفي بحيرة موريس، وبحيرة مريوط، وحتى الواحات، بل وأبعد كثيراً من ذلك، من جهة الغرب، ومن جهة الشرق، وفي البحيرات المرة، وفي كل الأجزاء المنخفضة في خليج السويس، والصحراء بين البحر الأحمر والنيل “. ثم يقول، إن هذه المشاريع سوف تستقطب المهاجرين من إفريقيا والجزيرة العربية وسوريا واليونان وفرنسا وإيطاليا وبولونيا وألمانيا، وهذه الهجرة يمكنها أن تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات، وتستعيد تجارة الهند طريقها القديم، أي من خلال مصر، كما كانت قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في خاتمة القرن الخامس عشر.
ويذهب بخطته بعيداً، حيث مصر قوة امبراطورية، تستند بيدها اليمنى على الهند، وتستند بيدها اليسرى على أوروبا، والإسكندرية على قمة العالم، فهي مؤهلة لقيادة العالم أكثر من روما والقسطنطينية وباريس ولندن وأمستردام “.
ويختتم خطته ، بالقول ” وبعد خمسين عاماً من وضع اليد ، سوف تنتشر الحضارة داخل أفريقيا ، عن طريق سنار ، الحبشة ، دارفور ، فزان ، وستقبل أمم كثيرة الدعوة للتمتع بمزايا العلوم والفنون ودين الله الحقيقي ، لأنه عن طريق مصر ستنطلق شعوب قلب أفريقيا نحو النور والسعادة ” . انتهت خطة نابليون ، الخطة طويلة الأجل ، خطة الخمسين عاماً .
ثلاثة رجال فقط من حكام مصر الحديثة، أدركوا أن إصلاح مصر يبدأ بالري، نابليون، الباشا، عبدالناصر. مع فارق خطط نابليون جزءا من مخطط استعماري، مشاريع الباشا – كما يقول الأستاذ الإمام محمد عبده: – لري إقطاعه الكبير، السد العالي خير ما أنجزه قائد لأمته.
– مشاريع التحديث في القرن التاسع عشر، لم تخرج عن خطط نابليون، ولم تخرج عن تمكين قرنسا وعموم أوروبا من مصر والمنطقة، فما لم تمهل المقادير نابليون لإنجازه أكمله الباشا وبنوه من بعده، وهنا نعود إلى كتاب دكتور جمال الشيال المذكور أعلاه، حيث يقول: ” محمد علي باشا لم يندفع في حركته الإصلاحية نحو الغرب اندفاعاً كلياً، بل حاول أن يوائم بين حاجات مصر وتراثها الشرقي، وبينما يريد أن يستورده لها من إصلاحات ونظم وعلوم غربية.” ثم يقول: ” حاول أن ينقل الغرب إلى مصر، ليحقق مثله العليا في الإصلاح، ولكنه لم يحاول – البتة – أن ينقل مصر إلى الغرب، بل احتفظ لها بروحها وتقاليدها “، ويقول: ” أخذ يضع الخطط المختلفة، التي تُعتبر – إلى حد ما – استمراراً لما بدأه الفرنسيون في مصر، والتي التزم فيها سبيلاً وسطاً، فلم يلجأ إلى القديم ولم يتعصب له، لأنه آمن منذ اللقاء الأول، بأن الإصلاح إنما يكون بالنقل عن الغرب ” ويختم بالقول: ” لم يأخذ عن الغرب كل شيء، ولم يعتمد عليه كل الاعتماد، بل اتخذ من المستشرقين والمستغربين خطةً وسطاً “. انتهى الاقتباس من الدكتور الشيال، ويكفيه نزاهةً وشرفاً فكرياً، أنه قال، إن مشاريع الباشا التحديثية استمرار لمشاريع الفرنسيين إبان غزوهم لمصر، وأقول: يكفيه نزاهةً وشرفاً لسببين: إن الكتاب – في الأصل – بحث تقدم به لمسابقة عامة، تستحث شباب الخريجين على التأليف في جوانب من عظمة محمد علي باشا، وأفضاله على مصر ومنها موضوع الترجمة والثقافة،، ثم عُين الشيال مُعيداً في قسم التاريخ بجامعة الإسكندرية الناشئة آنذاك، فطور البحث العام إلى رسالة علمية نال بها أول درجة ماجستير تمنحها الجامعة الوليدة، وقد تكونت لجنة المناقشة من ثلاثة من أكابر الرعيل الأول من المؤرخين المصريين: الدكتور عبدالحميد العبادي، محمد شفيق غربال، محمد مصطفى صفوت. أما السبب الآخر لوصفه بالنزاهة والشرف، فهو أنه في النصف الأول من القرن العشرين، كان التيار الغالب بين المؤرخين المصريين هو إسباغ جملة فضائل العظمة والنبوة والرسالة الوطنية على من حمل لقب مؤسس الدولة الحديث، كان ذلك جزءاً مكملاً لعملية بناء هوية وطنية قومية مع وعقب ثورة 1919م، وقد تبنت هذه السرديات الكثير من الروايات الفرنسية، والأوروبية التي انكتبت في عهد الباشا وبعده تحت رعايته وكفالته وتمويله وتحفيزه.
لم تكن مشاريع الباشا وذريته هي فقط امتداد لخطط نابليون ومشاريعه، بل إن الخطاب الثقافي والأخلاقي الذي جاء به نابليون؛ ليبرر الغزو والاستعمار، كان هو ذاته الخطاب الذي تبنته وعملت تحته دولة الباشا وذريته من بعده، خطاب التمدين ونشر لواء الحضارة وبث النور في مصر وإفريقيا، وقد كان الطهطاوي هو الأمين على تفصيل وتأصيل هذه الخطاب الشارح لفلسفة التحديث في القرن التاسع عشر، كما تصوره نابليون، ثم كما اجتهد في تنفيذه الباشا وبنوه.
– ينقل الدكتور الشيال – في ص 8 – من الكتاب المذكور أعلاه، عن مسيو هامون، ناظر مدرسة الطب البيطري في مصر في عهد محمد علي باشا، ينقل قول الناظر، إن ” ثلثي الأطباء والصيادلة الأجانب، الذين أُلحقوا بالإدارة البيطرية أول إنشائها، كانوا لا يحملون دبلومات أو مؤهلات علمية في الطب، بل إن منهم من كان ممرضاً، ومنهم من كان مدير مكتب تلغراف، ومنهم من كان صانع أحذية، ومنهم من كان نادلاً في مقهى في القاهرة ،،، إن أي أجنبي كان ينزل بأرض مصر، وليست له مهنة يمتهنها، كان يُعيَن صيدلياً أو طبيباً “. انتهى كلام ناظر مدرسة الطب البيطري كما أورد الدكنور الشيال.
– وقريب من هذا المعنى شهادة الأستاذ الإمام محمد عبده – ص 836 من المجلد الأول من مجموع الأعمال الكاملة الصادرة عن دار الشروق – يقول الأستاذ الإمام، إن محمد علي باشا ” اشرأبت نفسه، ليكون ملكاً غير تابع للسلطان العثماني، فجعل من العُدَة لذلك، أن يستعين بالأجانب من الأوروبيين، فأوسع لهم في المجاملة، وزاد لهم في الامتياز، خارجاً عن حدود المعاهدات المنعقدة بينهم وبين الدولة العثمانية، حتى صار كل صعلوك منهم لا يملك قوت يومه ملكاً في بلادنا، يفعل ما يشاء، ولا يُسأل عما يفعل، وصغرت نفوس الأهالي بين أيدي الأجانب بقوة الحاكم، وتمتع الأجانب بالحقوق التي حُرم منها الوطنيون، فاجتمع على سكان البلاد المصرية نوعان من الإذلال: إذلال ضربته عليهم الحكومة الاستبدادية المطلقة، وإذلال سامهم الأجنبي إياه “. انتهت شهادة الإمام الشيخ عبده، وهي من نوع الفكر الذي لا تجد له شبيهاً عند الطهطاوي. ومدرسة التحديث الرسمية ومدارس التاريخ الوطنية.
– المؤرخ الأستاذ عبدالرحمن الرافعي من أكابر من أشادوا وشادوا جملة الفضائل الوطنية للباشا، وذريته وما جرى في عهدهم من تحديث، يغض الطرف عن كل ما يخدش التصور المثالي للباشا، وعهده كمؤسس لما يسمى الدولة الحديثة، فعند ترجمته لشخصية علي باشا مبارك 1824م – 1893م، وعلي مبارك تعلم في عهد الباشا، ولعب دوراً كبيراً في عهد الخديو إسماعيل، حتى لقبه الرافعي ” زعيم نهضة العلم والتعليم في عصر إسماعيل “، يتحدث الرافعي عن كثرة تنقل أسرة علي مبارك – في طفولته – من بلد إلى بلد، ومن قرية إلى قرية أبعد، من برنبال في الدقهلية إلى عرب السماعنة في الشرقية، فيكتفي بالقول، إن ذلك التنقل كان ” نتيجة سوء معاملة الحكام للأهلين في ذلك العصر، وإرهاقهم بالضرائب الجائرة، مما اضطر تلك العائلة وكثيراً مثلها إلى الرحيل فراراً من المطالب التي لم يستطيعوا أداءها، بعد أن تجردوا من ماشيتهم ومتاعهم، وتشدد الحكام في استخلاصها بالسجن والضرب، فلم يجدوا مخلصاً من هذه المظالم سوى الهجرة من موطنهم، وهذا يعطينا صورة من مظالم الحكام في ذلك العهد، إذ لم يكن ثمة قانون يمنع ظلم القوي عن الضعيف، ويحول دون اعتداء الحاكم على المحكوم، ولا ضرائب منتظمة معلومة المقدار، بحيث يعرف كل إنسان حدود ما عليه منها، بل كانت متروكة لأهواء الحكام والرؤساء ” انتهى كلام الرافعي من ص 215 من الجزء الأول من عصر إسماعيل.
إذا كان الدكتور الشيال يقول، أن تحديث الباشا استمرار – إلى حد ما – لتحديث نابليون والحملة الفرنسية، فإن ” لورا لونج ” في كتابها ” ديليسبس وقناة السويس: عبقرية الإنسان والتاريخ ” – ترجمة محمد فريد حجاب، تقديم حسين عيد، صادر عن المركز القومي للترجمة عام 2010 م، تقول في ص 15 من الكتاب المذكور ” فعندما هُزم الأسطول الفرنسي من جانب البحرية البريطانية بقيادة اللورد نلسون، أصبح من المحتم على القوات الفرنسية أن تنسحب من مصر التي كانت تُحكم السيطرة عليها، وقد سأل نابليون: آنذاك – أي بعد الانسحاب من مصر – القنصل الفرنسي في القاهرة، أن يقترح عليه اسم رجل ليرأس الحكومة الجديدة في مصر، على أن يكون هذا الرجل المقترح صديقاً لفرنسا، كان القنصل هو ماثيو ديليسبس، والد فرديناند ديليسبس الذي أشرف على فكرة تنفيذ مشروع نابليون في حفر قناة تصل بين البحرين الأحمر والمتوسط، ديليسبس الأب اقترح اسم محمد علي بك، الذي يفضل الفرنسيين على البريطانيين، فهو الذي سيحفظ المصالح الفرنسية في مصر “. انتهى كلام لورا لونج .
ثم في ص 67 من كتاب ” كارولين جوتييه كورخان ” وعنوانه ” العلاقات المصرية الفرنسية في عهد محمد علي باشا 1805- 1849م ، نقرأ أن مصر كان فيها قنصلان فرنسيان، ماثيو ديليسبس و دروفيتي، وأن ديليسبس في يناير 1804م، رفع تقريراً إلى تاليران رئيس وزراء نابليون يقول فيها: ” بإمكاني أن أؤكد لكم، أنه – يقصد الباشا – لم يعد في مشروعه أي التباس، إنه يريد الاستيلاء على السلطة العليا “.






