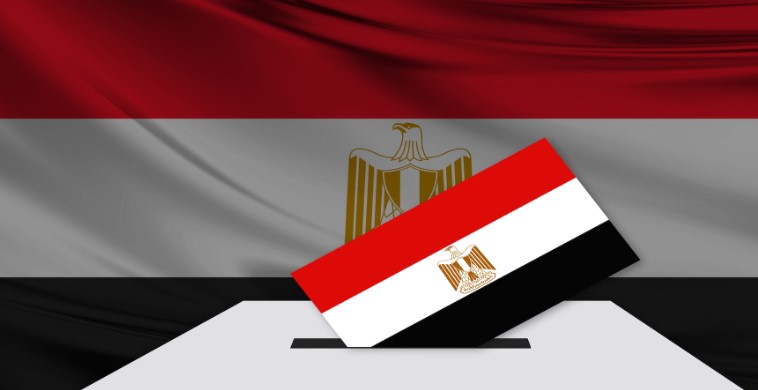ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية، وفي ضوء أزمات محتدمة في الإقليم، وفي القارة الإفريقية، بل وفي العالم، ربما يكون جديرا بنا التساؤل، إذا كنا نسير على الطريق الصحيح الذي يحفظ أمن واستقرار بلادنا وسلامة المواطنين أم لا، وخصوصا أن المرحلة هي مرحلة تنافس بين أقطاب كبرى في العالم، تمهد لنظام دولي جديد، لم يتشكل بعد، وهو ما يفرض تضاغطا في المصالح بين الأطراف، وبيئة قد تكثر فيها الحيل والأعمال القذرة؛ لضمان مصالح جيو سياسية، تسعى لنقاط ارتكاز في المواقع الجغرافية الحساسة، وغني عن البيان، أن مصر بموقعها الجغرافي، وقدراتها البشرية، وإمكانياتها الكامنة، تقع على رأس هذه المواقع حول العالم.
وقد تفرض هذه الحالة تفاكرا في مسألة قوة، وصلابة النسيج السياسي، والاجتماعي المصري، حتى يستطيع مواجهة هذه التحديات جميعها، وهذا التفاكر يفرض أسئلة، عما إذا استمر على ذات المناهج القديمة في مصر، هي في صالح قوة هذا النسيج، أم هي سبب هشاشته أصلا، بسبب استمرارها أكثر من اللازم.
تقليديا وتاريخيا في مصر، يتم بلورة خطاب سياسي محتواه يقول، إن مواجهة التحديات تتطلب وحدة في الصف، والموقف وهو ما يتطلب غالبا تأميم مساحات الخلاف، والتقييم والمراجعة للسياسيات الداخلية، وكذلك هندسة عملية انتقال للسلطة، بشكل يضمن طبقا لهذا التقدير مواجهة التحدي الخارجي الذي غالبا ما اصطلح على تسميته بالمخططات، والمؤمرات الخارجية، ومؤخرا يتم الاستشهاد بعدم الاستقرار الإقليمي، وشيوع الحروب والنزوح وسيولة دول على حدودنا المباشرة وغير المباشرة.
هذه المفردات للخطاب السياسي المصري الحديث، بدأت مع ثورة يوليو، وتمت صياغتها طبقا لضرورات، قد تكون مشروعة ومقبولة وقتذاك، ومنها: التحرر من الاستعمار القديم، و تأسيس نظام جديد بقوى اجتماعية جديدة، ووفق مشروع للتنمية الاقتصادية، كان على حساب بقايا نظام إقطاعي ونظام حزبي فقدا القدرة على الفاعلية، والاستمرار والتمثيل الواقعي لغالبية المصريين، من هنا تفاقمت الأزمة الداخلية، وتحرك شباب الجيش، ووجد الحاضنة الشعبية الكاسحة بطبيعة مشروع جمال عبد الناصر الذي اهتم بمفردات العدل الاجتماعي، والتنمية المخططة، والتي سمحت بتكوين الطبقة الوسطى المصرية الواسعة المؤثرة حتى يومنا هذا.
المأزق الحقيقي الذي نواجهه اليوم، هو استمرار ذات المشروع السياسي، تحت مظلة أوهام، أن معطياته ما زالت موجودة، حيث يتم طرح خطاب بنفس المفردات، وكذلك يتم الاعتماد على آلية هندسة البيئة الانتخابية؛ لتنتج ماهو متوقع وتهمل ضرورة، أن تكون بيئة عادلة تملك ضمانات متساوية للجميع.
المشكل الرئيسي الذي يواجهه هذا السيناريو، أن العشر سنوات الماضية كانت فارقة في وعي المصريين، حيث أدركوا أن مواجهة التحديات، سواء الداخلية أو الخارجية، لن تكون الا بتوافق وطني يملك مصداقية، كما أدرك المصريون أن النجاح في عبور البلاد لمأزق تمكين الإخوان، ومواجهة الإرهاب، لم يكن صناعة أو بطولة فردية، بل هو في الأخير منظومة مؤسسية متكاملة؛ لعبت فيها القوات المسلحة المصرية دورا قائدا بوعي تاريخي، يستند على موروث للمؤسسة، وموروث حضاري لمصر التي هي سبيكة متنوعة، ترفض بنبضها الحي الدولة الدينية الثيوقراطية، وذلك في عقيدة عسكرية تضع المصالح الوطنية الاستراتيجية للدولة المصرية مقدمة على كل ماعداها.
وأدرك المصريون أيضا، أن تدهور مستوى معيشتهم، ودخول غالبية السكان ضمن مؤشرات الفقر، والفقر المدقع، وربما الجوع، هو مسئولية سياسات داخلية، أكثر بمراحل من المسئولية الملقاة على عوامل خارجية، كفيروس كورونا أو حرب أوكرانيا، خصوصا وهم يلاحظون تضخم الإنفاق الحكومي أحيانا في مظاهر بذخ غير مبرر ولا مقبول، و الذي نتج عنه تضخم للديون، دون مساهمة في تعظيم الإنتاج في القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري، والتي تمكنه من تلبية احتياجات الدولة والسكان الداخلية.
في هذا السياق، ربما لم يعد من الممكن الولوج في عملية هندسة للانتخابات على النمط التاريخي لدولة يوليو، نلحظ أنها تجري حاليا على قدم وساق؛ بهدف ضمان فوز فريق يقول بضرورة استكمال مشروع أثقل كاهل المصريين، وبمزاعم إدخال تعديلات، لم يثبت وجود نية لإجرائها، خصوصا وأن عملية الحوار الوطني لم تسفر واقعيا عن شيء، كما لم ينتج عن مخرجاتها التي تمت بلورتها عبر شهور، وبتكاليف اقتصادية كبيرة أي قرار سياسي جديد.
وحقيقة الأمر، أن الحوار الوطني لم ينجح إلا في توريط المعارضة المصرية سياسيا، ربما تمهيدا لعملية هندسة الانتخابات، بينما كانت المعارضة تأمل، أن يساهم الحوارالوطني في تحسين البيئة السياسية المصرية، والقدرة على امتلاك مساحة في المعادلة السياسية، تسمح بوزن لها في صناعة القرارات السياسية والاجتماعية، ولو على مدى زمني متوسط، ويسمح للمصريين بمساحات للتفاعل السياسي والاجتماعي الآمن، دون أن يكون ثمنه المباشر سجنا واعتقالا، وكلها أهداف مشروعة ومقدرة بطبيعة الحال.
لكن المشكل الرئيس حاليا هو أنه عطفا على عدم وجود مخرجات ذات قيمة سياسية للحوار الوطني، فإن تورط المعارضة في مشهد انتخابي لايملك أية مصداقية، لن يكون في صالح أحد لا النظام السياسي ولا المعارضة ذاتها، لأنه في غالب الظن لن يساهم في بناء نسيج وطني قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية في لحظة فارقة من تفاعلات النظام الدولي، كما أنه في أغلب الظن، أن عملية الاستقرار السياسي الداخلي في ضوء استمرار السياسيات التي أسفرت عن المأزق الاقتصادي، سوف تكون محل شك كبير.
من هنا، وفي ضوء الوعي التاريخي، والموروث لمؤسسة القوات المسلحة المصرية، وقدراتها الاستراتيجية في التعامل مع المهددات الداخلية والخارجية، أجد لزاما عليها، أن تضطلع بدور يتطلع اليه المصريون في هذه المرحلة مماثلا لذلك الدور الذي لعبته في ثورتي يناير ويونيو، وهو أن تدرس مدى قدرة سيناريو هندسة الانتخابات الراهن بوجود معارضة مصنوعة، وديكورية، على صناعة حالة استقرار سياسي ممتد لست سنوات في مصر، وماهي مخاطر عدم نجاح هذا السيناريو على مستقبلنا جميعا، ولعلي أسوق هنا بعض المعطيات الجديرة بالنظر والتأمل من جانب مؤسسة القوات المسلحة المصرية، وهي كالتالي:
أولا: أن التكاليف السياسية للصيغ التقليدية والتاريخية في مصر (دولة يوليو)، باتت باهظة الأثمان في ضوء، أن غالبية السكان هم من الشباب المتواصلين مع مفردات العالم الحديث المؤسسة على الحريات العامة، خصوصا حرية الصحافة والإعلام، ووجود وزن ودور حقيقي للمعارضة السياسية.
ثانيا: أنه على الرغم من أن المجمعات الصناعية والعسكرية حول العالم لها دور قائد في صناعة القرار السياسي، حتى في الدول الكبرى والديمقراطية، ولكنها ليست في الواجهة، ولاتسيطر على غالبية المقدرات الاقتصادية والإعلامية، نظرا للتكاليف السلبية لهذه لأوضاع على حالة الاستقرار السياسي الممتد للدول.
ثالثا: أنه على الرغم من أن العواصم العالمية تمارس توظيفا للديمقراطية؛ لتحقيق مصالحها أكثر منه الانحياز لمفاهيم مبدئية، كما نرى حاليا في إقليم غرب إفريقيا، ولكن يبقى أن الديمقراطية هي الوسيلة التي تضمن حكما رشيدا، يحوز على الرضى العام من جانب الشعوب، ويضمن الاستقرار السياسي للدول كل حسب ظروفه ومتطلباته.
رابعا: أن الرضا العام عن السياسيات الحالية هو في درجة متدنية طبقا لمؤشرات علمية، أعرف أنكم تملكونها، وهذا الرضا، بات ضروريا؛ لضمان سلامة الوطن والناس، خصوصا وأن صناعة الفزع والتخويف والإضرار بالمصالح، قد يعمل لبعض الوقت، ولكنه لا يؤثر طول الوقت.
خامسا: أن تطوير دولة يوليو أصبح مطلوبا، وبإلحاح؛ لتعيش مفردات العالم الحديث، ولا تتجمد في صيغ قديمة، تضمن عدم الاستقرار أكثر ما تضمن الاستمرار والازدهار.