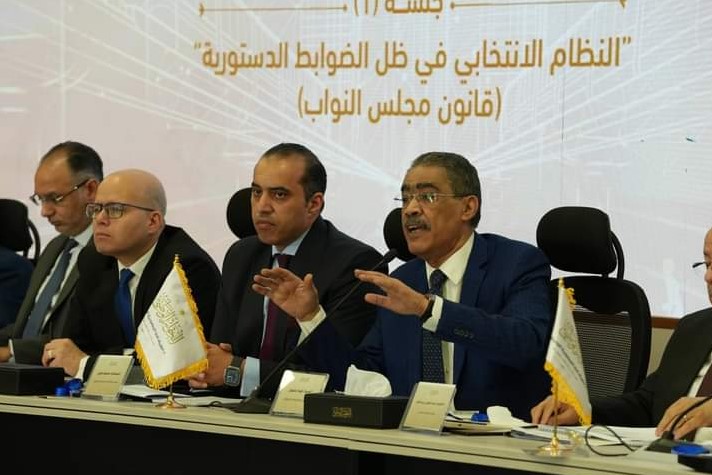سؤال الإصلاح السياسي ليس مجرد شعارات، وأمنيات طيبة ولا كلام كبير عن الدولة المدنية الديمقراطية، ولا عن انتخابات شكلها تعددي وجوهرها محسوم نتيجته سلفا، إنما اتخاذ خطوات أولى نحو الإصلاح في ملفات، تحمل قدرا كبيرا من التوافق المجتمعي، ولا تعتبرها الدولة تهديدا لها، حتى لو تحفظ عليها البعض، ورفضها البعض الآخر، وقبلها البعض الثالث؛ فالمهم التوافق على الجوهر والتقدم خطوة نحو عملية إصلاحية تدريجية وحقيقية.
ورغم أن الحوار الوطني فتح الباب أمام آراء متعددة؛ لتعبر عن نفسها بشكل علني، وطرحت أفكار كثيرة تتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وتعديل بعض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية والسياسية، إلا إن كل هذه الأفكار لم تترجم في حيز الواقع، ولم تنفذ حتى الآن، وخاصة ما يتعلق بتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وقانون الانتخابات البرلمانية والمحليات وغيرها.
وقد بات مطلوبا، أن يقف الحكم وقفه حقيقية مع توجهاته الاقتصادية والسياسية، وأن يعترف، ولو ضمنا أن السياسات التي اتبعت في السنوات الماضية جوهرها في حاجة إلى مراجعة، وأن استمرار رفع شعارات لا تطابق الواقع، لم يعد مجديا ولا مفيدا.
لقد عرفت مصر طوال تاريخها المعاصر خطابا معلنا لمختلف نظمها السياسية متسق مع جوهر توجهات هذه النظم، فالنظام الملكي، كان يعلن كل يوم، أن الذات الملكية مصانة، وأن مصر نظامها ملكي دستوري، وأن شعبها بمختلف فئاته وأحزابه السياسية يناضل من أجل التحرر والاستقلال، وكان ما يجري في الواقع، ليس بعيدا، عما يعلن، وجاءت ثورة يوليو، وحكم عبد الناصر، وأعلن بشكل واضح، أن نظام الحكم قائم على الحزب الواحد، ووصف خصومة بالقوى الرجعية، وأعداء الثورة، وطبق الاشتراكية في الواقع، وروج لها في خطابه المعلن، وجاء السادات وفعل العكس؛ فتحول للنظام الرأسمالي، وأعلن رفضه للاشتراكية والاشتراكيين، وطبق ذلك قولا وعملا، أما في العهد الحالي، فلا زال الخطاب الرسمي المعلن، يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والدولة المدنية الحديثة، في حين أن الواقع ليس له علاقة بهذه المبادئ؛ فالحكم الحالي لم يقل، كما قال عبد الناصر، إنه مع نظام الحزب الواحد، وأن من يرغب في عمل سياسي شرعي ينضم لهذا التنظيم، إنما قال، إنه مع التعددية السياسية التي غابت في الواقع، بل أنه لا يوجد حزب حاكم، مثلما جرى في العهود السابقة، إنما هناك أحزاب موالاة تؤيد الرئيس وتبايعه، وتندهش كيف يبح قادتها أصواتهم في دعم الرئيس، دون أن يقابلوه أو يتواصلوا معه، أو يكونوا جزءا، ولو محدودا من صناعة القرار السياسي في البلاد، (كما جرى مع أحزاب الحكم السابقة) وحتى لو شكلوا غالبية داخل البرلمان.
أحد أزمات الوضع الحالي، أن الخطاب المعلن ليس له علاقة بالواقع المعاش، وأن هناك انفصالا بينهما، وأن المطلوب الاعتراف، بأن مصر لم تبن دولة قانون، ولم تؤسس لعملية انتقال ديمقراطي، وإنها لم تختر بدلا من ذلك، أن تكون دولة اشتراكية، بل إنها ظلت دولة اعتدال، ومع ذلك لم تستفد من هذا الاعتدال في جذب الاستثمار، وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي ولا أن تكون قوة صناعية واقتصادية، وهي لم تصبح دولة ممانعة، رغم أنها تركت كثيرا من إعلامها، يصل بسقف هجومه على أمريكا والغرب؛ ليكون أعلى من طهران، أي إنه لم يستفد من قوته الكامنة كدولة اعتدال، ولم يتحول إلي دولة مقاومة، وبقي يردد شعارات بعيده عن الفعل والتأثير.
مطلوب تغيير المسطرة التي حكمت حركة البلاد عقب التهديدات الوجودية التي تعرض لها الشعب المصري في ٢٠١٣، ودفعت الكثيرين إلى تبرير إغلاق المجال العام، والمساحات الآمنة للتعبير عن الرأي، فغابت المحليات، وغيبت المشاركة الشعبية في أي خطة؛ لتطوير الأحياء، وحوصرت الأحزاب في مقراتها، واكتفت بإصدار بعض البيانات، كما غاب أي دور يذكر للنقابات المهنية، أو العمالية، وبما أن الظروف قد تغيرت، والبلاد استقرت أمنيا، فإن المطلوب وضع قواعد جديدة، وتدريجية تحكم عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي.
فيجب أولا، رفع شعار استعادة دولة القانون والمؤسسات، والعمل على تنفيذ هذا الشعار في الواقع العملي وبشكل تدريجي، كما يجب البدء في إعطاء مساحات حقيقية، وليست سابقة التجهيز لظهور أكثر من وسيط سياسي بين الدولة والشعب.
إن تاريخ استقرار النظم السياسية، منذ منتصف القرن الماضي، وحتى الآن كان متوقفا على المساحات الآمنة التي تعطيها للناس، فلم يحدث أن غاب الوسيط السياسي أيا كان شكله، أو الوسيط الأهلي من نقابات وروابط شعبية ومجتمع مدني، وفي حال إضعاف هذه الوسائط، يصبح هناك خطر كبير، أن تقفز في وجوه الجميع نتائج “تفاعلات غير مرئية”، تجري في بطن المجتمع، وقد تأخذ شكل احتجاجات اجتماعية، أو سياسية خارج كل التوقعات والحسابات.
المساحات الآمنة في العمل السياسي، تخرج “غير المرئي” إلى “المرئي”، وتصبح همسات البعض أو غضب البعض الآخر له مسار علني، وآمن للتعبير عنه.
والحقيقة أن جانبا من أزمة مصر الحالية، هي، أنها اعتبرت معظم القضايا أمن قومي، ولم تميز بين السرية المطلوبة مثلا للعمليات العسكرية؛ لمحاربة الإرهاب في سيناء وغيرها، وبين اعتبار المشاريع القومية من الأسرار؛ خوفا من “أهل الشر” أو اعتبار نقد إنشاء محاور (بعضها ليس أولوية)، ومبان ضخمة غير منتجة، ومونوريل وقطار كهربائي خيانة للمصالح الوطنية، واعتبار العلم ودراسات الجدوى إهدار للوقت وللإنجاز.
إن تجارب الشعوب تقول إن إلغاء السياسة وغياب كل الوسائط “الآمنة” من أحزاب ونقابات ومجتمع أهلي يهدد الاستقرار ويجعل كثير من التفاعلات الكامنة في قلب المجتمع مرشحه أن تقفز فجأة في وجوهنا من حيث لا ندري، عندها لن تفيد “اشتغالات” الرأي العام في إبعاد الناس عن قضاياهم ومشاكلهم الحقيقية في التعليم والصحة والتصنيع وتطوير الزراعة والعدالة الاجتماعية وأولويات التنمية وخطط تطوير الأحياء وغيرها.
لسنا في دولة مدنية ديمقراطية، والمطلوب أن نعلنها هدفا، وأن نمتلك أدوات للوصول إليها، وهدف بناء دولة مدنية ديمقراطية، يتطلب في خطوته الأولى دولة قانون، تضع قواعد، يحترمها الجميع وأولهم من وضعوها أي أهل الحكم، والثانية هي هامش حقيقي غير مصطنع، يعطي لمختلف القوى السياسية المدنية الحق في التحرك وفق قواعد الدستور والقانون، ويقوم أولا على نظام التعددية المقيدة الذي سينضج مع الوقت، حتى نصل للتعددية الكاملة.