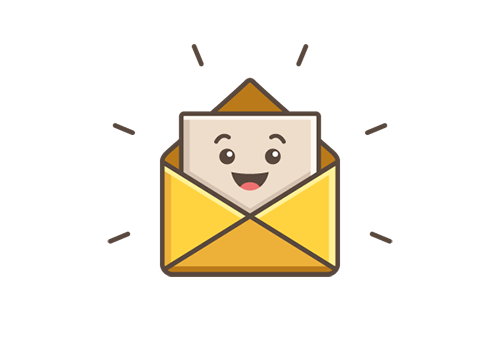إذا كانت السياسة غير الرشيدة تدخل بالشعوب في أنفاق مظلمة، فإن وظيفة الفكر أن ينقب عن المخرج وعن الضوء، وإذا لم يوجد مخرج ولا ضوء، فإن وظيفة الفكر هي ابتكارهما، ولو من العدم، وهذه هي ألف باء وظائف العقل المفكر في دفع حركة التاريخ. عندما تنسد الطرق، وتجد الشعوب نفسها أمام حوائط مسدودة، تحول بينها وبين المستقبل، يكون الناس واحداً من اثنين:
1- ناس يغضبون غضب القادرين الذين يملكون روح المبادرة، والمغامرة والتجريب وإعادة المحاولة- دون كلل ولا ملل- بحثاً عن مخرج.
2 – أو ناس يغضبون غضب العاجزين، فيقودهم خليط الغضب مع العجز إلى حالة من شلل القدرة، ثم فقدان روح المبادرة، ثم الاستسلام لليأس والقنوط، ثم انتظار قارعة من السماء أو انفجار من الأرض.
والأخطر، هو أن تقع القوى العاقلة المفكرة المتعلمة في صفوف النوع الثاني، حيث الغضب المقرون بالعجز، وحيث العجز المؤدي إلى أوسع دروب اليأس، وحيث اليأس الذي يرهن الشعوب للانتظار العدمي القاتل.
عندما صدرت الطبعة الأولى من كتاب “شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان”، أول مرة، قبيل هزيمة العرب الكبرى 1967م، في كتيب صغير في حجم كف اليد، من ثلاثمائة صفحة، كان ضوءاً في نهاية النفق، وكان مخرجاً رحباً، كانت فكرته الأساسية هي إعلاء إمكانات مصر- عبر اقتصاد حديث وتصنيع وتكنولوجيا- حتى تتأهل لقيادة العرب، وحتى تحرر فلسطين، وتسترد كامل ترابها من جديد للعالم العربي. كانت هذه هي الرؤية الدافعة وراء تأليف الكتاب، ورغم صغره، فقد كان علامةً فكرية بارزة في ذلك الحين. كان الدكتور حمدان- في ذلك الوقت من ستينيات القرن العشرين- يمتلك روحاً وثابةً، مع عقله الحاد، مع تكوينه الأكاديمي الثقيل، مع شعلة دافقة من الروح الوطنية والقومية، مع إيمان عميق بالقيادة الناصرية، فذهب يفكر في مصر ذات الاقتصاد الصناعي الحديث، مصر قائدة العرب، مصر المحاربة- للعالم الغربي كله- حتى تتحرر فلسطين من قبضة الصهيونية.
لكن بعد عشرين عاماً من ذلك التاريخ ، وفي منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، حيث انتهى من تحويل الكتيب الصغير ذي الثلاثمائة صفحة، إلى أربعة مجلدات ضخمة من خمسة آلاف صفحة، كانت مصر قد تغيرت، وكان العرب قد تغيروا، تغير كل شيء من النقيض إلى النقيض، فتغير هو كذلك، غضب غضباَ شديداَ، غضباً من العنف والعمق والعصف بذاته وفكره وروحه، وضميره بحيث احتاج إلى خمسة آلاف صفحة، حتى يفرغ شحنة الغضب الجبار بين سطورها ومتونها وهوامشها، تحول الكتيب الصغير المحكم الرشيق الأنيق في مضمونه وفكرته ولغته وحبكته، تحول إلى بيداء واسعة، من ورائها بيداء أوسع، دروب بعيدة تُفضي إلى دروب أبعد، رحلة شاقة مرهقة منهكة، أنهكت الكاتب والقارئ، وتاه فيها القارئ وراء الكاتب، ثم انتهت إلى حالة من الإعياء الشديد، بحيث امتنع دكتور حمدان امتناعاً مطلقاً، عن أن يمد بصره للمستقبل، توقف عن تقديم رؤية لكيف الخروج من النفق، أو لكيف استطلاع الضوء في نهاية الظلام، بل اكتفى بأن صب جام غضبه على مصر، ثم صب جام غضبه على العرب، مصر السادات- مبارك، عرب النفط.
ورغم أن الهدف من الخمسة آلاف صفحة هو الوصول في نهايتها إلى رؤية مستقبلية جديدة، تبرر ما بذله فيها من جهد، وما تكلفه من عناء ومشقة، إلا أنه آثر أن يختم المجلدات الأربعة، بخاتمة الكتيب الصغير التي كانت تحمل الدعوة الثلاثية: تصنيع مصر، قيادة مصر للعرب، تحرير مصر لفلسطين. فلم يناقش استحالة أي من تلك الأهداف في عالم عربي كانت ملامحه العامة كالتالي: مصر مديونة تفاوض دائنيها في نادي باريس، العراق ومن خلفه دول الخليج في حرب مع إيران، الطفرة النفطية تعطي الثقل الأكبر لدول الخليج، لبنان في حرب أهلية، المغرب العربي يتباعد عن المشرق العربي، شعار الإسلام هو الحل يملأ الأفق، ويقطع الطريق على أفكار الوطنية والقومية والتنوير الغربي والعلمانية، تراجع أفكار التحرر الوطني والحياد الإيجابي وعدم الانحياز، تمدد النفوذ الأمريكي في مفاصل الدول العربية، ثقافة الاستهلاك والاقتناء، تغزو كل بيت عربي. باختصار شديد: في العشرين عاماً، من منتصف الستينيات حتى منتصف الثمانينيات، أي الفترة من صدور الكتيب في حجم اليد، إلى صدوره في أربع مجلدات ضخمة، كانت الدنيا كلها قد تغيرت مصر والعرب والعالم، مرحلة بدأت بانفجار الهزيمة العربية الكبرى، ثم ختمت بانفجار التفكك السوفيتي، وانهيار القوة العظمى الثانية.
باختصار شديد: الإطار الفكري الذي أبدع الكتيب الصغير، ويحتفظ له بجدارته الأكاديمية، حتى هذه اللحظة تمزق، ولم يكن يصلح أو يتحمل أو تنهض عليه المجلدات الأربعة، لهذا تتوه في المجلدات، دون دليل ودون إرشادات طريق، ولهذا انتهت الرحلة الطويلة الشاقة البعيدة إلى لا شيء، انتهت إلى حارة سد، انتهت إلى الصدام في حوائط مسدودة.
………………………………………………………….
فالباب الأخير من المجلدات الأربعة، وهو الباب الحادي عشر، وعنوانه “مصر والعرب”، يبدأ بإشارة عنوانها “توضيح لا بد منه للقارئ”، وفيه يقول دكتور حمدان: “إلى أن يزول وجه مصر القبيح نهائياً”، “وكذلك وجه العرب الكالح القميء المتنطع أيضاً، فإن من الواضح تماماً في الوقت الحالي الرديء الساقط استحالة كتابة هذا الباب كما ينبغي، وكما كان في خطة هذا العمل الكبير”. ثم يقول: “وليس ذلك حرصاً على سلامتنا، أو حتى حياتنا، ولكن حرصاً على وصول هذا الكتاب إلى القارئ، وكل لبيب بالإشارة يفهم”.
هنا نتساءل كان الباب- في خطته التي انحجبت عن النشر- دعوة إلى الثورة ضد النظام المصري، أو الأنظمة العربية؟ أم كان كشفاً لوثائق خطيرة وإذاعة لأسرار أخطر؟ الغموض الذي أحاط بوفاة دكتور حمدان عن 66 عاماً، في 17 إبريل 1993م، عزز من الاحتمال الثاني، احتمال أن الرجل كانت لديه وثائق وأسرار وإدانات للحكام.
لكن هو نفسه ينفي ذلك، فالباب المحجوب أو الذي لم يكتبه، أو لم ينشره، يتحدث هو عنه، فيقول في ص 630 من المجلد الرابع: “كان التصور الأصلي عند تخطيط هذا العمل، أن يأتي هذا الباب الختامي تتويجاً وقمةً له جميعاً، يستخلص ويستقطر أعمق، وأخطر نتائجه التطبيقية والمستقبلية في مجال العلاقة العضوية التاريخية والمصيرية بين مصر والعرب، وعلى هذا الأساس، كان المفروض أن يشمل الباب ثلاثة فصول في مائتي صفحة، عنوان الفصل الأول بين الوطنية المصرية والقومية العربية، ثم عنوان الفصل الثاني مصر في عالم عربي متغير، ثم عنوان الفصل الثالث عن مستقبل مصر والعرب”.
ثم يقول: “ورغم أن المادة الأولية والأفكار الأساسية، والتخطيط العريض لهذه الفصول قد تم، منذ أمد ليس بالقصير، إلا أن المؤلف بكل الأسف والأسى يستأذن، في أن يقدم اعتذاره لقارئه، عن عدم استحالة الكتابة والنشر، في ظل الظروف الراهنة القهرية القاهرة التي يعرف، إذ لن يصل إليه حرف منها بحال لو حاول”.
ثم يشرح أنه- بديلاً عن ذلك- أنه قرر إعادة نشر الباب، كما هو في طبعة عام 1970م، دون أدنى تغيير، رغم ما وصفه بـ “التغيرات الانقلابية المحزنة، والمخزية التي طرأت؛ لتجعل كثيراً من الحقائق المادية الصلبة أخطاء علمية بحتة، وأسوأ منها، لتزلزل كثيراً من الآراء والأحكام القومية والسياسية الأساسية”.
ثم يبرر نشر الباب القديم- في سياق لم يعد يتناسب مع مضمونه أبداً- فيقول: “وإنما عذرنا، وهو أيضاً رجاؤنا، أن يكون النص بصورته الأصلية وثيقة تاريخية دامغة، مثلما هي صافعة، لكل من كان له قلب، لم يزل أو ألقى السمع وهو شهيد، وتذكرةً وعبرةً، لم يفقد بعد آخر قطرة من حسه الوطني والقومي”. انتهى الاقتباس.
الكتيب الصغير كان موحياً وملهماً ومتسقاً مع المناخ السياسي الذي صدر فيه، الكتاب ذو الخمسة آلاف صفحة، كان جراباً واسعاً لشحنات من الغضب، والسخط والاحتجاج والاستنكار، نقرأ الكتيب الصغير؛ لنتعلم، نقرأ الكتاب الكبير؛ لنفرغ ما في جوفنا من إحباط، وكلما مررت بلحظات من النكسات الوطنية عدنا إلى فصول الكتاب الكبير بالذات في الباب العاشر، وعنوانه آفاق الزمان وأبعاد المكان، وهو من ثلاثة فصول: تعدد الأبعاد، التوسط والاعتدال، الاستمرارية والانقطاع. وتعجبنا وترضينا وتمتعنا من الناحية النفسية، خاصة ما كان منها يحمل بعنف على الديكتاتوريات فنذهب معه، حيث يذهب بنا، في حين أنه يقودنا إلى عالم من الحتميات، والثوابت المتحجرة والتي يستحيل معها التفكير أو التغيير، هذه الحتميات- وليس سواها- هي التي انتهت بالكتاب الكبير إلى سراب، إلى غير رؤية، إلى ضباب، إلى غير أفق منظور.
بقدر ما كان الكتيب الصغير يحمل وعدا ووحياً وإلهاماً، بقدر ما آل الكتاب الواسع إلى أضيق طريق، بل إلى طريق مسدود.
…………………………………………
دكتور حمدان أبصر الأزمة، لكن غفل عما كان يسميه الأستاذ الإمام محمد عبده في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بـ ” القوى الحيوية الكامنة في البلاد، والتي تنتظر، من يضمها إلى بعضها، ويشق بها الطريق ” .
مصر بين عناصر الأزمة، وقواها الحيوية الكامنة، هذا هو مقال الأربعاء المقبل بمشيئة الله تعالى.