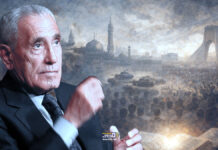وافق مجلس النواب المصري، منذ ما يقارب الأسبوعين على نص المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضمن ما تم عرضه، وتمت الموافقة عليه من نصوص مواد، وقد سبق أن تحدثنا عما جاء بهذا المشروع من نصوص، تقيد الحق في الدفاع، وغير ذلك من أصول ومبادئ تتعلق بالمحاكمات العادلة، وكذلك سبق وأن أبدى المجتمع المصري اعتراضات شديدة على العديد من نصوص هذا المشروع.
ولكن بخصوص هذا النص تحديداً وعلاقته بالتصرف في الأموال، وما ثار من أوجه اعتراضات مجتمعية كثيرة، فلا بد وأن نعرض لذلك النص، كما تمت الموافقة عليه، وحسب ما تناولته المواقع الإخبارية، حيث يجري النص، على أنه: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه، من أن يتصرف في أمواله أو يديرها، أو أن يرفع أية دعوى قضائية باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه، يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها؛ بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
وكانت غالبية الردود التي قيلت للرد أو للدفاع عن هذه المادة متلخصة في كونها في الأساس موجودة بالفعل في قانون الإجراءات الجنائية القديم تحت نص المادة ( 390 )، كذلك أنها لا تتعارض مع نصوص الدستور المصري في حمايته للملكية الخاصة، وبحسب ما تم نشره عبر موقع جريدة اليوم السابع من حديث منشور إلى وزير العدل، جاء فيه دفاعاً عن ذلك النص، بأنه يتماشى مع نص المادة 25 من قانون العقوبات الحالي، والتي تؤكد على أن كل محكوم عليه في جناية محروم من إدارة أمواله وأشغاله الخاصة بأمواله، كما أورد ذات الحديث، من أن الهدف من ذلك النص هو دفع المتهم المحكوم عليه لاتخاذ إجراءات قضائية بشأن الحكم الغيابي الصادر ضده، وهو ما يسقط الحكم الصادر غيابياً بكل تبعياته.
ولكن لا بد وأن نؤكد، بأن هاك أوجه اختلاف ما بين النص القديم والنص المستحدث، وذلك في كون النص القديم لم يتضمن عبارة، (أو أن يرفع دعوى قضائية باسمه)، وهذا فارق شديد الأهمية والخطورة، ما بين النصين القديم والمستحدث، ولست أدري إلى أي مدى يتم تطبيق هذا الحظر في اللجوء إلى التقاضي، بوصفه أحد أهم الحقوق الشخصية والعامة في ذات الوقت، والمرتبطة بقدرة الأشخاص على اللجوء إلى التقاضي والتمكين من ذلك سواء للدفاع عن حق أو دفع ضرر، وحيث أن جلسات مجلس النواب لم تزل محجوبة عن العامة، فلم يتبين لنا إلى أي مدى دار النقاش حول هذه النقطة المفصلية والمرتبطة بحقوق المواطنين، كما وأن الجريدة الرسمية لم تعد تنشر الأعمال التحضيرية أو المناقشات التي تعد بمثابة المرجع في حالة وجود جدل فقهي حول تفسير نص من النصوص، فإن المجتمع سيظل في حيلة حيرة شديدة حيال هذا المنع المطلق من اللجوء إلى التقاضي، بحسب ما تم نشره، ومن جهة ثانية، فقد يكون ذلك الحظر ذا دلالة أو حيثية، لو أنه كان مرتبطا بإدارة الأموال، إنما أن يأتي في صياغة عامة غير محددة، فهو ما يسلب الشخص المحكوم عليه غيابياً معظم محددات شخصيته القانونية، وربما يكون ذلك أوقع، لو كان الأمر مرتبط بصدور عقوبة بحكم نهائي في مادة جنايات.
أما إذ عدنا إلى صلب المادة والمتعلق بعدم القدرة على إدارة الأموال أو التصرف فيها، وبحسب ما نٌسب إلى السيد/ وزير العدل من استناده إلى نص المادة 25 من قانون العقوبات، فلا أرى لذلك مكانا سوى في حالات صدور حكم نهائي بالعقوبة. وبخصوص المنع من التصرف والذي يمثل سلب سلطة أو قدرة صاحب الأموال “المحكوم عليه غيابياً” من القدرة على إبرام أي تصرف في أمواله، ومن ثم فهو يعد بمثابة تدبير تحفظي أو وقائي، يتم فرضه لصالح المجتمع، وقد أوردت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعريفاً لمنع التصرف في الأموال، على أنه: فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة. كما أنه من ناحية مقارنة فإن أغلب التشريعات الإجرائية تنص على ذلك الحظر، ولكن بحدود اشتراطات ظرفية محددة أو بحسب جرائم بعينها. ومن زاوية قضائية، فإن أفضل ما قيل في هذا الأمر، هو ما أوردته المحكمة الدستورية العليا في الحكم رقم 26 لسنة 12 قضائية، وهو الحكم الذي انتهت فيه إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، وسقوط فقرتيها الثانية والثالثة، وكذلك المادة 208 مكرر “ب” من ذات القانون، وذلك بحسب نص لحكم من قوله، إنه: وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان أصل البراءة يتصل بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، ولا شأن له بطبيعة أو خطورة الجريمة موضوعها، ولا بنوع أو قدر عقوبتها ؛ وكان هذا الأصل كامناً في كل فرد، كافلاً حمايته سواء في المراحل المؤثرة السابقة على محاكمته جنائياً، أو أثناءها، وعلى امتداد حلقاتها؛ وكان النص المطعون فيه قد أجاز فرض قيود على أموال الأشخاص- الذين توافرت من خلال التحقيق معهم دلائل كافية على تورطهم في إحدى الجرائم التي عينها- تحول دون إدارتهم لها أو تصرفهم فيها- وهى قيود لا سند لها من النصوص الدستورية ذاتها- ممايزاً بذلك بين هؤلاء وغيرهم من المواطنين، بل بينهم وبين غيرهم من المتهمين المدعى ارتكابهم جرائم أخرى غير التي حددها هذا النص؛ وكان هؤلاء وهؤلاء يضمهم جميعاً مركزا قانونيا واحدا، هو افتراض كونهم أسوياء، لا ينقض الاتهام- عند وجوده، ولا مجرد التحقيق من باب أولى- أصل براءتهم، ولا يفرق بينهم في الحقوق التي يتمتعون بها. ذلك أن صور التمييز التي تخل بمساواتهم أمام القانون- وإن تعذر حصرها- إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد أو تفضيل، يجاوز الحدود المنطقية لتنظيم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، سواء بإنكار أصل وجودها أو من خلال تقييد آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.
فهل سيراعي انتباه السادة القائمين على تمرير قانون الإجراءات الجنائية، مثل هذا الحكم الهام، أو أن يحاولوا السماع إلى أوجه النقد الشديدة التي توجه سهامها إلى نصوص ذلك القانون، أم أن أمرا قد قضي وأبرم، فلله الأمر.