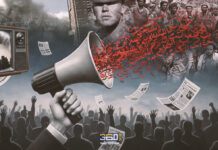بدا السياق الدولي والإقليمي الذي صاحب نجاح الثورة الإيرانية في عام ١٩٧٩، مختلفا جذريا عن السياق الذي صاحب نجاح الثورة السورية في ديسمبر من العام الماضي، وبات خطاب قادة البلدين تقريبا عكس بعضهما، ليس فقط أو أساسا لأسباب مذهبية، إنما أيضا لأسباب تتعلق بالتحولات التي شهدتها المنطقة، وجعلت الطبعة السورية من حكم التيار الإسلامي في دمشق، تختلف في خطابها وتوجهاتها عن خطاب وتوجهات تيارات الإسلام السياسي من إيران إلى أفغانستان، وانتهاء بتجارب باقي التنظيمات الإسلامية في الحكم والمعارضة.
والسؤال المطروح، كيف نفسر هذا التحول الكبير في خطاب هيئة تحرير الشام، فيما يتعلق بعدد من القضايا وعلى رأسها الموقف من إسرائيل الذي ظلت التيارات الإسلامية على مدار عقود من الزمن، تعتبر أن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر هو هدفها والجهاد في سبيل ذلك “أسمي أمانينا”.
وقد مثل خطاب الثورة الإيرانية حجر الزاوية في تبني خطاب الممانعة والمقاومة المسلحة، ومواجهة سياسات أمريكا (الشيطان الأكبر كما وصفها الخميني) وإدانة مشاريع التسوية السلمية من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مرورا باتفاقات وادي عربة بين الأردن وإسرائيل وحتى الاتفاقات الإبراهيمية، كما تبنت كل فصائل تيارات “الإسلام السياسي” موقفا ثابتا في رفض الاعتراف بإسرائيل، ورفع شعار تحرير القدس ومزايدة على كل من فعل العكس، وذهب نحو أي تسوية سلمية.
وبعيدا عن القراءة المذهبية للثورة الإيرانية التي لا تكشف في الحقيقة أغلب أبعادها، فإن توقيتها في عام ١٩٧٩ كان السائد فيه عربيا رفض أي علاقة مع إسرائيل، وكانت خطوة الرئيس السادات في التوقيع على اتفاق سلام منفرد مع إسرائيل استثناء في هذا الإطار، لأن البيئة الشرق أوسطية ظلت تحمل ” قدر من الممانعة”، وكثير من الآمال في تحقيق حلم تحرير فلسطين، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فقط “عبر فوهة بندقية”.
إن وعود الثورة الإيرانية طوال العقود الماضية كانت كبيرة، فقد وعدت بتحرير القدس وبدعم المستضعفين، وكانت أيضا تيارات الإسلام السياسي في صعود، قبل أن تُختبر في الحكم والإدارة، ويتراجع دعم كثير من الناس لمشروعها.
ورغم أن هناك أحداث هزت القناعة التي راجت عقب نجاح الثورة الإيرانية التي تقول، إن الحرب الوحيدة التي يجب أن يخوضها العرب والمسلمون هي ضد إسرائيل، فكانت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لسنوات، وسقط فيها مئات الآلاف من القتلى، ثم جاء غزو صدام حسين للكويت بكل التداعيات التي خلقها في الواقع العربي، بصورة جعلت كثيرا من الخبراء، يعتبرونه بمثابة نهاية “النظام الإقليمي العربي”. صحيح، أن القضية الفلسطينية ظلت حاضرة، ولكنها تراجعت إلى خلفية الأحداث، خاصة بعد فشل مسار أوسلو (١٩٩٣)، وبعد أن أُجهضت انتفاضة ٢٠٠٠، وتدهور أداء منظمة التحرير الفلسطينية، وضعف وترهل السلطة الفلسطينية، كما ترسخ الانقسام الفلسطيني وفشل حماس كبديل سياسي للإدارة والحكم قبل ٧ أكتوبر وبعدها، كل ذلك عمق من قناعة الكثيرين، بأن السبب الرئيسي وراء الانكسارات العربية يرجع لسوء الأداء الداخلي، وليس مؤامرات الخارج.
صحيح، أن قطاعا واسعا من الجماهير العربية ظل مؤمنا وداعما للقضية الفلسطينية على أرضية مدنية أو دينية أو حقوقية، واتضح أثناء حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على غزة حضور هذا الدعم، إلا أنه ظل في الشارع، ولم يترجم في معادلات حكم جديدة في الشرق أو الغرب على السواء.
لقد مثل حال المنطقة والسياق الإقليمي والدولي عاملا رئيسيا في تحديد خيارات الثورة السورية، وفي مراجعة فصائلها الإسلامية المتشددة لخطابها السياسي ومشروعها الفكري والعقائدي، فيما يتعلق بإسرائيل وبدت المفارقة، أنها لم تقم بنفس المراجعة، فيما يخص موقفها من باقي مكونات الشعب السوري، وكانت الانتهاكات المخزية التي ارتكبت في الساحل (ذو الأغلبية العلوية)، وتكررت في السويداء (ذو الأغلبية الدرزية) مؤشر على عدم قيام فصائل الحكم الجديد بالمراجعة المطلوبة، فيما يتعلق قضايا المواطنة والعدالة بين جميع المكونات.
لقد وصل تنظيم هيئة تحرير الشام الإسلامي إلى السلطة بعد إسقاط نظام “آل الأسد” الذي تاجر بالمقاومة ورفع شعارات النضال ضد إسرائيل كمبرر لقتل السوريين، كما أن الدول العربية حسمت أمرها في إعطاء الأولوية لمشاريعها ومصالحها الوطنية، ولم يدخل أحد في مواجهة عسكرية واحدة من أجل دعم القضية الفلسطينية.
لقد اكتشف أحمد الشرع بعد وصوله إلى السلطة، أن ما كان يقوله حين كان في جبهة النصرة، أو يقود هيئة تحرير الشام، ويسيطر على إدلب، عن أن تحرير الشام هو خطوة على طريق تحرير القدس، ليس له علاقة بالواقع الجديد عربيا وإقليميا ودوليا، وأن الحسابات الوطنية لكل دولة ترسخت، وأن لا أحد يحارب إلا من أجل تحرير أرضه.
لقد بهت الواقع المعاش على مشروع الحكم الجديد في سوريا، وغيب ما كان يبدو من بديهيات “مشاريع الإسلام السياسي”، فيما يتعلق بمواجهة إسرائيل وتحرير القدس، وقبلت الحكومة السورية الجديدة بوجود إسرائيل، وفتحت معها قنوات اتصال، حتى لو كانت لا زالت ترفض التطبيع.
إن برجماتية القادة الجدد في سوريا وحسابات المصالح وتثبيت أركان الحكم الجديد باتت تحكم توجهاتهم وعلاقاتهم بالقوى الكبرى وإسرائيل، ورغم أن إيران رفعت شعارات عكسية وتبنت خطاب المقاومة، بل ودخلت في مواجهة مسلحة مع إسرائيل، صمدت فيها، ولكنها حاربت ليس أساسا من أجل دعم فلسطين، إنما دفاع عن مشروعها الوطني والنووي.
إن قراءة اللحظة التاريخية شرط نجاح أي مشروع سياسي، دون أن يتنازل عن الثوابت الوطنية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، وهو أمر لا زال محل اختبار في سوريا رغم البرجماتية والتحول الكبير الذي حدث في خطاب “الحكم الإسلامي” الجديد.