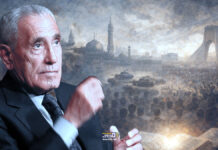في البدء لا بد، وأن نقرر، أنه في حالات التشريعات الاجتماعية، والمرتبطة بشكل أكثر جرأة بمشكلات وقضايا مجتمعية، فلا بد وأن تكون هناك دراسات سابقة على وضع القانون، ولا بد وأن يكون هناك مزيد من المشاورات والنقاشات المجتمعية، التي تسترعي النتائج المترتبة على وضع التشريع، وكيفية الموازنة بين المصالح المتشابكة والمرتبطة بتطبيقه، كما لا بد من إيجاد حلول، لما يترتب على وضع القانون الجديد.
وإذ أن القانون لا يعني سوى تلك القواعد القانونية الناتجة عن عملية التشريع أو المسطرة التشريعية المحددة في الدستور التي تحتكم لها جماعة معينة، فمنذ وجود الإنسان، وجدت معه قواعد قام بإبداعها من أجل التحكم في سلوكياته. أما المجتمع بكل بساطة، هو مجموعة من الأفراد، يتفاعلون فيما بينهم، وتربطهم علاقات سواء على المستوى الواقعي أو الافتراضي؛ بغية إنتاج ثقافة معينة. لكن السؤال المطروح هو، ما هي العلاقة التي تربط بين القانون والمجتمع؟ وهل هناك حاجة للإنسان في علاقاته الاجتماعية للقانون؟
إن إعادة طرح هذا السؤال، ليس إلا من أجل التأكيد على أهميته ومشروعيته في هذا الطرح، حتى يتسنى لنا القول، بإن القانون ليس إلا منظومة من المنظومات المكونة للمجتمع، وهذا ما يعني أن القانون حقل من الحقول السوسيولوجية، أو أن القانون ظاهرة اجتماعية موجود بيننا بشكل دائم، فرضته علينا حاجة تنظيم علاقاتنا الاجتماعية، وهذا ما عبر عنه الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي المعاصر إيدجار موران، بقوله إن المجتمع أنتج القانون الذي أنتجه، بمعنى أن هناك نوعا من العلاقة الوجودية بين القانون والمجتمع، فالمجتمع ينتج القانون، وهذا الأخير هو بدوره ينتج المجتمع من خلال تلك القواعد التي يسطرها، وكذا الكوابح التي ينهجها.
فهل انتبهت السلطة إلى أهمية تلك القواعد حال ضخها لقانون الإيجارات الجديد، أم أن هناك أهدافا من وراء الإصدار، تخفى عن الأعين، تبتعد بهذا القانون بعيدا عما هو مرأي للناس، وهو الأمر الذي أنتج به العديد من المشكلات، سواء كانت من ناحية الصناعة التشريعية، أم من حيث الإمكانية الحقيقية للتطبيق، دونما عوائق قانونية، قد تدفع بالقانون إلى منطقة المنازعات القانونية أمام المحاكم.
الأمر لا يبدو سهلاً، ولا يمكن اعتباره يسيراً، فأمر قانون الإيجارات، والمرتبط بحالات اجتماعية ذات حاجة للحق في السكن، بحسب كونه الملاذ الأخير للمواطنين، كان من الأولى أن تتم مناقشته بشكل أكثر عمقاً وتريثاً، قبل أن يتم الزج به إلى مجلس النواب، الذي لم نعهد معه سوى الموافقة على كل ما تتقدم به الحكومة من قوانين، حتى على الرغم من الأصوات المعارضة التي بدت أثناء مناقشة ذلك القانون تحت قبة البرلمان، إلا أنها لم تكن بالقدر الكافي، أو القادر على رد هذا القانون أو تأجيل مناقشته أو إصداره، وهو ما أنتج القانون على ما به من مشكلات تشريعية وقانونية.
أما إذا وضعنا أمام القارئ أهم مشكلات تطبيق ذلك القانون، فإنه من المفيد أن نضع نص المادة الأولى، والتي تنص على أن: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ولكن لم يوضح هذا القانون الوضعية القانونية للعلاقة الإيجارية في الفترة السابقة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، فهل نسي المشرع، أن هناك تشريعات أسبق، كانت تنظم العلاقة الإيجارية، والتي أهمها القانون رقم 121 لسنة 1947، والقانون رقم 52 لسنة 1969. أم هناك خلل في دراسة القانون قبل طرحه على الهيئة البرلمانية، أنتجته بهذا الشكل، وهو الأمر الذي يؤدي إلى خلل تشريعي في تطبيقه، خصوصا أن معظم هذه التشريعات لم يتم إلغاؤها أو وقف العمل بها في التشريعات اللاحقة عليها.
ذلك بخلاف أن نصوص القانون الجديد تؤكد على عدم تطبيقه على العقود المحررة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1996، وهو من الأمور التي تؤكد على أن ذلك القانون المستحدث لم يسترعِ انتباه واضعيه كيفية معالجة الأوجه التشريعية الكاملة والمنظمة للعلاقة ما بين المالك والمستأجر في التشريعات المختلفة، وذلك ما سوف يتم استخدامه من قبل المستأجرين المستفيدين من وجود تلك النصوص سارية حتى تاريخ العمل بذلك القانون، وأنا لا أدعو بذلك إلى المزيد من النزاعات القانونية، والتي ترهق بشكل أساسي طرفي النزاع مالياً، خصوصاً بعد غلو الرسوم القضائية والخدمات القضائية بشكل غير مبرر، كما أنه يرهق مرفق القضاء ذاته، ويجعله مزدحماً أكثر مما يجب أن يكون عليه، ولكني بشكل أكثر دقة أوجه اللوم إلى واضعي هذا التشريع، والذين لم يعهدوا به إلى المتخصصين لمراجعته بشكل أكثر دقة، حتى لا نجد ازدواجا تشريعياً، يجعلنا في حالة من التخبط القانوني.
كما وأن ما جاء النص عليه في المادة السابعة/ الفقرة الثانية، من هذا القانون من أنه: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
والخلل التشريعي الوارد في هذه المادة يبدو واضحاً في قول النص، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية، أو غير سكنية، إذ كيف نساوي ما بين الوحدات السكنية وغيرها، والتي لا تكون أساساً لها علاقة بما هو معد للسكن، أو نافعاً له. كما وأن فتح الباب لقاض الأمور الوقتية، وهو مخصص لأمور مؤقتة بحسب طبيعتها، مما يجعله يصدراً أمراً نافذاً، ربما يلغيه القضاء الموضوعي، حال عرضه عليه، الأمر الذي سيحدث جدلاً تطبيقياً واسع المدى، كما أن وضع قاضي الأمور الوقتية في محك علاقة ذات بعد اجتماعي يؤثر بشكل كلي على مأوى أسر كاملة، لا يبدو فيه شيء من تحقيق العدالة التي هي الهدف الرئيسي من اللجوء إلى القضاء، بخلاف أن ذلك التشريع ذات بعد اجتماعي أساسي، لا يجب أن يكون محل لافتراضات عابرة، أو لإجراءات متسرعة تؤثر بشكل يقيني على الحقوق محل النزاع.
وأنا في مقالي هذا لا أدافع عن فئة المستأجرين بشكل رئيسي، أو أجهض حقوق فئة الملاك بشكل كامل، ولكنني أدعو أن تكون الهيئة التشريعية على دراية كاملة بمجريات القوانين وبأثرها ومدى نفعها وكيفية تطبيقها، ومدى مساسها بالحقوق محل التطبيق بشكل أكثر حرصاً.