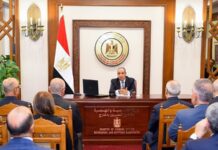في 17 أغسطس 2025، توقفت إسرائيل عن الحركة، أغلقت الجامعات أبوابها، البلديات علّقت أعمالها، شركات كبرى أطفأت أنوارها، والطرق امتلأت بمئات الآلاف.
في تل أبيب وحدها تجاوز عدد المتظاهرين نصف مليون، واقترب الرقم في عموم البلاد من مليون إسرائيلي أو أكثر.
المطالب كانت واضحة، وقف الحرب، عقد صفقة تعيد الرهائن، وإنقاذ ما تبقى من تماسك الداخل الإسرائيلي.
لكن هذه الصورة لم تُعرض داخل إسرائيل. الإعلام المحلي تجاهلها عمدًا، بينما رأى العالم الخارجي المشهد كاملا.
بين الرواية الرسمية والشارع
بينما كان نتنياهو يواصل خطابه عن “النصر الكامل”، أظهرت استطلاعات الرأي، أن ثلثي الإسرائيليين يفضلون صفقة توقف الحرب. الشارع بات يشعر أنه رهينة لحكومة ترفض الاستماع، وأن المستقبل يتراجع تحت شعارات جوفاء. لم يعد الانقسام خفيًا؛ أصبح مواجهة مكشوفة بين الحكومة ومواطنيها.
لكن الانقسام ليس سياسيًا فقط، بل أخلاقيا كذلك. ما مدى شرعية سلطة تعتبر الحرب قدرًا لا خيارًا.
هذه المليونية لم تكن نسخة من احتجاجات 2023، التي اندلعت ضد الإصلاحات القضائية التي طرحتها حكومة نتنياهو.
هذه المرة، اجتمع في الشارع أطياف مختلفة، طلاب خرجوا من جامعاتهم، بعدما التهمت الحرب ميزانيات التعليم. عمال شاركوا رغم صمت نقاباتهم الكبرى (الهستدروت) ورجال أعمال لأكثر من مائتي شركة متضررة من الوضع الاقتصادي.
كان المشهد عابرًا للطبقات، شعبيًا بلا قيادة حزبية. المعارضة اكتفت بالمراقبة، بينما بدا اليسار، كأنه فقد مركز ثقله، ولم يعد فاعلًا في الشارع، إما لانقسامه الداخلي وإما لفقدانه ثقة قاعدته. وهكذا بدا الاحتجاج أكثر صدقية، وأقرب لصوت الناس.
رغم الحشود، غابت الرايات الحزبية، وغاب الصوت السياسي القادر على تحويل الغضب إلى مشروع. الحناجر علت، لكن دون بوصلة، لم تُرفع راية واحدة. لا قيادة تتقدم الصفوف.
لم يكن الاحتجاج تعبيرًا عن أيديولوجيا، بل عن لحظة خوف، وإحساس عميق بالخذلان.
التظاهر والاحتجاج لم يكن العلامة الوحيدة على هشاشة الداخل. ففي الوقت نفسه، رُصدت حركة خروج واسعة من إسرائيل نحو الخارج.
مكاتب الطيران ووكلاء السفر تحدثوا عن زيادة لافتة في الحجوزات نحو قبرص، اليونان، الإمارات، وأوروبا الغربية، ولم يكن هذا خروجًا عاديًا للسياحة، بل تكرارًا لنمط قديم: عندما تهتز الطمأنينة، يختار الإسرائيليون المطار قبل الشارع..
في حرب الخليج 1991، هرب الآلاف إلى أوروبا؛ خوفًا من صواريخ صدام.
مع الانتفاضة الثانية، تضاعفت طلبات الجوازات الأوروبية، حتى وصل عدد الحاصلين عليها إلى نصف مليون.
خلال أزمة القضاء 2023، خرج من السوق 70 مليار شيكل، وارتفعت طلبات الهجرة 40%.
وفي عام 2024 فقط، غادر 82,700 إسرائيلي البلاد مقابل دخول 56 ألف فقط– لأول مرة منذ عقود، يميل ميزان الهجرة ضد إسرائيل، وأصبحت هناك دول جاذبة لتجمعات اليهود الهاربين مثل رومانيا وقبرص.
هذه الأرقام تعكس تحولًا نوعيًا، تؤكده شهادات شخصية لوكلاء سفر: “نحن لا نتعامل مع موسم عطلات”، يقول أحدهم، “إنه موسم فرار”.
تقول المؤرخة الفرنسية فريدريك شيلو المتخصصة في الشأن الإسرائيلي في وصف المشهد: ظاهرة غير مسبوقة، وكان الحديث عنها من المحرمات.
وتنقل قناة فرانس 24 عن مغادرين قولهم: “لم نعد نشعر أن هذه الدولة تخصنا”. وليس الخروج من المطار مجرد فعل جغرافي، بل انكسار في العلاقة مع الوطن.
هكذا يصبح الخروج اليوم خروجًا مضاعفًا من الحرب والخطر الخارجي (إيران، غزة، حزب الله)، ومن الداخل ذاته، حين ينفجر بالغضب ويغيب الإحساس بالثقة في الدولة.
طفلٌ رفع لافتة كُتب عليها: “أبي في غزة… أمي في المطار”. هذه ليست جملة شاعرية، بل لافتة حقيقية، رفعها طفل في ساحة ديزنجوف في تل أبيب. ربما تلخص وحدها انهيار البيت الإسرائيلي من الداخل: غياب الأب، انسحاب الأم، وضياع الطفل.
الطوابير في مطار بن جوريون تقف جنبًا إلى جنب مع الحشود في تل أبيب؛ مشهدان يعكسان أزمة واحدة: إسرائيل تهرب من نفسها، إما بالاحتجاج أو بالمغادرة.
الانقسام داخل القيادة
في مواجهة هذا الوضع، لم يظهر صوت موحد من الحكومة. نتنياهو يتشبث بخطاب الحسم، فيما يلمّح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن صفقة تبادل قد تكون مخرجًا ضروريًا. هذا التباين أضعف صورة السلطة، وأعطى المحتجين ثقة، بأن الشرخ لم يعد فقط في الشارع، بل وصل إلى رأس الهرم السياسي.
في بلدٍ اعتاد على التماسك، صار الانقسام علنيًا، صار الخوف من الداخل أكبر من الخوف من العدو، وصارت الطائرات التي تقلع من بن جوريون أكثر انتظامًا من قرارات حكومته.
ورغم كل ذلك– المظاهرات، الطوابير في المطارات، الانقسام في القيادة، النزيف الاقتصادي– لم تُظهِر حتى الآن مؤشرات واضحة على تغيّر جذري في اتجاه الرأي العام الإسرائيلي الانتخابي. لا تزال الأغلبية تميل نحو اليمين، وفق استطلاعات حديثة.
وسط هذه الانقسامات، يبدو أن اليمين في إسرائيل هو الطرف الوحيد الذي لا يهتز.
السؤال يطرح نفسه بقوة: لماذا يظل اليمين ثابتًا رغم هذا الزلزال، بينما يعجز اليسار عن قلب المعادلة؟
اليمين يتحدث بلغة بسيطة، لكنها عميقة التأثير: الأمن أولًا. في بلد يعيش وفق معادلات القوة منذ تأسيسه، تبقى لغة البقاء أكثر إقناعًا من لغة التغيير. اليمين لا يعد بحلول، بل يقدم حماية. وهذه وعود أقوى في لحظات الخطر.
في المقابل، فشل اليسار في إسرائيل في إنتاج خطاب جديد بعد أوسلو. غابت الرؤية، وابتعد المشروع، وتحول إلى نخبوي معزول في المدن الكبرى، فاقد للحضور الشعبي. منذ اغتيال رابين، لم يظهر زعيم يساري، يمتلك كاريزما أو قدرة على مخاطبة الهامش الإسرائيلي.
الصراع بين اليمين واليسار، ليس سياسيًا فقط، بل هو تجاذب بين ثلاث قوى:
منطق الأمن والخوف (اليمين).
منطق العدالة والحقوق (اليسار وفق الفهم الإسرائيلي الخاص).
منطق البرجماتية اليومية (المركز).
الأمن ما زال يتفوق على السياسة في الوعي الجمعي. الخوف من إيران وحماس، وحزب الله يعزز خطاب القوة. وفي ظل معارضة بلا مشروع موحّد، ويسار شبه غائب عن المشهد، تظل الخيارات الانتخابية محدودة أمام الناخب الإسرائيلي.
لكن أي تماسك هذا، حين يكون قائمًا على الخوف؟ وهل يمكن لـ”ديمقراطية” أن تعيش طويلًا في ظل معادلة تربط البقاء بالقوة فقط؟
المليونية الأخيرة لم تكن مجرد صرخة من أجل الرهائن، بل مرآة مكسورة، عكست صورة إسرائيل اليوم. شارع يغلي، مجتمع يهرب، حكومة منقسمة، حرب على جبهات عدة.