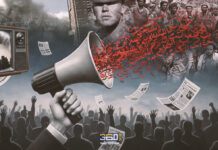منذ اندلاع الحرب المفتوحة بين القوات المسلّحة السودانية (الجيش) وقوّات الدعم السريع في إبريل 2023، ظلّ الصراع يتسع أفقيًا وعموديًا جغرافيًا عبر دارفور وكردفان والخرطوم، ونوعيًا عبر تنامي الارتزاق المنظّم وتحوله إلى رافعة قتالية ولوجستية، خصوصًا في معسكر الدعم السريع، بما ساهم في تغيير قواعد الاشتباك خلال 2024- 2025.
وطبقا لهذه المستجدات، فإن حضور الفواعل غير النظامية والمقاتلين العابرين للحدود، قد أطال أمد الحرب ورفع كلفتها الإنسانية، وفتح الباب أمام تدويل الصراع وربطه بشبكات التهريب والذهب والسلاح في مناطق البحر الأحمر والساحل والصحراء.
في هذا السياق، تعد ظاهرة المرتزقة بنية تحتية موازية للحرب، حيث توفر الخبرة النارية، خطوط الإمداد، وغطاء التمويل الأمر الذي انعكس على فاعلية طرفي الصراع السوداني، وتطرح أسئلة بشأن خيارات السياسات المصرية مع هذا التطور على الحدود المصرية.
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى تقارير أممية أفادت أن قوات الدعم السريع اعتمدت منذ منتصف 2023 على تدفقات مقاتلين أجانب ومتعاقدين عسكريين خاصّين عبر ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، مع إنشاء عقد لوجستية في شمال دارفور (بير مرقي)، وربطها بممرّات تهريب الوقود والسلاح والذخيرة.
كما تشير إفادات فريق الخبراء الأممي المعني بالسودان إلى تأسيس خطوط إمداد عبر الشرق التشادي وجنوب ليبيا وجنوب السودان، مع استخدام تكتيكات لامركزية في التخزين والنقل، وذلك لتقليل تعرّضها للضربات الجوية.
في المقابل، هناك تقارير سودانية، تتحدث عن اعتماد الجيش على مقاتلين من التيجراي الإثيوبيين في مراحل محددة من القتال أثناء السيطرة على مناطق شرق السودان والجزيرة، فضلا عن الاعتماد على خبرات أوكرانية نوعية في مراحل أخرى من القتال.
مع عام ٢٠٢٥، رصدت دراسات بحثية ميدانية، أنجزتها مؤسسة الأسلحة الصغيرة، أنه قد جرى استقدام مقاتلين محترفين من كولومبيا للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وهو ما تم تقديم اعتذار رسمي عنه من جانب كولومبيا للسودان.
في هذا السياق، فإن تداعيات تدفق المرتزقة على توازنات القوى في الحرب السودانية تبدو متعددة، كما أنها مؤثرة على البيئة التي يعمل فيها هؤلاء المرتزقة، ولعل أبرز هذه التداعيات هو أقلمة الصراع أي فتح الباب أمام امتداده الإقليمي، خصوصا وأن غالبية الدول المحيطة بالسودان هي دول هشة، كما أنها تسهم من ناحية أخرى في تدويل الصراع؛ بسبب مرور المرتزقة بنقاط حدودية ومطارات ومواني وغيرها في شبكة معقدة للتمويه، أما على الصعيد الاجتماعي، فإن حضور الأجانب يحدث أزمة ثقة في البيئة المحلية السودانية بشأن قدرتها علي حسم الصراع لصالحها، كما يغذي خطاب التهديد الوجودي. ولعل الأثر الإيجابي هو الأثر العسكري من حيث القيمة المضافة للجهة المستقدمة للمرتزقة، وذلك على مستوى الخبرات النارية، خصوصا في تشغيل المدرعات والمسيرات، فضلا عن قدرات القنص والاقتحام.
وطبقا للتقارير الدولية، فإن اتساع رقعة الاشتباك تعد من أهم تداعيات اتساع ظاهرة الارتزاق العسكري في السودان ذلك أن: وجود قوات محترفة صغيرة وخفيفة الحركة يتيح هجمات سريعة على مراكز صحية ومخازن غذاء ومحطات وقود؛ لفرض «تجويع تكتيكي» وإخضاع مجتمعات محلية، وذلك طبقا لما جرى في مناطق شمال كردفان، كما تم رفع مستوى العنف ضد منتسبي قبيلتي الزغاوة والمساليت في دارفور منذ منتصف عام ٢٠٢٤، فضلا عن وجود واستمرار أثر باق، وهو أن أدوات تمويل المرتزقة من مناجم الذهب وإتاوات الطرق والممرات، سيكون من الصعب إزالتها بعد انتهاء الحرب، بما ترتب عليها من مصالح اقتصادية مؤثرة سياسيا واجتماعيا لفئات بعينها.
ويمكن القول إن استمرار ظاهرة الارتزاق الأجنبي في السودان، سوف تساهم في تثبيت التفوق غير المحسوم للدعم السريع في دارفور، وذلك في إطار عدد من المسارات المتوقعة، منها أن تستمرّ شبكات الإمداد والارتزاق بوتيرة متوسطة، فتساهم في الحفاظ على مستوى قدرات الدعم السريع الحالية في الحصار والاقتحام في مناطق شمال دارفور وأجزاء من جنوب كردفان، وذلك مع هجمات متقطّعة على سلاسل الإمداد المدنية. وهو الأمر الذي يعني موجات نزوح ومجاعات موضعية، وتصلّب سياسي في مواقف التفاوض. كما أنه مع تزايد تدفق المرتزقة ودخول أنظمة تسليح جديدة ونوعية، فإنه من المتوقع الحد من فاعلية سلاح الجو السوداني، وزيادة في ضربات العمق المتبادل في كافة المناطق على الجغرافيا السودانية، فضلا عن تضخم الجريمة المنظمة خارج السودان، خصوصا في تشاد والنيجر وليبيا وإفريقيا الوسطي، بما يزيد من حجم ظاهرة الارتزاق العسكري، ولا يقلل منها.
على الصعيد المصري، فإن هذه التطورات تعني زيادة احتمال تسرب السلاح والمرتزقة الي الصحراء الغربية، كما أن استمرار اقتصاد الحرب القائم على الذهب والتهريب قد يعيد تنشيط مسارات بحرية غير شرعية في الساحل الغربي للبحر الأحمر، بما يعد معطى إضافي لتهديد أمن الملاحة، وهي تهديدات كبيرة تتطلب انخراط القاهرة في عمليات تعاون إقليمي لتفعيل آلية رقابة حدودية، تشمل تتبّع الطيران والشحن البري، وعقوبات ذكية على الوسطاء اللوجستيين، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يساهم في رفع كلفة الارتزاق، ويساهم في تعطيل معدلات التجنيد الخارجي، خصوصا من أمريكا اللاتينية، كما أنه من المطلوب بلورة منصات وآليات دعم مجتمعي وصحي في شرق تشاد وشمال دارفور، بتنسيق ودعم أممي وذلك لتعطيل حلقات التجنيد القسري والتهريب، ويقلل من موجات الارتزاق أو اللجوء غير المنظّم.
هذه الأدوار الهامة من المقترح، أن يساهم فيها مركز الساحل والصحراء لمحاربة الإرهاب الموجود بالقاهرة تابعا لتجمع الساحل والصحراء، وذلك كمجهود مصري في إطار إقليمي، فضلا عن المجهودات المصرية التي يتم بلورتها على الصعيد المحلي.
أي إطار تفاوضي جديد، يحتاج إلى ورقة ضغط لوجستية، تتمثل في ربط وقف النار المؤقّت بإغلاق عقد التمويل والارتزاق، وتقديم حوافز اقتصادية للمجتمعات الحدودية، بديلاً عن اقتصاد الحرب.
توصيات عملية
1ــ آلية إقليمية لمراقبة الحدود الغربية للسودان.
إنشاء مركز عمليات مشترك. (مصر– تشاد– ليبيا– إفريقيا الوسطى) يتبادل بيانات الطيران غير المنتظم وحركة القوافل، ويربطها بإشعارات فورية للأمم المتحدة.
استخدام عقوبات «موجّهة» تطال الوسطاء اللوجستيين ومشغّلي النقل الأرضي/ الجوي الداعمين لتدفق المرتزقة والسلاح، بدلاً من عقوبات عامة تزيد كلفة المدنيين
2ــ تجفيف تمويل الارتزاق عبر الذهب
- دعم سلاسل توريد مسئولة للذهب من دارفور، بمساعدة تقنية لأدوات التتبع (Chain of Custody) ومراكز شراء رسمية على حدود تشاد، ما يقلّص هوامش الربح لشبكات الحرب.
- تفتيش مُحسّن في منافذ العبور (المطارات/ المواني الإقليمية) لرصد شحنات الذهب غير الموثّقة.
3ــ قدرات مضادّة للطائرات بدون طيار ومنظومات الدفاع الجوي القصير.
دعم الجيش السوداني بأنظمة تشويش وكشف، ومسيرات اعتراض دفاعية، مع تدريب ميداني يقلّل أثر المسيّرات الانتحارية والـMANPADS بيد الجماعات غير النظامية
حماية المدنيين وممرّات الإغاثة كرافعة تفاوض.
- ربط أي تخفيف للعقوبات أو حوافز إعادة الإعمار بوقف أنماط الهجوم على المدنيين، وبممرات إنسانية مؤمّنة حول الفاشر وشمال كردفان.
- نشر آلية أممية– إقليمية رشيقة للتوثيق الفوري للانتهاكات (Near -Real -Time) بما يحرم مرتكبي الجرائم من «أثر الصدمة» غير الموثّق ويخفض وتيرة العنف
استراتيجية اتصالات مضادّة للارتزاق:
- حملات موجّهة للمجتمعات المصدّرة للمرتزقة (داخل السودان وخارجه) تبيّن الأكلاف القانونية والإنسانية، مع قنوات خروج آمنة وإعادة إدماج لمن يرغب بالانسحاب.
- العمل مع حكومات أمريكا اللاتينية لتجريم وتفكيك شبكات التجنيد الخاصة المتورطة في إرسال مقاتلين إلى السودان.
- تساؤلات مفتوحة
- هل المرتزقة سبب أم نتيجة؟
كِلاهما: نتيجة لانهيار احتكار الدولة للعنف وتحوّل الذهب والتهريب إلى اقتصاد سياسي للحرب؛ وسبب لإطالة أمد الصراع عبر رفع الكفاءة النارية وتوسيع شبكة المصالح التي تعيش على استمرار القتال.
ما حدود قدرة الجيش على كسر شبكة الارتزاق؟
يتوقّف الأمر على تعطيل الممرّات (خصوصًا شرق تشاد وشمال دارفور) وعلى تحسين الدفاع الجوي القصير والمسيّرات المضادّة. دون ذلك، سيظلّ تأثيره تكتيكيًا محدودًا.
هل يغيّر الارتزاق معادلة التفاوض؟
نعم إذ يخلق لدى الدعم السريع إحساسًا بالقدرة على الاستمرار، ويعوّض النقص البشري، فيما يضغط على الجيش عبر حرب استنزاف.
وكسر هذا الانطباع يحتاج تكاليف إضافية على الوسطاء وممرات التمويل أكثر من «نصر ميداني سريع
ما أثره على النسيج الاجتماعي السوداني؟
يعزّز الانقسام الإثني ويضاعف دوائر الثأر، إذ تُقرأ الانتهاكات باعتبارها «اعتداء غريب/وافد»، فتتصلّب الهويات السالبة. معالجة ذلك تتطلّب عدالة انتقالية محلية وآليات مصالحة تتزامن مع ضبط الحدود.
منظومة عابرة للحدود
تكشف ظاهرة المرتزقة في السودان عن نقلة نوعية في بنية الحرب، من صراعٍ على السلطة داخل دولة منهَكة إلى منظومة قتال عابرة للحدود، تسندها تجارة الذهب والسلاح والتهريب وحواضن قبلية– اقتصادية، تمتدّ من دارفور إلى تشاد وليبيا وأبعد.
وما لم تُعالَج البنية التحتية للارتزاق، الممرّات، الوسطاء التمويل، فإن أي تسوية سياسية ستبقى هشّة، إذ يمكن إعادة إشعال الجبهات بسرعة بواسطة الشبكات نفسها. المعادلة واضحة ضغط ذكي على اللوجستيات وحماية المدنيين مع مسارات اقتصادية بديلة للمجتمعات الحدودية، ستؤدي إلى انكماش مساحة الارتزاق، وبدون ذلك سنواجه تدويلًا متصاعدًا، يمدّد حرب السودان، ويؤذي الإقليم برمّته.