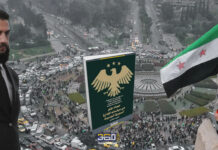جاء صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق علي كوشيب القائد الميداني لميليشيات الجنجويد في 7 أكتوبر الحالي، متزامنًا مع تمديد ولاية البعثة الأممية لتقصي الحقائق لعامٍ ثالث، ليعيدا معًا فتح ملف العدالة في السودان كأحد أكثر القضايا تعقيدًا وتشابكًا في المشهد السياسي الراهن. فهاتان الخطوتان الدوليتان لم تكونا حدثين معزولين، بل مؤشرًا على عمق الأزمة التي يعيشها السودان منذ اندلاع حرب الخامس عشر من إبريل 2023، والتي كشفت عن هشاشة منظومته العدلية.
تكمن أهمية اللحظة الحالية، في أنها تمثّل مفترق طرق بين العدالة كمدخل لإعادة بناء الدولة والعدالة كعامل لاستدامة الصراع. فبينما يرى المجتمع الدولي في الأحكام الصادرة ضد مجرمي الحرب إشارة إلى التزامٍ بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ينظر جزء من السودانيين إليها بعين الريبة معتبرينها شكلاً من أشكال التدخل الخارجي الذي يعمّق الانقسام، ويهمّش الإرادة الوطنية. وبين هذين المنظورين، يقف ملايين الضحايا، ينتظرون عدالة لم تأتِ بعد لا من الداخل ولا من الخارج.
تسعى هذه الدراسة إلى قراءة متأنّية في تاريخ ومسار العدالة في السودان من منظور سياسي واجتماعي انطلاقًا من التجارب السابقة في فترات الحكم العسكري والمدني، مرورًا بمحاولات ما بعد ثورة ديسمبر 2018، وصولًا إلى اللحظة الراهنة التي تتداخل فيها أدوات العدالة الدولية مع واقعٍ وطني ممزّق بفعل الحرب والانقسام. فالدراسة لا تنظر إلى العدالة بوصفها إجراءً قانونيًا فحسب، بل باعتبارها مرآة لأزمة الدولة السودانية نفسها.
الدولة والعدالة… علاقة مضطربة منذ الاستقلال
منذ لحظة تأسيس الدولة السودانية الحديثة في أعقاب الاستقلال عام 1956، ارتبط مفهوم العدالة بمركز السلطة أكثر مما ارتبط بمفهوم الحق أو الإنصاف. فقد تشكلت بنية القضاء والمؤسسات العدلية في ظل دولة ما بعد الاستعمار كامتدادٍ للنظام الإداري البريطاني الذي لم يكن هدفه تحقيق العدالة، بقدر ما كان يسعى إلى ضبط المجال العام، وبهذا المعنى، وُلدت العدالة السودانية، وهي محمولة على إرثٍ سلطوي، حيث أصبحت الدولة هي مصدر العدالة وغايتها في آنٍ.
خلال العقود التالية، تكرّس هذا التماهي عبر أنماط الحكم العسكري والمدني على السواء. ففي فترات الحكم العسكري، تم إخضاع القضاء للأوامر العليا، واعتباره أداة لحماية النظام لا لمساءلته. أما في الفترات الديمقراطية القصيرة، فقد ظل القضاء أسيرًا للبنى البيروقراطية والعلاقات الطبقية التي تشكّلت منذ العهد الاستعماري، دون أن يمتلك القدرة أو الاستقلالية الكافية لتأسيس تقاليد عدلية راسخة. وهكذا أصبحت العدالة في السودان انعكاسًا لطبيعة الدولة نفسها قوية في قمعها وضعيفة في إنصافها.
ومع اندلاع ثورة ديسمبر 2018، بدا لوهلة، أن العدالة ستتحرر من أسر الدولة، وأنها ستتحول إلى ركيزةٍ لإعادة بناء النظام السياسي على أسسٍ جديدة. غير أن تجربة ما بعد الثورة، سرعان ما كشفت، أن مؤسسات العدالة رغم الشعارات الكبيرة بقيت جزءًا من الصراع حول السلطة، وليست أداة لتقييدها. فالمحاكمات المتعلقة بجرائم النظام السابق تعثّرت، والعدالة الانتقالية لم تجد طريقها إلى التنفيذ، لأن الدولة العميقة ظلت تمسك بالمفاتيح القانونية والإدارية نفسها.
العدالة المؤدلجة… حين تحوّل القضاء إلى أداة للسلطة
لم تُتح للسودان فرصة بناء منظومة عدلية حقيقية، تعكس قيم المواطنة المتساوية، أو تعيد الاعتبار لضحايا التهميش والانتهاكات التي ورثها من عهد الاستعمار. فالنخب السياسية التي تولّت الحكم، سواء كانت مدنية أو عسكرية لم تتعامل مع العدالة كقيمة تأسيسية لبناء الدولة، بل كأداة لتثبيت نفوذها أو تصفية خصومها. وهكذا تحوّل القضاء إلى مجالٍ لتجسيد الولاءات السياسية، وتحوّلت العدالة إلى مرآة للسلطة لا لمبادئها.
ورثت الحكومات الوطنية جهازًا قضائيًا محكومًا بهياكل إدارية استعماريّة، ولم تُجرِ أي إصلاح مؤسسي جذري، يضمن استقلال القضاء عن الجهاز التنفيذي. كان همّ النخب حينها تثبيت السيطرة السياسية على الدولة الوليدة، وليس إعادة تعريف العلاقة بين العدالة والسلطة. ومع أول نظام عسكري عام 1958 بقيادة الفريق إبراهيم عبود بدأ التسييس المنهجي للقضاء عبر إقالة القضاة المعارضين، وتعيين آخرين يدينون بالولاء للنظام. ومنذ ذلك الحين أصبح القضاء ساحة من ساحات الصراع السياسي، لا مؤسسةً تقف على مسافة واحدة من الجميع.
ومع عودة الحكم المدني في الستينيات، لم تنجح النخبة الحزبية في استعادة ثقة الشارع أو بناء مؤسسات عدلية مستقلة. فالصراع بين الأحزاب التقليدية، الطائفية منها واليسارية، أنتج حالة من الشلل التشريعي والانتقائية في تطبيق القوانين، ما أدى إلى تآكل مصداقية العدالة. ثم جاء انقلاب جعفر نميري عام 1969 ليعيد صياغة علاقة الدولة بالعدالة في إطارٍ سلطوي أكثر وضوحًا، حيث جرى إنشاء محاكم خاصة واستثنائية، كانت وظيفتها هي حماية النظام وإضفاء الشرعية على قمع المعارضة.
ومع سقوط نظام نميري عام 1985، وقيام الديمقراطية الثالثة، تكرّر المشهد ذاته؛ إذ ظلت النخب تتصارع على سلطة الدولة، بدلًا من إصلاح مؤسساتها. ولم تُفتح أي ملفات للمحاسبة أو العدالة الانتقالية رغم وجود ضحايا ومظالم متراكمة منذ عقود. هذا العجز عن بناء عدالة انتقالية بعد سقوط الأنظمة المتعاقبة، مهّد الطريق أمام نظام الإنقاذ عام 1989 ليُحكم قبضته على القضاء من جديد، ولكن هذه المرة بغطاء أيديولوجي واضح.
فقد جاء نظام البشير بانقلابٍ عسكري، قاده الإسلاميون ورفع شعار “التمكين” الذي ترجم عمليًا إلى إحلال الكادر الحزبي مكان الكادر المهني في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء والنيابة العامة. تم فصل مئات القضاة وتعيين آخرين على أساس الولاء العقائدي. كما فُرضت تشريعات ذات طابع ديني أيديولوجي، استُخدمت لتبرير الإقصاء والعقاب السياسي، فصارت العدالة جزءًا من مشروع الهيمنة الفكرية للنظام، لا من منظومة حقوقية متوازنة.
وفي مرحلة ما بعد الثورة الشعبية عام 2018، كانت الآمال كبيرة في إصلاح هذا الإرث الثقيل. غير أن الحكومة الانتقالية وجدت نفسها أمام إرث مؤسساتي مترهل وشبكات نفوذ معقدة، بينما غلب على قراراتها الطابع السياسي. فبدلًا من تأسيس مسار قضائي متكامل للعدالة الانتقالية، تم إنشاء لجان سياسية مثل “لجنة تفكيك التمكين” التي تبنّت شعارات المحاسبة، دون أن تُبنى على أساس قضائي. ومع مرور الوقت تحولت هذه اللجان إلى أداة صراع سياسي وأمني، ما أعاد إنتاج ذات الحلقة المفرغة: عدالة محمولة على دوافع سياسية لا على أسس قانونية مستقلة.
هذا التاريخ الطويل من التسييس لمفهوم العدالة، جعل المواطن السوداني، يرى العدالة كامتداد للسلطة لا كحقٍّ أصيل. ومع كل دورة سياسية جديدة، تتجدد الوعود بالإصلاح، لكن تظلّ هنالك مقاومة لأي استقلال فعلي للقضاء. فالدولة التي نشأت على منطق السيطرة، لا تستطيع بسهولة، أن تقبل بعدالة تُحد من سلطتها. ولهذا بقي القضاء السوداني طوال تاريخه رهينة “الشرعية السياسية” أكثر من “الشرعية القانونية”.
الثورة والعدالة المؤجلة– وعود ديسمبر التي لم تتحقق
أعادت حرب 15 إبريل 2023 تعريف مفهوم العدالة في السودان بطريقة غير مسبوقة. فبينما كانت البلاد تحاول منذ ثورة ديسمبر 2018، أن تبني مسارًا انتقالياً نحو حكم مدني قائم على العدالة والمساءلة، جاءت الحرب لتقوض كل ما تبقى من مؤسسات الدولة، وتُدخل العدالة نفسها إلى ساحة الصراع. لم تعد العدالة مطلبًا وطنيًا جامعًا، بل أصبحت سلاحًا سياسيًا وأخلاقيًا في يد الأطراف المتحاربة، تُستخدم لتبرير القتال أو لإدانة الخصم، لا لتحقيق الإنصاف للضحايا.
في هذا السياق، تحول مطلب العدالة من كونه عملية قانونية إلى قضية وجودية، تتعلق ببقاء الدولة نفسها. فالمجتمع السوداني المنهك من الحروب والانقسامات، بات يرى في العدالة شرطًا لبقاء ما تبقى من العقد الاجتماعي. ومع ذلك، فإن هذا الإدراك لم يُترجم إلى إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف المتحاربة. الجيش يرى نفسه حامي الدولة والشرعية، وبالتالي، يبرر العنف بصفته وسيلة لاستعادة النظام، بينما تدّعي قوات الدعم السريع، أنها تقاتل من أجل “التحول المدني” و”إنهاء الدولة العميقة”، لكنها في الواقع تمارس انتهاكات واسعة ضد المدنيين في دارفور والخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد.
إنّ هذا الاستخدام المتبادل للخطاب العدلي بين الأطراف يعكس مأزقًا عميقًا في بنية العدالة السودانية نفسها التي لم تُفصل يومًا عن السلطة. فحين غابت الدولة لم تجد العدالة من يدافع عنها، لأنها لم تكن ملكًا للمجتمع، بل كانت دومًا جزءًا من منظومة الحكم. وهكذا تحولت العدالة في زمن الحرب إلى مساحة صراع رمزي، يُحاول كل طرف احتكارها لفرض روايته.
في ظل هذا الانهيار، برزت محاولات محلية محدودة لإحياء مفهوم العدالة المجتمعية من خلال المبادرات الأهلية والوساطات القبلية والآليات التقليدية للتسوية. غير أن هذه الجهود ظلت محدودة التأثير، لغياب الإطار المؤسسي الذي يمنحها الشرعية. كما أن الحرب خلقت واقعًا جديدًا من الانقسام الجغرافي والإداري، إذ أصبحت العدالة تُمارس بشكلٍ مختلف من منطقة إلى أخرى تبعًا لسيطرة الأطراف المسلحة. فالمناطق الخاضعة للجيش تُطبّق قوانين عسكرية استثنائية، بينما تُدار مناطق الدعم السريع بقرارات ميدانية، لا تخضع لأي نظام قانوني معروف.
ومع تفاقم الأوضاع، بدأ الحديث الدولي عن “المساءلة” و“العدالة” يطفو على السطح مجددًا، خصوصًا مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة التحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور، وقرار مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق في السودان لعام ثالث. لكن هذا الحراك الدولي واجه سؤالًا جوهريًا: هل يمكن للعدالة الدولية، أن تكون بديلاً عن غياب العدالة الوطنية، أم أنها ستتحول إلى عاملٍ إضافي لتعميق الانقسام السياسي؟
من جهة، يرى كثيرون من الناشطين والضحايا، أن تدخّل العدالة الدولية هو الأمل الوحيد لمحاسبة مرتكبي الجرائم في ظل غياب الدولة. ومن جهة أخرى، تخشى قوى سياسية ومجتمعية، أن يتحول هذا التدخل إلى أداة ضغطٍ سياسية، تُستخدم لتبرير التدخلات الأجنبية أو لتقويض السيادة الوطنية. هذا الجدل يعكس عمق الأزمة العدلية في السودان، حيث لم تعد المسألة محصورة فيمن يحاكم من، بل فيمن يملك شرعية إقامة العدالة أصلًا.
حرب 15 إبريل وانهيار الدولة القانونية
مع تزايد طول أمد الحرب وفشل محاولات التفاوض، بدأت أطراف النزاع تبحث عن أدوات سياسية، تكرّس وجودها كسلطة أمر واقع. ومن هنا، أعلن حميدتي ومجموعة من القوى السياسية المتحالفة معه – وفي مقدمتهم عبد العزيز الحلو وبعض الفصائل المدنية المسلحة – عن خطواتٍ لتأسيس كيانٍ سياسي وإداري موازٍ للدولة، رُوّج له باعتباره “تحالف التأسيس الجديد”.
لكن هذا التحالف على الرغم من شعاراته حول “التحول المدني” و“إعادة هيكلة الدولة”، حمل في جوهره مشروعًا سياسيًا لتأمين الحماية القانونية والرمزية لقادة الحرب وتوفير غطاء سياسي، يُحصّنهم من المحاسبة المستقبلية.
إنّ تكوين هذه الحكومة الموازية كان خطوة محسوبة لتغيير معادلة العدالة والمساءلة في السودان. فبدلًا من أن تكون العدالة مرجعيةً فوقية، تحكم الجميع أصبحت موضوعًا للنقاش السياسي وميدانًا للمناورة. كل طرف في الصراع يسعى إلى إعادة تعريف العدالة، بما يخدم شرعيته:
الجيش السوداني يطرح نفسه بوصفه الحامي الشرعي للدولة، ويرى أن العدالة تبدأ باستعادة المؤسسات “من المليشيات”، بينما الدعم السريع وحلفاؤه يقدّمون أنفسهم كضحايا “الاستبداد العسكري”، ويستخدمون خطاب “العدالة للضحايا” لتبرير حربهم وإعادة إنتاج وجودهم السياسي.
بهذا الشكل تم تسييس مفهوم العدالة بالكامل، إذ لم يعد السؤال: “كيف نحاسب الجناة؟” بل “من يملك الحق في المحاسبة؟”. هذا الانزياح في مركز النقاش يعكس مأزقًا عميقًا في الوعي السياسي السوداني، حيث تُختزل العدالة في الخطاب لا في المؤسسات، وفي الصراع على الشرعية لا في احترام القانون.
تاريخيًا، كان تسييس العدالة أحد أدوات تثبيت الأنظمة الحاكمة في السودان. لكن ما يحدث اليوم يتجاوز ذلك؛ إذ إن الحكومة الموازية تمثل محاولة لإعادة هندسة المشهد العدلي برمّته. فهي تسعى إلى خلق منظومة قانونية وسياسية موازية، تُعيد إنتاج مفهوم “الشرعية الثورية”، ولكن خارج مؤسسات الدولة.
هذا المسار يتيح لقادة الحرب ومناصريهم مناورة قانونية جديدة: فبدلاً من الاعتراف باختصاص القضاء الوطني أو الدولي، يمكنهم الادعاء، بأنهم جزء من “كيان سياسي شرعي بديل” ما يمنحهم حصانة واقعية، وإن لم تكن قانونية.
إنها صيغة حديثة لـ”الهروب من العدالة”، تعتمد على الحشد الشعبي والغطاء السياسي لا على قوة القانون.
وفي ظل هذا الواقع المنقسم تراجع دور القضاء الوطني إلى أدنى مستوياته، وفي المقابل، تكتفي الأطراف المختلفة بإصدار بيانات سياسية أو تشكيل “لجان تحقيق” دون أي نتائج ملموسة، وهو النمط ذاته الذي ظل يتكرر في كل مراحل التاريخ السياسي السوداني.
إن تكوين الحكومة الموازية من قبل حميدتي والحلو، يُمثّل أخطر تجلٍّ لحالة الانقسام العدلي في السودان؛ لأنه يسعى لتقنين واقع الانقسام بدل تجاوزه. هذا التكوين يخلق طبقة سياسية محصنة ضد المساءلة، ويحوّل مفهوم العدالة من غاية وطنية إلى أداة دفاع سياسي. ومع مرور الوقت، سيُسهم هذا النموذج في ترسيخ فكرة “العدالة الانتقائية”، حيث تُستخدم المحاسبة كوسيلة لتصفية الخصوم، لا لتحقيق الإنصاف.
ومع ذلك، لا يمكن فصل هذا المسار عن السياق الأوسع لحرب 15 إبريل التي دمّرت مؤسسات الدولة، وأعادت إنتاج منطق القوة كمرجع وحيد للشرعية. فما دام الدولة نفسها منقسمة ستبقى العدالة منقسمة معها. وما لم يُستعاد الإجماع الوطني حول فكرة العدالة بوصفها قيمة فوق سياسية، فإن أي حكومة– سواء كانت مركزية أو موازية– ستعيد إنتاج العجز نفسه، وإنْ بصيغة جديدة.
إن أخطر ما في الانقسام الراهن ليس فقط تعطيل العدالة، بل تحويلها إلى أداة حصانة سياسية، تُستخدم لتبرير الحرب وحماية المتورطين فيها. فالعدالة التي لا تملك قوة التنفيذ، تبقى خطابًا أخلاقيًا هشًّا، يُستعمل في البيانات والتصريحات، لكنه لا يغيّر واقع الضحايا على الأرض. وهذا بالضبط ما يحدث اليوم في السودان، حيث تتحول العدالة من وعدٍ بالإنصاف إلى آلية جديدة لإدامة الإفلات من العقاب تحت لافتات جديدة.
محاكمة منسوبي نظام البشير بعد الثورة– العدالة بين الرمزية والخذلان
مثّلت ثورة ديسمبر 2018 لحظة فارقة في التاريخ السياسي السوداني، إذ أزاحت نظامًا استبداديًا استمر لثلاثة عقود، وفتحت الباب أمام آمالٍ واسعة بإقامة دولة القانون والمواطنة. كان شعار “حرية، سلام، وعدالة” هو قلب الخطاب الثوري، ولم يكن مجرد مطلب سياسي، بل وعدًا أخلاقيًا باستعادة كرامة السودانيين وإنصاف ضحايا الانتهاكات.
غير أن هذا الشعار سرعان ما اصطدم بواقعٍ مؤسسي وسياسي معقد، حوّل العدالة إلى ملفٍّ شائك بين قوى الثورة والسلطة الانتقالية، وبين المدنيين والعسكريين، بل وبين الشارع والبيروقراطية العدلية نفسها.
عقب سقوط نظام البشير في إبريل 2019، برزت توقعات واسعة، بأن تبدأ مرحلة جديدة من المحاسبة الجادة، وأُعلن عن نية محاكمة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم في دارفور. لكن سرعان ما تبيّن أن هذه المحاكمات كانت محصورة في قضايا مالية بسيطة، تتعلق بـ”الثراء الحرام” أو “التعامل بالنقد الأجنبي”، بينما تم تجاهل القضايا الجوهرية المتعلقة بالقتل والتعذيب والإبادة الجماعية.
أظهر هذا المسار منذ بدايته أن الدولة الانتقالية، لم تكن تمتلك الإرادة السياسية أو الأدوات القانونية الكافية لإقامة عدالة حقيقية. فالمؤسسات العدلية التي ورثتها من نظام الإنقاذ، كانت نفسها جزءًا من منظومة القمع السابقة. القضاة، والنيابة، والأجهزة الأمنية لم تخضع لعملية إصلاح شاملة، بل استمر كثير من رموزها في مواقعهم. وبدلًا من تفكيك البنية القانونية للنظام السابق، جرى العمل ضمنها فكانت النتيجة أن العدالة وُضعت في “قفص النظام القديم”، دون أن تتحرر من سلطته الرمزية أو المؤسسية.
لقد انعكس هذا الإخفاق في عمل لجنة إزالة التمكين التي أُنشئت بقرار سياسي لتفكيك شبكات نظام البشير واسترداد الأموال العامة. ورغم الزخم الشعبي الذي رافقها، إلا أن اللجنة كانت تعمل في فراغ قانوني، حيث لم تكن تعمل وفق إطار قضائي، واعتمدت على قرارات إدارية وسياسية ومع مرور الوقت تحولت اللجنة من أداة للمحاسبة إلى ساحة صراع بين القوى المدنية والعسكرية، وانتهى بها الأمر، إلى أن تُحل بقرارات انقلاب 25 أكتوبر 2021، دون أن تحقق العدالة المنشودة، أو تستعيد ثقة الشارع.
هذا الفشل لم يكن عَرَضيًا، بل هو نتاج مباشر لتاريخٍ طويل من تماهي العدالة مع السلطة السياسية. فحتى بعد سقوط نظام البشير بقيت المؤسسات العدلية، تُدار بذات المنطق القديم: الولاء أولًا، والمساءلة مؤجلة. لم يتم إصلاح القوانين المقيدة للحريات أو تشريعات الأمن العام، ولم تُفعّل آليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. والأسوأ، أن الحكومة الانتقالية لم تُسلّم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، رغم تعهدها بذلك في إشارة واضحة، إلى أن العدالة الدولية أيضًا كانت رهينة للمساومات السياسية الداخلية.
إنّ التجربة العدلية في مرحلة ما بعد الثورة لم تفشل فقط في محاسبة رموز النظام السابق، بل ساهمت أيضًا في تفكيك الثقة الشعبية في إمكانية تحقيق العدالة داخل السودان، ولقد كانت محاكمات البشير ورفاقه فرصة تاريخية لإعادة تأسيس منظومة عدلية جديدة قادرة على ترميم العلاقة بين الدولة والمجتمع، لكنها ضاعت بين الخلافات السياسية والصفقات الانتقالية، وبذلك تحوّلت العدالة من وعد ثوري، إلى مرآة تعكس فشل الطبقة السياسية في الوفاء بوعود الثورة.
إن السودان اليوم في أمسّ الحاجة إلى عدالة تُعيد الثقة بين المواطن والدولة، لا عدالة تُدار من الخارج بمعزل عن الواقع المحلي. فكل مسار عدلي لا يمر عبر فهم عميق لبنية المجتمع السوداني، سيظل عرضة للتسييس والاستقطاب. ولذا فإن إعادة بناء منظومة العدالة يجب أن تبدأ من الداخل، من المحاكم الوطنية ومن إصلاح القوانين ومن تمكين القضاة المستقلين لا من انتظار قرارات، تصدر من جنيف أو لاهاي. وهو ما يفرض على الفاعلين الحقوقيين التفكير في مقاربة جديدة توازن بين المساءلة والواقع وبين القانون والسياسة؛ لتتحول العدالة من عامل استقطاب إلى ركيزة للاستقرار.