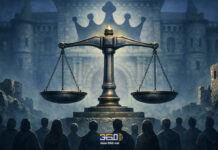عند افتتاح المتحف المصري طرح سؤال الهوية نفسه مجددا.
من نحن بالضبط.. عرب أم فراعنة.. أم ننتسب إلى حضارة البحر الأبيض المتوسط، أم “بزرميط” كما تساءل ساخرا السيناريست الكبير “أسامة أنور عكاشة” في رائعته “أرابيسك”؟
استثار سؤال الهوية هذه المرة مساجلات، انقضى ضجيجها سريعا كالعادة انتظارا لمناسبة أخرى.
هل تعاني مصر أزمة هوية حقا؟!
بالقطع: لا.
لماذا الإلحاح على طرح السؤال إذن؟
للنيل من انتسابها العربي وأدوارها في محيطها.
هكذا بكل وضوح.
بالثقافة والمصير والتاريخ، فمصر عربية مشدودة إلى محيطها العربي، الانعزال عنه حكم بالإعدام التاريخي وإهدار لأمنها القومي في صميم اعتباراته.
مصر عربية، تعتز بإرثها الفرعوني، متأثرة بثقافة البحر المتوسط، وجزء من الحركة الفوارة في الإقليم، منتسبة إلى قارتها الإفريقية، ومتداخلة مع عالمها الإسلامي، متنوعة دينيا، والتنوع عامل قوة لا ضعف.
تراكمت تجاربها وخبراتها في أنحاء حياتها، إرث الحضارة المصرية القديمة ظل ساريا في اللغة والعادات والتقاليد وطبائع الشخصية، رغم اختلاف الأزمان.
إنكار التاريخ تجهيل بما جرى فعلا على شواطئ النيل عبر القرون.
وإنكار التراكم تجهيل آخر بحقائق الأمور، المنطقة التي نحيا فيها اختلفت، جوارنا عربي ومحيطنا الحيوي عربي وأمننا القومي عربي، مصادر التهديد القديمة كـ”الهكسوس” اختفت من على خرائط الجغرافيا السياسية، وحلت مكانها مصادر أخرى، أخطرها التهديد الإسرائيلي.
عروبة مصر ليست قضية معلقة في فضاء المساجلات.
إنها مسألة وجودية.
من حق كل مصري، أن يفخر بإرثه الحضاري، دون أن ينكر ما جرى للبلد بعد انقضاء الحضارة المصرية القديمة من غزوات واحتلالات وهجرات واختلاط دماء.
الكلام عن النقاء العرقي وهم مطلق، فضلا عن كونه عنصرية صريحة، أو كامنة.
الحضارات القديمة كلها صبت في مجرى تاريخي واحد لتصنع الإنسانية المعاصرة.
الاعتزاز لازم وإنكار الحقائق انتحار.
كان افتتاح المتحف المصري الكبير، بكل ما يحتويه من إرث حضاري لا مثيل له في أي متحف آخر بالعالم كله، داعيا للفخر الجماعي.
ذات درجة الفخر الجماعي استشعرها عامة المصريين في احتفالية موكب المومياوات الملكية الفرعونية.
في المرتين، جرت مداخلات على شبكة التواصل الاجتماعي، حاولت إنكار عروبة مصر، قيل كلام كثير عن “الاختراق الوهابي” للمجتمع المصري في السبعينيات وما بعدها، كأن العروبة تتحمل مسئوليته، والإسلام يمكن تلخيصه في ذلك المذهب المتخلف بالغ الرجعية.
في أوقات سابقة، جرت حملات أعلنت الطلاق مع العروبة؛ بهدف تصفية الحسابات مع ثورة يوليو بعد حرب أكتوبر (1973).
لم تكن تلك الحملات عشوائية وانطباعية وغير مؤسسة فكريا، فقد تبناها مفكرون وأدباء كبار كـ”توفيق الحكيم” و”لويس عوض” و”حسين فوزي”، ورد عليها في وقته وحينه جمهرة المثقفين المصريين على رأسهم الناقد الأدبي الكبير “رجاء النقاش”.
في مساجلات السبعينيات، دعا “الحكيم”، إلى “تحييد مصر”، أو بصياغة أخرى انعزالها عن عالمها العربي، لا شأن لها بأزماته وقضاياه.
كان ذلك صداما مباشرا مع صلب نظرية الأمن القومي في مصر، حقائق الجغرافيا والتاريخ معا.
حسب المفكر الجغرافي الدكتور “جمال حمدان“، فإن مصر إذا ما انعزلت داخل حدودها تتعرض للتهميش السياسي، تستباح تماما، وإذا ما خرجت إلى محيطها الطبيعي، تنهض وتتقدم وتكتسب صفة الدولة الإقليمية العظمى.
إذا كان هناك من يتصور إن إنكار العروبة ممكن فهو واهم.
لم تخترع ثورة يوليو المشروع العروبي، لكنها جسدته أملا حيا على الأرض بسياسات تبنتها ومعارك خاضتها.
قيمة “عبد الناصر” في التاريخ، ليست أنه حكم مصر، أكبر دولة عربية، ولا أنه أنجز بقدر ما يستطيع، أصاب وأخطأ، وهذا كله يستحق مراجعته بالوثائق الثابتة لا الأهواء المتغيرة.
قيمته، أنه عبّر عن فكرة، أن مصر تستطيع أن تكون قوية وتجعل العالم العربي قويا معها فتتضاعف قوتها.
كان صراع الأفكار والسياسات قبل يوليو، هو من أعطى زخما ميدانيا للفكرة العروبية بمعانيها الحديثة.
أرجو ألا ننسى أن الفكرة العروبية الحديثة نشأت في المشرق العربي، الذي يتعرض الآن لتخريب مقدراته، وتلوح فوق الخرائب خرائط التقسيم، لمناهضة سياسات “التتريك”، كما أنها دمجت المسلمين والمسيحيين في نسيج فكري وثقافي وسياسي واحد على نحو غير معتاد من قبل، وأحد الأسباب الجوهرية الماثلة حاليا لزعزعة الوحدة الداخلية لبلدان عربية كثيرة، غياب أي مشروع للدمج على أساس قواعد المواطنة والمساواة أمام القانون بين مكوناته وتنويعاته.
كان دخول مصر إلى حلبة التاريخ بعد تأميم قناة السويس عام (1956)، وتصدرها لقيادة حركات التحرير الوطني في ذلك الوقت إيذانا بضخ دماء جديدة في المشروع العروبي.
أيا ما كانت متغيرات السياسة فلا عروبة بلا مصر ولا مستقبل لمصر خارج عالمها العربي.
هذه حقائق لا يصح إنكارها باصطناع تناقض ما بين الانتساب للعروبة والفخر بالإرث الحضاري المصري.
لم يحدث مثل هذا التناقض في الإجابة الصينية على سؤالي الهوية والمستقبل.
في خريف (2017)، لمح الرئيس الصيني “شي جين بينج” علامات إعجاب وانبهار على محيا ضيفه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في ولايته الأولى، وهما يتجولان معا في “المدينة المحرمة” درة الحضارة الصينية بقلب العاصمة بكين: “نحن أقدم حضارة في العالم”.
التفت “ترامب” للمغزى السياسي في العبارة التي استمع إليها توا: “لكن الحضارة المصرية أقدم منكم”.
لم يكن لديه ما يرد به على رسالة الرئيس الصيني المبطنة سوى أسبقية الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها الذي يفوق إرث أية حضارة أخرى.
- “هذا صحيح، لكن حضارتنا اتصلت”، قاصدا أن الصين حافظت على لغتها وهويتها، رغم ما ألم بها من تراجع فادح وتخلف طالت معاناته بفعل الغزو الأجنبي وهيمنته على مقاديرها.
التجربة المصرية اختلفت بعد غروب الأسر الفرعونية، غيرت لغتها لمرات عديدة من المصرية القديمة إلى القبطية واليونانية، حتى استقرت على العربية وغيرت ديانتها لمرات عديدة أخرى حتى سادها الإسلام.
التنوع الحضاري يضيف ولا يلغي.
استخدام الإرث الحضاري التليد لدواع سياسية قضية أخرى تماما.
الإفراط في سؤال الهوية تعبير عن مجتمع مأزوم، لا يثق في نفسه ومستقبله غائم أمامه.
هذه حقيقة تتأكد أهميتها عند النظر في أحوال الصحة والتعليم والتنمية وأولويتها المتراجعة بفداحة.
مصر في حاجة ماسة إلى إجابات أخرى على تحدي الهوية من حيث هو مسألة أمن قومي وتحدي المستقبل من حيث هو مسألة نهضة وسقوط.