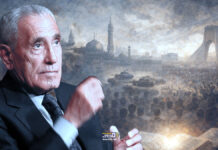“الحمد لله الذى أعطانا هذه الفرصة لنرى الأماني وقد تحققت.. الحمد لله فقد كنا نحلم بالجزائر العربية وقد رأينا اليوم الجزائر العربية”.
بتلك الكلمات ابتدأ “جمال عبد الناصر” خطابا مقتضبا ألقاه في العاصمة الجزائرية يوم (٤) مايو (١٩٦٣).
لم يمن على الثورة الجزائرية بحرف واحد، أو بإشارة عابرة.
لا قال إننا أمددنا الجزائر بالسلاح، ولا ناصرناها بالمال، ولا أن فرنسا شاركت في حرب السويس عام (1956) للانتقام من دورنا في نصرة ثورتها.
قال نصا: “جمال عبد الناصر لم يفعل أي شيء لشعب الجزائر”.
لم يكن ذلك صحيحا على أي وجه، لكنه خاطب الكبرياء الجزائري، الذي ينفر من المن عليه.
كانت الجزائر تعرف الحقيقة وتقدرها، ولم تكن في حاجة إلى من يذكرها.
في ذلك اليوم الاستثنائي زحف مليون جزائري من أنحاء البلاد إلى العاصمة لرؤيته، افترشوا الطرقات العامة وناموا فوقها بالقرب من الميناء، ملايين أخرى سدت الطرق وكادت تحطم السيارة التي كان يستقلها مع الرئيس “أحمد بن بيللا”، فاضطرا لأن يصعدا إلى أعلى عربة مطافئ مضت بين الجموع الحاشدة.
لم يكن خطاب الجزائر عشوائيا في بنيته وصياغاته، فقد استند على دراسات موسعة عن الشخصية الجزائرية واكبت إطلاق ثورتها.
كان التفكير الاستراتيجي المصري في خمسينيات القرن الماضي، يعمل على “فتح الجبهة الجزائرية في موقع القلب من الشمال الإفريقي لتوجيه ضربة قاضية للاستعمار الفرنسي الذي سيجد قواته مطالبة بمواجهة واسعة على ساحة الشمال الإفريقي كله يرغمه أن يخفف ثقل قواته على الجناحين الآخرين تونس ومراكش”.
وفق تلك الرؤية، دخلت مصر طرفا أصيلا وشريكا كاملا في حرب تحرير الجزائر دون ادعا ء، أو مَن.. وتولت إذاعة “صوت العرب” تحت قيادة الإعلامي الأبرز “أحمد سعيد” مهمة الجبهة الإعلامية.
من هنا بدأت أعظم معاركها.
– من أين نبدأ؟
– بم نبدأ؟
– ثم كيف نبدأ؟
الأسئلة طرحت نفسها والإجابات اكتسبت جديتها، استنادا على دراسات معمقة في التاريخ الجزائري والشخصية الجزائرية، شئونها وأحوالها “حتى أوشكنا أن نصبح جزائري الهوية”- كما كتب “أحمد سعيد” في مذكرات خطية لم يتسن لها أن تنشر حتى الآن.
كل ما هو منسوب للشخصية الجزائرية خضع لنقاش مستفيض شارك فيه أكاديميون مصريون وسياسيون جزائريون حول سماتها الرئيسية:
مثل: الانكفاء على الذات توجسا من الغير.
مثل: جرعة الانفعال تقبلا وسماحة، أو رفضا وعنفا.
مثل: أهو جفاف ومكابرة أم إباء وكبرياء؟
مثل: أهو اندفاع إلى درجة التهور بالسلب أو الإيجاب أم هو تردد إلى درجة
التوجس والتجمد؟
أثبتت الدراسات المستفيضة:
أنه- أولا- مسلم والإسلام متجذر في أعماقه.
وأنه- ثانيا- عاشق لمصر ولأزهرها وزعمائها وكتابها وفنانيها مثل “يوسف وهبي” و”عماد حمدي” و”فاتن حمامة” و”زينات صدقي” و”إسماعيل يس”.
وأنه- ثالثا- العروبة عنده لا تنفصل عن الإسلام، فهي لغته أيا كانت جذوره العرقية.
وأنه- رابعا- ينظر إلى فرنسا كرمز كبير للثقافة والحضارة وإبداع الفنون وسوق العمل والرزق مهما تدنى العمل وتضاءل الرزق، لكنه يرفض احتلالها ويلعنه وأحيانا يقاومه.
برؤية محكمة استخدمت الإذاعة الوليدة التراث الجزائري في تمهيد الجو العام للثورة.
تليت أشعار وألفت أغانٍ ومسلسلات إذاعية وبثت نداءات من شيوخ طرق صوفية ترددت في آلاف المساجد وعشرات الآلاف من الزوايا.
تميزت برامج التعبئة بالقصر والوضوح، كأنها طلقة تعرف هدفها وكيف تصل إليه.
لم تزد أية مقتطفات صوتية عن أكثر من نصف دقيقة وتناثرت بين الفقرات تحت عنوان واحد: “كلمة حق”.
أُذيعت بكثافة أقوال وأشعار الأب الأكبر للنضال الجزائري في القرن العشرين “عبدالحميد بن باديس”.
كقوله: “إن هذا الشعب الجزائري المسلم ليس فرنسيا، ولا يمكن أن يكون فرنسيا، ولا يريد أن يكون فرنسيا، ومن المستحيل أن يكون فرنسيا ولو أراد التجنس”.
وكشعره: “شعب الجزائر مسلم.. وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله.. أو قال مات فقد كذب”.
اكتسبت تلك الأقوال والأشعار أهمية إضافية من كونه أمازيغي الأصل.
كانت المسألة “الأمازيغية” معضلة كبرى اعترضت الثورة الجزائرية كعمل جماعي مشترك لكل تنوعات المجتمع.
ساعدت علوم التاريخ والاجتماع والنفس في تجاوز تلك المعضلة، التي هددت الثورة في محطات عديدة.
أجريت دراسات في كل الشمال الإفريقي شاملا بدو سيوة تولاها ثلاثة من كبار المؤرخين المصريين: “د. أحمد عزت عبدالكريم” و”د. عبدالحميد العبادي” و”د. زكى محمد حسن”، بالإضافة إلى “عثمان سعدى”، وهو باحث جزائري حصل على درجة الدكتوراه فيما بعد.
كان الهدف الرئيسي من تلك الدراسات الموسعة الإجابة عن سؤال واحد: كيف تتوحد الجزائر بكل مكوناتها من أجل الاستقلال؟
كانت نصيحة “محمد بوضياف” التركيز على ما يجمع.
كان دور “حسين آية أحمد”، أحد قادة الثورة الأمازيغي الأصل، رئيسيا في إضفاء إجماع وطني على حركة التحرير المسلحة.
وكان دور “ديدوش مراد”، أحد أبطالها وهو بدوره أمازيغي الأصل، حاسما في إحباط فتنة أريد بها ضرب وحدة الجزائر، وهو صاحب شعار: “البربر عرب”.
هكذا تأسست الأدوار المصرية في عالمها العربي على درس وبحث واطلاع، لا على شعارات مجوفة من كل معنى، أو قيمة.
كانت معركة الجزائر واحدة من أهم المعارك، التي خاضتها ثورة (23) يوليو.
في نوفمبر (1954) قبل (71) عاما بالضبط، انطلقت أول رصاصة في حرب التحرير الجزائرية.
كتب بيان الثورة في القاهرة.
هذه حقيقة تاريخية ثابتة، لكنها شبه مجهولة.
كان لافتا في خطاب “عبدالناصر”، الذي ألقاه بالجزائر، تركيزه شبه المطلق على القضية الفلسطينية، التي كانت توصف عن حق بقضية العرب المركزية.
ربما أراد أن يلفت انتباه الجزائريين، بعدما حصلوا على استقلالهم بالدماء، أن واجبهم يحتم عليهم نصرة فلسطين بأقصى ما يستطيعونه من جهد.
في حرب الجزائر تأكدت وحدة المصير العربي.
أثناء فتنة مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر (٢٠٠٩) بدت الذاكرة العامة مثقوبة.
كان كل شيء هستيريا وأغلب ما يكتب على ورق أو يبث في فضاء عار حقيقي.
وكان الشحن الإعلامي والسياسي على الجانبين قد وصل إلى التنابز بالأوطان واختلاق الوقائع والقصص المحرضة على القتل.
بدا أن الهدف إخفاء فشل النظامين تحت غبار مباراة كرة قدم.
بعد (16) سنة من تلك الفتنة استثارت تصريحات بغير أساس أو سند للفنان المصري “ياسر جلال” أثناء تكريمه في مهرجان وهران زوبعة أقل وطأة بكثير لكنها عبرت عن ثقوب في الذاكرة العامة، خطيرة ومنذرة.
لم يكن هناك ما يدعوه إلى انتحال قصة وهمية عن تواجد قوات صاعقة جزائرية لتأمين ميدان التحرير إثر نكسة (1967)، لكنه التجهيل بالتاريخ، الذي يعتمد الشائعات أسلوبا لقراءته.
الحقيقة، التي يجب أن تقال، إنه ليس واحده