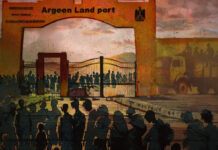ربما كانت أحد نتائج الحرب على غزة– التي تراجعت دون أن تتوقف بشكل كامل- أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى بؤرة الأحداث عالميا، أيضا في وجدان الأجيال العربية الأصغر سنا، رغم أنها لم تغب بالتأكيد عن مخيلة أجيال، سبق أن عاصرت أحداثا، يمكن أن نطلق عليها مفصلية في تطور القضية.
لهذا، ندرك جميعا مدى خطورة أن تتوارى قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة الذي يمثل عصبا أساسيا في القضية الفلسطينية. وفي ظل هذا البروز المتجدد للقضية الفلسطينية ولمسألة اللاجئين يصبح من المهم بمكان إبراز أهم مفاصل هذه المسألة التي تخص الحقوق الفلسطينة في الصميم، وذلك على مستوى القرارات الدولية، لأنها وأيا كانت تقلبات الأحداث ستظل تشكل المرجعية الحقوقية على الأقل أمام الرأي العام الدولي الذي بات أكثر اطلاعا ووعيا بما لا يقاس عليه الحال سابقا إزاء التوحش والاكتساح الإسرائيلي لكل الحقوق الفلسطينية، وفي المقدمة منها اللاجئين وحقهم في العود ة لأرضهم.
المفارقة هي، أننا بتنا نواجه سيلا جارفا من اللاجئين العرب “سودانيين- يمنيين- سوريين– عراقيين– ليبيين” بشكل يمكن وصفه بالدراماتيكي، بل هي الدراما الأكبر في الألفية الثالثة، في أعقاب ثورات الربيع العربي. وقد أدى ذلك فعلا إلى تراجع الاهتمام بمأساة الشعب الفلسطيني دبلوماسيا وإعلاميا، وفي المنتديات الدولية، حتى بدأت أحداث السابع من أكتوبر، تطل برأسها لتطغى على بقية الأحداث التي نعيشها وتعيد التذكير بمفاصل ومحاور القضية العربية الأم.
ولمحاولة التعرف أكثر على سبب ما جرى من تراجع، يكفي أن نعرف أن تعداد اللاجئين والنازحين الذين فروا من الحرب الأهلية في سوريا فقط، وفقا لآخر إحصائية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر 2025، هو 7.4 ملايين لاجئ، ويزيد هذا العدد عن تعداد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، حيث قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن تعدادهم يقدر بخمسة ملايين وتسعمائة ألف لاجئ.
ورغم التأكيد المتكرر، على أن القضية الفلسطينية لا يجوز اختصارها، في أنها قضية لاجئين، فهي ليست قضية شتات، يبحث عن مأوى، بل هي قضية حق شعب في أرضه، إلا أننا نتناول هنا فقط قضية اللاجئين الفلسطينيين، بوصفها قضية سياسية وقانونية وإنسانية، وأيضا وقبل أي شيء، قضية وطن لا زال مستعمرا.
تطل علينا في خلفية مأساة اللاجئ الفلسطيني ذلك الإعلان المشؤوم لأول رئيس وزراء لدولة العدو الإسرائيلي ديفيد بن جوريون والمسمى “إعلان الدولة العبرية”، بمتحف الفن الحديث بتل أبيب عشية الخامس عشر من مايو 1948.
هذا الإعلان الذي على أثره تحركت خمسة جيوش عربية في اتجاه فلسطين لمحاربة ذلك الكيان الدخيل، منيت هذه الجيوش بهزيمة قاسية أمام العصابات الصهيونية التى تجمعت في فلسطين قبل إعلان هذه الدولة– المستعمرة– ببضعة عقود.
اللافت هنا، هو التأكيد على أن إعلان الدولة نفسه لم يكن في حدود وعد بلفور، بل تجاوز هذا الوعد الذي قطعه وزير المستعمرات البريطاني عام 1917.
تقول الدكتورة سوزان أكرم، (وهي أستاذة بجامعة ميتشجان ذات أصول فلسطينية)، إن وعد بلفور كان فقط (إنشاء وطن قومي لليهود)، وليس دولة يهودية، والفارق بين المصطلحين كبير جدا، فالوطن لا يعني أن يحكم اليهود فلسطين، بل أن يعيشوا فيها كمواطنين فقط.
كما أن قرار التقسيم 1947 قد نص، على أن يتم التقسيم بشكل سلمي ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، وليس بحرب عصابات صهيونية وتهجير قسري، بل ذهبت د. أكرم إلى أن قرار التقسيم لم يمنح اليهود الحق في تقرير المصير، بل منحه للفلسطينيين.
والحقيقة، أن نظرية د. أكرم لها وجاهتها، وتستحق التأمل، فحتى وعد بلفور المشؤوم، لم ينص على طرد الفلسطينيين، حيث ينص على أنه:
“على أن يُفهم جلياً، أنه لن يُؤتى بعمل من شأنه، أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين”.
الواقع، أن النزوح إلى البلدان العربية المحيطة بدأ فعليا قبل إعلان الدولة اليهودية، منذ بدايات الاعتداءات التي قامت بها العصابات الصهيونية على الفلسطينيين، وانطلاق حركة المقاومة الفلسطينية للتصدي لها، وأبرزها كانت ثورة 1936.
تحول أصحاب الأرض الذين تم تهجيرهم قسرا إلى قضية دبلوماسية “قضية اللاجئين الفلسطينيين”، وأخذت تٌتداول في قاعات وأروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى طاولات المفاوضات العربية الإسرائيلية تارة، والفلسطينية الإسرائيلية تارة أخرى، عقب زيارة الرئيس الأسبق أنور السادات إلى القدس المحتلة في نوفمبر 1977، وحتى وقتنا هذا، مرورا بالعديد من المحطات السياسية التي شهدت مفاوضات، ما بين علنية وسرية، وأبرمت اتفاقيات، تنصلت دولة الاحتلال من معظمها فيما بعد، لعل أبرز حالات التنصل هذه، هو ما صرح به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عام 1996، بأنه غير مسئول عن أية اتفاقيات قام بها سلفه إسحاق رابين (غزة- أريحا 1993).
وقد توقفت المفاوضات حتى 1998، ثم استؤنفت مجددا، وكان حل الدولتين هو الموضوع الرئيس في تلك المفاوضات، ورغم اعتراض كثيرين على هذا الحل، إلا أنه أخذ يتلاشى، ويخفت تدريجيا حتى بدا كحلم بعيد.
فلسطين ومنظمة الأمم المتحدة
وتجدر الإشارة، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين هم فئة خاصة من اللاجئين، لا تشملهم اتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين، بل أن قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصين بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد سبقا أي من جهود المنظمة الدولية في التعاطي مع قضايا اللاجئين غير الفلسطينيين، والتي بدأت رسميا مع طرح اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين للتوقيع من قبل الدول العضوة بالأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، يجب أيضا التذكير، بأن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، لم تكن كلها لصالح الفلسطينيين، فقد كانت هناك قرارات مثل القرار 107 الصادر بتاريخ الخامس عشر من مايو 1947 والخاص بالطلب من سكان فلسطين الامتناع عن التهديد بالقوة أو استعمالها.
إن الاهتمام الذي أبدته المنظمة الدولية جاء قبل إعلان قيام دولة الاحتلال بعام كامل، فمن أهم القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة قبل صدور قرارها الشهير بتقسيم فلسطين، كان القرار 106 الصادر في الخامس عشر من مايو عام 1947، بإنشاء لجنة خاصة للأم المتحدة لفلسطين (UNSCOP)، والقرار 182 الصادر في الرابع عشر من مايو 1948 والخاص بتعيين وسيط خاص بالأمم المتحدة في فلسطين (الكونت برنادوت)، والذي اغتاله الإسرائيليون بعد تعيينه بأربعة أشهر فقط في سبتمبر 1948. ثم القرار 186 الخاص بإنشاء لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين (UNCCP)، والتي يصفها المؤرخون حتى الآن، بأنها لجنة شكلية ﻻ فائدة لها، وأنها تجتمع بشكل دوري على الورق فقط.
ثم تلاه بعدها بعدة أشهر قرار التقسيم الشهير في نوفمبر، ثم القرار 212 الخاص بإنشاء صندوق خاص للاجئين الفلسطينيين في التاسع عشر من نوفمبر.
ويعتبر من أهم القرارات التي صدرت في أعقاب تفاقم مأساة اللاجئين الفلسطينيين، بعد هزيمة الجيوش العربية، هو القرار الشهير- الذي يعتبر مرجعا هاما في أي مفاوضات للتسوية مع الجانب الإسرائيلي- رقم 194، والذي تضمن إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة، وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم، وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، لتوفير مناخ يؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.
تكمن أهمية القرار 194، في أنه يضمن للفلسطينيين حق العودة، واستعادة ممتلكاتهم ومنازلهم التي صادرها الاحتلال الإسرائيلي، أو التعويض عنها، إن كانت أزيلت، وهو حق يضمنه القانون الإنساني الدولي المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربعة 1949، واتفاقية اللاجئين 1951.
ويمكن أن نفسر التعنت الإسرائيلي في التعاطي مع هذا الحق، في أن تطبيقه يعني عودة ما يزيد عن خمسة ملايين فلسطيني في دول الشتات إلى الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعني ببساطة تغيير البنية السكانية لصالح الفلسطينيين، ويمكن اعتبار هذا القرار بمثابة المرجعية التي يسعى الطرف الفلسطيني إلى تطبيقها، وتساند الدول العربية هذا الحق رغم رفض كافة الدول العربية التي حضرت التصويت على القرار، وهي مصر والمملكة العربية السعودية واليمن وسوريا والعراق ولبنان، ولكن تم تبني القرار بموافقة 35 دولة، ورفض 15 وامتناع 8 دول عن التصويت منهم إيران. ومحاولات العرب المستميتة لتطبيق هذا القرار، بالإضافة إلى محاولتهم أيضا تطبيق قرار التقسيم والذي رفضوه أيضا آنذاك (نفس الدول، بالإضافة إلى إيران قد رفضت قرار التقسيم أيضا)، والتفاوض اللاحق حول الدولتين، يمكن اعتباره ناجم عن عدة أسباب منها مبادرة السادات بزيارة القدس المحتلة وتغيير الأوضاع في المنطقة.
اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي
يتم تعريف اللاجئين الفلسطينىيين وفقا للأونروا، بأنهم “أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين يونيو 1946، وحتى مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم؛ نتيجة حرب 1948″، وتكمن خصوصية مسألة اللاجئين الفلسطينيين، في أن لهم كيان خاص مستقل، كما ذكر في البداية، وهو وكالة الأونروا، والتي تكونت قبل انشاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولهذا السبب، فإن الحالة الفلسطينية هي حالة خاصة في القانون الدولي وبناء على هذا فإن هناك مادة مخصصة للفلسطينيين في اتفاقية 1951، حيث تنص المادة 1 (د) من الاتفاقية على أنه:
“لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب، دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائياً، طبقاً لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، جراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية”.
ووفقا لهذه المادة، فإن اللاجئ الفلسطيني المسجل لدى منظمة الأونروا، لا يحق له الحصول على الحماية أو المساعدة أو كليهما من مفوضية اللاجئين.
وتكمن المشكلة التي تواجه العديد من الفلسطينيين غير المسجلين لدى الأونروا، أو المقيمين في دول غير مستضيفة لمخيمات الأونروا مثل مصر التي يوجد بها فقط مكتب تمثيل للأونروا، وليس ساحة للمخيمات.
وبالرغم من الفقرة الثانية من هذه المادة التي تنص، على أنه إذا توقفت المساعدات، فإن اللاجئ يستفيد من أحكام اتفاقية 1951، إلا أن العديد من الدول، ومنها مصر لا تطبق هذا، وتتمسك بالمعاملة الخاصة للفلسطينيين، فيما يعرف بما يسميه بعض خبراء القانون الدولي للاجئين بـ”فجوة الحماية “Protection Gap، وهناك العديد من الدراسات القانونية الرامية إلى سد هذه الفجوة القانونية، ربما كان أهمها كتاب أصدره مركز البديل الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، والذي أورد العديد من التفسيرات التي تمنح اللاجئ الفلسطيني الحق في التمتع بالحماية والمساعدة في الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين. وفي الحالات التي تنطبق فيها مواد اللاجئين الخاصة بهذه الاتفاقية، فإن تطبيق المادة الأولى يتم وفقا لكافة التفسيرات القانونية بمعناه الواسع، فتنص المادة الأولى (أ)، الفقرة الثانية على أن يشمل من واجه اضطهادا في بلد جنسيته، أو الأشخاص عديمي الجنسية، إذا واجهوا اضطهادا في بلد إقامتهم المعتادة. وذهبت بعض الدراسات إلى اعتبار الفلسطينيين من عديمي الجنسية، بما فيهم حاملي وثائق سفر اللاجئين في مصر وسوريا ولبنان والعراق وبعض الدول العربية الأخرى، وهو ما يمكنهم من الاستفادة مباشرة من أحكام اتفاقية 1951، ولكن يعوق هذا أمران، الإرادة السياسية للدول المضيفة، وما إذا كانت تلك الدول مصادقة على الاتفاقية أم لا.
وفي النهاية، تظل قضية اللاجئ الفلسطيني في البلدان العربية تمثل معضلة متشابكة من القرارات والقوانين والسياسات، ربما كانت في معظمها تقر قيودا وممنوعات، سواء كان البلد المضيف من دول الأونروا، أم ليس كذلك.