جدلًا كبيرًا، أثاره قرار وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أوائل الشهر الماضي، إخضاع 83 نشاطًا تجاريًا للموافقة الأمنية، شرطًا للحصول على ترخيص المزاولة. ذلك بما شمله من أنشطة رأى كثيرون أنها اعتيادية لا تحمل أي دواع تستدعي هذا النوع من الموافقة لممارستها.
وحتى بعد أن عدّل الوزير قراره في الأيام الأخيرة، باستبعاد 48 نشاطًا، وقصر طلب الموافقة الأمنية على 35 نشاطًا فقط، لا يزال القرار يحمل كثيرًا من الأسئلة حول ضرورته وجدواه وأسبابه. إذ بقيت من الأنشطة التي مازالت مدرجة ضمن سلطته: الكافيهات والمقاهي ومحال الذهب وبيع المشروبات الكحولية.
من العسكرية للبوليسية
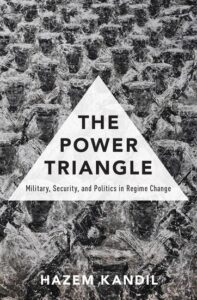
في كتابه “مثلث القوة: الجيش والأمن والسياسة في تغيير النظام“، يسعى حازم قنديل، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة كامبريدج، إلى تحديد النتائج المختلفة للصراع السياسي بين المكونات الثلاث للنظام السياسي: الجيش والأمن والسياسة؛ فيقول إن صراعًا بدأ بين الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وقائد جيشه وصديقه المشير عبد الحكيم عامر في أعقاب ثورة 1952، دفع “ناصر” إلى توسيع نفوذ الجهاز الأمني الداخلي، وحوّل معه الدولة من عسكرية إلى بوليسية بامتياز.
إذ كان لـ”عامر” نفوذ على الجيش وشعبية واسعة بين ضباطه. وهو أمر حينما أدركه “ناصر” قاومه بأساليب عدة، من بينها بناء أجهزة أمنية مدنية موازية، يكون ولائها له وحده، مثل قوات الأمن المركزي، وجهاز المخابرات العامة، وسكرتارية الرئيس للمعلومات، والاتحاد الاشتراكي العربي. وكان له دور أمني بالمراقبة والتبليغ، وبشكل خاص التنظيم الطليعي.
وفق المؤلف، كان ذلك كله لخدمة غرض واحد هو استبدال مهام المؤسسة العسكرية بمؤسسات مدنية. بينما عقب حرب أكتوبر 1973 وفي عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، انحصر انخراط المؤسسة العسكرية في السياسة، في مقابل ازدياد دور وزارة الداخلية، التي بات لديها نفوذ في الإشراف على الحزب الوطني وتعيين أعضاء الحكومة. كما تم إنشاء جهاز مباحث أمن الدولة. وكانت تلك نقطة التحول الكبرى من الدولة العسكرية إلى أخرى بوليسية.
وفي عهد مبارك، ازداد نفوذ وتمويل وإعداد جهاز الشرطة مع تدخل الداخلية في الانتخابات. واستمر هذا الوضع على ما هو عليه، كما يقول حازم قنديل حتى 2016 -وقت صدور الكتاب. [لم يتغير بناء الدولة واستمرت بوليسية].
المواطن المراقب
هذا النفوذ لجهاز الداخلية في بناء الدولة المصرية -الذي ذكره “قنديل” بكتابه- وقد تأسس على مدار عهود طويلة، إنما يمتد مع ترسخه ليتجاوز القطاعات السياسية، إلى إخضاع المواطنين للمراقبة والتفتيش المستمر. بينما يصوغ مبرراته بحماية الوطن من الأعداء في الداخل والخارج.

مفهوم الدولة الأمنية يساعد في فهم هذا. فالدولة الأمنية -كما تعرفها المنظرة السياسية الأمريكية آيرس يونج– هي تلك التي تُخضع مواطنيها للمراقبة والتفتيش من أجل حماية الوطن من الأعداء في الداخل والخارج.
ومن عناصر الدولة الأمنية -كما تصفها لوسيا زيدنر أستاذة العدالة الجنائية بجامعة أوكسفورد- التحكم بالمجتمع عبر الأجهزة الشرطية، بحيث تكون السياسات نابعة من منطلق أمني.
وهنا، الدولة الأمنية ليست ظاهرة مصرية. بل عرفتها الولايات المتحدة بامتياز -على سبيل المثال- عقب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول من العام 2001. وإن كان تاريخيًا، يمكن وصف الدولة المصرية بأنها دولة أمنية، سيطر المنطق الأمني على إداراتها المختلفة وفي العديد من القرارات والسياسات.
هناك أسباب عدة لنقل مهام مختلفة في الدولة المصرية إلى الجهاز الأمني خلال السنوات الأخيرة. لعل أبرزها عدم كفاءة البيروقراطية المصرية التقليدية، التي تتسم بإجراءات معقدة تعرقل العمليات. وهو ما دفع إلى اعتماد الدولة سياسة إنشاء بيروقراطية موازية، تتجاوز مشاكل البيروقراطية القديمة. ظهر هذا في إنشاء هيئات وصناديق مستقلة، ونقل المهام من البيروقراطية التقليدية إلى أجهزة سيادية، ترى الدولة أنها أكثر كفاءة وسرعة في الإدارة.
وفي القرار الأخير بإخضاع المحال للموافقة الأمنية، يظهر أن الدولة تسعى لإعادة النظام إلى المجتمع والشارع بالمعنىين الرمزي والمادي. إذ أنه ومنذ أحداث عام 2011 وما تلاها، أصبح مبدأ استعادة الاستقرار هدفًا رئيسيًا، لعدة سياسات تبنتها الدولة.
ولإعادة هذا الاستقرار الذي يريده النظام، كثفت الدولة أدواتها الأمنية. ليس فقط لإعادة الانضباط إلى المجتمع والشارع. بل لتقوية هذه الأدوات وجعلها أقوى مما كانت عليه قبل 2011. واستخدام هذه الأدوات في القضاء على البناء العشوائي كان من النماذج الدالة على هذه السياسة.
“في انتظار جودو”
في مسرحيته “في انتظار جودو” يعرض الأيرلندي صمويل بيكيت ببراعة، كيف ينتظر بطلا المسرحية شخصًا يدعى “جودو”، الذي لا يأتي أبدًا. هذا هو أحيانًا الحال، مع انتشار الاعتماد على الموافقات الأمنية في مجالات مختلفة، لا توجد علاقة مباشرة بينها وبين دعم حالة الأمن ومكافحة الجريمة.

الموافقة الأمنية في مصر ليست حديثة العهد نسبيًا، ولعل موافقات أجهزة الأمن في الجامعات مثالًا صارخًا على ذلك، فسفر أعضاء هيئات التدريس يتطلب موافقة أمنية أولًا. وقد تعددت حالات رفض الأمن طلبات بعض الأستاذة بالجامعات المصرية في السنوات الأخيرة. كما ألزمت بعض الجامعات بطلب هذه الموافقة قبل استضافة المؤتمرات الأكاديمية.
في عام 2019 تم تعديل قانون الإرهاب ليعاقب بالحبس والغرامة من يؤجر عقارًا دون إبلاغ الشرطة بهوية المستأجر. كذلك تتطلب إزالة العقارات -على سبيل المثال- “دراسة أمنية” تستغرق السنوات أحيانًا. وقد يؤدى هذا التأخر في الدراسات الأمنية إلى انهيار عقارات كانت حالتها خطر تستوجب الإزالة الفورية التي عطلتها الدراسة. هذا فضلًا عن تباطؤ هذا النوع من الدراسات في مسائل حل النزاع على العقارات. والنزاع على كازينو الميريلاند خير مثال على هذه البيروقراطية الأمنية التي تتسم أيضًا بآثار سلبية على الشركات والاستثمار تتشابه كثيرًا مع البيروقراطية المدنية.
نتائج عكسية
بالطبع، هناك أنشطة تتطلب موافقة أمنية. لكنها محدودة للغاية كما في حال محال بيع الأسلحة. لكن الكافيهات والمقاهي والعقارات والطباعة وغيرها من النشاطات فلماذا؟ إذا كانت لا تشكل خطرًا أمنيًا حقيقيًا، ولا تحتاج إلى حراسة خاصة.
هناك وزرارات وهيئات في الدولة من اختصاصها الرقابة على نشاط تلك المؤسسات، مثل المؤسسات التابعة لوزارات الصحة والتنمية المحلية والتخطيط والبيئة وغيرها.
إن زيادة الإجراءات الحكومة تعقيدًا، وإخضاع المزيد من الأنشطة للموافقات الأمنية إنما يعقد وقد يطيل عملية الترخيص -التي تتسم طبيعتها بالبطؤ- في مرحلة حرجة يعاني فيها اقتصاد الدولة، ويحتاج إلى تشجيع الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة.
صحيح، أن مصر قدمت الرخصة الذهبية تشجيعًا للمستثمرين. وكذلك سهلت الإجراءات البيروقراطية أمام كبار المستثمرين. إلا أن استكمال هذا يستوجب أيضًا تسهيل الإجراءات البيروقراطية للمشروعات الصغيرة وجعلها أكثر سلاسة.
اقرأ أيضًا: الأنشطة التجارية والرقابة الأمنية
على المدى القصير قد يكون التوسع في مهام الأجهزة الأمنية أكثر كفائة. لكن على المدى الطويل قد تكون له آثار ضارة على تلك الأجهزة والدولة بشكل عام. وهذه الآثار يمكن تلخيصها في الآتي:
أولًا، إن تركيز مختلف المهام في الجهاز الأمني يثقل العبء عليه، وقد يؤثر على أدائه في المهام الأكثر حيوية والأساسية في عمله فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والإرهاب. وهذا درس يمكن تعلمه من التاريخ السابق للبيروقراطية المصرية. فمنذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تضخمت البيروقراطية بلا داعي، حتى تحولت إلى مؤسسات غير قادرة على أداء مهامها بسلاسة. واستمرت بالتضخم في العقود اللاحقة، ما حولها هي نفسها إلى مصدر عبء على الدولة لاحقًا. وهي المشكلة التي تسعى الدولة حاليًا لتخطيها.
كما أن تعقيد الإجراءات الروتينية ساهم في زيادة معدلات الفساد في البيروقراطية المصرية. كذلك فإن في تحميل الجهاز الأمني مزيد من المهام الإضافية ما يجعله عرضة لأن يلحق بالبيروقراطية التقليدية، بما يشكل خطرًا وجوديًا كبيرًا على الأمن العام والقومي.
ثانيًا، إن تمركز المهام في يد الجهاز الأمني يعطل الحوكمة الرشيدة. ومن أساسيات نجاحها توزيع المهام بين المؤسسات المختلفة وعلى مستويات حكم متعددة. هذا بالإضافة إلى احتياجها لقدر عالي من الشفافية والمحاسبة.
ثالثًا، إن التغاضي عن إصلاح البيروقراطية القديمة باستبدالها بالأجهزة الأمنية، استمرار بتكليف الدولة أموالًا طائلة. إذ أن الاعتماد على أجهزة بديلة ليس حلًا مستدامًا.
اقرأ أيضًا: مهندس مصري في “جوجل”: ضغطة زر قد تنهي البيروقراطية والكثير من الفساد

وقد ذكرت الدكتورة ليلى البرادعي، عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في دراسة على المؤسسات الموازية خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن تلك المؤسسات قد تكون ضروروية بشكل مؤقت من أجل تنفيذ إصلاحات. لكنها لا تغني عن إصلاح النظام البيروقراطي وتحسين الحوكمة.
فبالنظر إلى وضع البيروقراطية المصرية اليوم، يتضح أن الحل الذي اعتمده مبارك بإنشاء بيروقراطيات موازية، لم ينجح في إصلاح الخلل في بناء البيروقراطية المصرية، كما لم يغير شيئًا.
رابعًا، حتى وإن كانت هناك مبررات بالفعل لإخضاع أنشطة غير إجرامية للرقابة الأمنية، فإن اختلاف طبيعة تلك الأنشطة عن المسائل الأمنية، قد يتسبب في حدوث أخطاء وربما انتهاكات (خاصةً كتلك التي تتعلق بحرية الفكر في كيانات مثل الجامعات).
خامسًا، إن خضوع أنشطة للرفض الأمني دون إبداء أسباب الرفض أو تسهيل إجراءات للطعن على تلك القرارات إنما يعطل مصالح المواطنين ويؤثر سلبًا على مبدأ الشفافية.
سادسًا وأخيرًا، توضح تجربة العام 2011 أنه حتى عندما كان الجهاز الأمني في أوسع نفوذه في تاريخ مصر خلال وزارة حبيب العادلي، لم يجنبه ذلك النتائج العكسية. بل تسبب هذا التوسع في انتشار الفساد والرشوة. ما أحدث غضبًا شعبيًا ضد الجهاز.
نحو الجمهورية الجديدة
أعلنت القيادة السياسية في مصر عن جمهورية جديدة تتخطى مشكلات الجمهورية القديمة. ولتحقيق هذا لا غنى عن تحقيق الحوكمة الرشيدة، التي هي إحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة.
وقد كان من الأهداف التي وضعتها وزارة التنمية المحلية تطبيق اللامركزية في الإدارة من أجل “تحقيق الأهداف ورشد القرار والإدارة العصرية والحكم الرشيد والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل”. بالإضافة إلى أن الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 يؤكد على أهمية حوكمة مؤسسات الدولة لتحقيق الشفافية والمسائلة ومحاربة الفساد.
لذا، فإن الطريق إلى الجمهورية الجديدة يتطلب حلولًا طويلة المدى ومبتكرة، وليس استخدام وسائل قديمة مثل التوسع بالدولة الأمنية أو إنشاء مؤسسات موازية أثبتت التجارب السابقة عدم فعاليتها في إحداث أي إصلاح. وذلك حتى لا تتحول الجمهورية الجديدة إلى مُعلقة.






