يمكن أن تُروى قصة محمد علي الكبير، كالتالي:
“غريب مغمور، هبط من العدم على بلد لا يتكلم حتى لغة أهلها، بلد في وضع فوضوي، غارق في الانقسامات والتحديات الخطيرة، والصراعات الدموية الشرسة، أقل خطأ قد يرتكبه الغريب قد يكلفه رقبته، لكنه ببصيرة ثاقبة يتخطى تحديا تلو آخر عبر جرأة الأسد وحيلة الثعلب؛ ليصعد من قاع العدم إلى قمة هرم السلطة، ملكا تدين له البلاد بالطاعة المطلقة، فينتشلها من الضعف إلى القوة.
عبر جيش قوي، وتحديث لا يعرف الهوادة يُوسع الملك من حدود مملكته، حتى تصير إمبراطورية شاسعة، لكن كشأن الأبطال في القصص التراجيدية، يملك الغريب خطأ مأساويا في تكوينه، عطش بلا حدود للسلطة يغويه أن يتحدى قوى أكبر منه عبر جرأة الأسد، وأن يتلاعب بها عبر حيلة الثعلب، الصفتان اللتان لم يخذلاه أبدا، بالإضافة لعزيمة لا تلين في تحقيق مراده، وإيمان لا يعرف الشك أنه منذور لشيء استثنائي، وأن القدر في صفه، وإن لم يكن فهو جسور بما يكفي لإخضاعه، لكن تلك القوى ترده مدحورا، منكمشا حتى ولو انتزع من لحمها قطعة، وهو يعضها بأنيابه، في قتال يائس أخير.
تفقده الهزيمة عقله ويجن، وينتهي حبيس غرفة في قصره غارقا في هذيانه، ذاهلا عما يدور حوله، تخلط ذاكرته الأمجاد الغابرة بأخرى متخيلة، يغزو ممالك لم يغزها في حياته، يضع خططا لحروب لم يخضها، ينتشي بانتصارات لم يحققها، يكتشف مناجم لم تطأها قدماه، فيجد أخيرا عبر أرض الخيال اللانهائية، إمبراطورية لا تتوقف عن الاتساع، ولا يمكن لأحد أن ينزعها منه”.
حتى بعد إضافة الحشو، الدلالات، الرؤى الوطنية المؤيدة والرؤى الناقدة، الآمال، الشجون، الجراح، الكذب، الشكوك، والكثير من الحقائق، تظل قصة محمد علي، بكل المقاييس قصة ساحرة.
فالتاريخ لا يكتبه فقط المنتصرون، لكن في أوقات كثيرة، يكتبه صاحب القصة الأجمل. إذ إن الغريب في النهاية، قد قدم نفسه للمصريين كوعد، كأمنية مكبوتة في النفوس، لكن وحده الرجل الجسور بإمكانه تحقيقها، لذا أعاد عدد كبير من المؤرخين، مصريون وعرب وأجانب، كتابة قصته لتماثل شيئا في مخيلتهم، شيئا تمكن الغريب، عبر لدغات “نظراته” الأخاذة من أن يقرأه في قلوبهم.
لكن في قلب ذلك السحر، يكمن السُم، الذي تجرعناه في رواية عمومية اخترعها عدد من المؤرخين الوطنيين، صيغ بها معنى الوطن ومصيره، أنه منذور لطاغية دموي مستبد، ما دام يقوم بالتحديث، بإمكاننا أن نتفاوض إذن على قبول طاغية يحمل مشروعا ينهض بالبلاد.
رواية صار الاقتراب منها من المقدسات، الانتقادات موجودة، لكنها غير مسموعة بقوة، تبدو كصوت لغريب أطوار أو لمارق، لقد تجرعنا السم أحيانا عبر الاعتراف بكونه السم الذي لم يكن هناك مفر منه، مذبحة ألم يكن المماليك عائقا ضد التقدم؟ ألم يرتكب مثلها نابليون في يافا تجنيد بالسخرة ؟ألم تفعلها جيوش أوروبا، في أوقات قريبة من ذلك العهد؟.
بالفعل، تظل مآسي التاريخ، تاريخا، يمكن فهمه -رغم كل شيء- بوصفه طريقة أهل ذلك الزمن، في حل معضلاتهم، لكن تكمن المشكلة كلها أن هذا التاريخ هو الذي صاغ حاضرنا كله، هو الذي يُستدعى ليبرر تكرار الماضي.
فُسر الاستبداد، العنف، السجون، كضرورة في حاضرنا بحكايات من قلب كتاب تاريخ محمد علي.
الأصوات الناقدة ليست جديدة، لقد بدأت من عبد الرحمن الجبرتي نفسه، المعاصر لمحمد علي، الصوت الذي ظل مقموعا، حتى إن كتابه لم يطبع إلا في عهد الخديوي توفيق، فرسم صورته بصوت واضح جلي كمتآمر دبر الدسائس والمكائد، ودمويا، أرهق شعبه بالمظالم، وكذلك صوت الإمام محمد عبده الذي نُفي بعد اشتراكه في الثورة العرابية، والذي فند في مقاله: آثار محمد علي في مصر، الكثير من إنجازاته، لينتهي إلى فكرة سبقت الكثير من الدراسات التي لم تنجز إلا في الثلث الأخير من القرن العشرين: لقد أحيا ملكه، لكنه أمات الروح المصرية، التي لم تشعر أن هذا المُلك، أو تلك الأمجاد تخصها. ثمة شخص آخر يتبدل اسمه يمتلك تلك البلد أكثر مما نمتلكها.
لكن تلك الأصوات وغيرها، والتي ظلت حاضرة لم تنجح أبدا في أن تفرض نفسها بقوة على قصة محمد علي، لأن لا ترياق لسم قصة آسرة، إلا عبر قصة تفوقها سحرا وجاذبية.
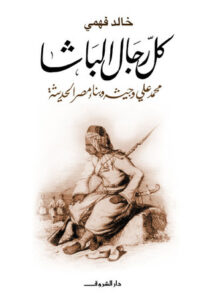
هذا تحديدا ما فعله خالد فهمي، في كتابه الشهير “كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه والدولة الحديثة” ليس فقط بسبب الجهد المضني في البحث والتنقيب، الاتكاء الذكي على إرث من سبقوه في ذلك المضمار، ولا حتى تعلم اللغة التركية من أجل قراءة الوثائق الأصلية لكشف تحريفها من قبل المخيلة الوطنية، بل تحديدا لأنه تمكن من رواية قصة ساحرة، الحكاء لا المؤرخ هو من انتصر، ربما لم يهزم القصة الأصلية بالكامل، لكنه نجح في فرض حكايته لتكون ندا للرواية الرسمية.
عشرات، بل مئات القرائن، لم تكن لتكفي، لو رواها المؤرخ لا الحكاء. لقد أنقذنا الفن!
يذكرني صديق لي، في أثناء حديث كان مفتتحه محمد علي، عن تقنيات الحكي الفريدة، التي استخدمها خالد فهمي في سلسلة حلقات على اليوتيوب بعنوان هزيمة يونيو المستمرة. إذ يتجاوز في تلك السلسلة، الأسئلة “الغبية” ليركز مباشرة على قصة أكثر إنسانية، قصة مركبة، لا تختزل صراع عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر، إلى صراع على السلطة بين متنافسين، بل بين صديقين، ليضيء مفتاحا جديدا لفهم ما حدث، إذ يمكن أن يكون صراع المتنافسين، أمرا مختزلا ومفهوما، لكن الصداقة وحدها تحتوي التركيب، الذي يحمل كل شيء، الحب والكره والتنافس بين قرينين، الإعجاب والغيرة، عدم القدرة على البطش للنهاية.
وبكل ما يملكه صوت الحكاء البدائي من تقنيات وسحر، يروي لنا حكاية نعلمها جميعا، لكن مع ذلك عبر أداء خالد فهمي تظل حكاية مشوقة. نعلم جميعا مثلا أن نكسة 5 يونيو 1967 ستقع، لكنه يرويها لنا كأننا لا نعرف، رغم ذلك وقبيل وقوعها، نشعر بالتوتر، وعند وقوعها يتغير صوته، كأنه يفاجئنا بحدث يزلزل قلوبنا ونتمنى رغم اليقين من وقوعه، ألا يحدث، وحتى نهاية الحلقات، لا يفقد المستمعين، الذين كأنما يتحلقون حول حطب صوته يطالبون بالمزيد.
لا دروس مستفادة، يحملها ذلك المقال، سوى درس بديهي بسيط ذكرني به صديقي، وخالد فهمي، ولأن لا شيء يُنسى سوى الدروس البديهية، أني كاتب قصة، فنان قبل أن أكون مثقفا عقله مدجج بالحجج والقرائن، الدرس هو:
يحيا الفن، والقصة الساحرة.






