في رحلة اليوم الواحد، طارت بنا طائرة مصر للطيران إلى العاصمة العراقية، في أول بادرة لكسر الحصار المفروض على البلد الشقيق، حين وصلنا إلى قاعة الشرف بمطار «بغداد»، كان كل شيء يشي بأننا أمام بلد يحاول أن يجمع حطامه، ويلملم ما تبقى من دولة كادت من وقت قريب أن تنعتق من تخلف العالم الثالث.
طلب منا المستقبلون أن نجمع جوازات السفر الخاصة بأعضاء الوفد المصري الموسع، وأخذت على عاتقي أن أجمع جوازات من أعرفهم بشكل شخصي، وكان عمنا «محمد عودة»، على رأس هؤلاء، وجدته يجلس إلى جانب الفنانة الشهيرة «سناء يونس»، فطلبت جوازيهما، تمنَّعت «سناء»، في البداية بطريقتها الفكاهية وقالت: طبعًا انت غرضك تعرف عمري، وتتخذها حجة لتفضح سري المكين.
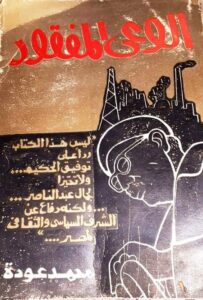
كانت هذه هي المرة الأولى التي أطلع فيها على تاريخ ميلاد أستاذي «محمد عودة» باليوم والشهر والسنة (10 يوليو عام 1920)، رغم علاقتي الممتدة معه لسنوات كنت أتوقع أنه من مواليد نهاية عقد العشرينات من القرن الماضي، فوجئت أنه من مواليد بداية العقد سنة 1920)، كان يصغر «جمال عبد الناصر» بسنتين فقط، ويكبر «محمد حسنين هيكل» بثلاث سنوات، وكنت أحسبه أقل عمرًا لحيويته المفعمة بحب الحياة، وانغماسه إلى النخاع في تفاصيلها، والعيش كل لحظة من لحظات عمره.
رغم فارق السن بيننا، ظلت روحه شابة أكثر منا جميعًا، برنامجه اليومي أكثر ازدحامًا من جدولنا، ظل هكذا حتى وفاته يوم 18 أكتوبر 2006، عدا الشهر الأخير الذي قضاه في عناية محبيه الذين تحلقوا حوله بغرفته بمستشفى «قصر العيني»، وظل طول الوقت أكثرنا تفاؤلًا بمستقبل مصر، وأشد إيمانًا وحبًا للمصريين.
**
اسمه الكامل: محمد عبد الفتاح متولي حسين عبد العال عودة. (اختصروه فقالوا محمد عودة)
من مواليد جهينة من أعمال مديرية الشرقية، اختلف حُفاظ السير، وكُتاب التاريخ، وأصحاب الطبقات في تحديد يوم ميلاده.
البعض يقسم بأيمان مغلظة أن كتبًا صفراء في حوزتهم رأوا نسخاً منها لديه تؤكد بالوصف التفصيلي أنه كان صديقاً مقرباً من «إبراهيم باشا»، وأنه صاحبه في كل فتوحاته، كان معه في «الجزيرة العربية»، وكان معه في الشام، وكان معه وهو يدق باب «القسطنطينية»، وكان معه بالقرب من «نفارين» جنوبي فرنسا.
وقالوا: إن الكتب تتحدث عن صاحب العينين الجاحظتين الودودتين، واللسان الذي يرطن الفرنسية كأهلها، ويتحدث الإنجليزية كأهل الشرقية، ويشير مؤلفوها إلى حبه للسفر والترحال، وحفظه من الشعر أعذبه، وولعه بالنساء من سن السابعة إلى السابعة والسبعين.
(وكنت أقول: هذا هو محمد عودة بالضبط، وكان يضحك وهو يقول: بدأنا التطاول).
**
يؤكد المخضرمون أنه من مواليد العام 1879، ويؤرخون لميلاده بيوم وقفة «أحمد عرابي» في مواجهة «الخديوي توفيق». (وكنتَ تسمعه يتمتم: لن نورث بعد اليوم).
البعض الآخر يقول: إنه من مواليد مارس سنة 1919. (كان يبتسم ويقول: ليت الشباب يعود يومًا).
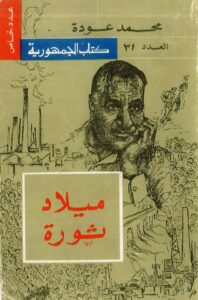
وذهب البعض إلى القول بأن ميلاد «محمد عودة» كان مع ميلاد ثورة 23 يوليو سنة 1952. (وكان يضحك من قولهم وهو يقول: كانت أيام)
بعضهم ذكر أن ميلاده الحقيقي في ساعة مبكرة من نهار يوم 9 يونيو سنة 1967، رأوا أمه تجري من ميدان إلى آخر، وقبل أن تصل إلى «منشية البكري» كان الطفل جاحظ العينين فوق ذراعيها يصرخ في وجه الهزيمة. (يحمر وجهه خجلاً ويكتفي ببسمة خفيفة على شفتيه)
وبعضهم قال: ولد في الساعات الأولى من بعد ظُهر يوم السادس من أكتوبر سنة 1973 مع زرع أول علم مصري فوق الشاطئ الشرقي لقناة السويس. (وكان وجهه يمتلأ فخرًا من قولهم، ولا ينفي)
**
المقربون منه، الحافظون لسره، يُسرون إليك أنه كان يجري وراء سيارة «عبد الناصر»، أمام الجامع الأزهر، وأنه كان من بين الذين حملوا سيارته في حلب أيام الوحدة المصرية السورية، وأنه أخبرهم بأنه رأى رؤي العين الملايين تزحف إلى بيت «عبد الناصر»، يوم 8 يونيو، قبل أن تملأ الملايين شوارع القاهرة زاحفة إليها من كل فج عميق بأربعة وعشرين ساعة.
بعض رواة سيرته يرون أنه كان يكتب في «اللواء»، أول القرن العشرين، وأنه زار فرنسا لأول مرة مع «مصطفى كامل»، وكان ترجمانه في عاصمة النور.
ويروي آخرون عنه أنه كان زميل دراسة وصديق مقرب من «سعد زغلول»، درسا معًا في مدرسة الحقوق وعمل «سعد» بالقضاء في القاهرة، وفتح «عودة» دُكان محاماة في فاقوس.
وأقسم كاتب وأديب «ماركسي» من مريديه أن الأستاذ كان ضابطًا بالجيش قبل أن يتحول إلى الصحافة، تخرج من الكلية الحربية قبل «عبد الناصر»، بدفعتين، وصل إلى رتبة «القائمقام»، ويؤكد الشاعر الماركسي أن هذا هو السبب وراء دفاع «عودة»، المستميت عن شرعية استيلاء العسكر على السلطة في عام 1952.
**
تضاربت الأقاويل في ظروف ميلاده حد التناقض، وجمعت بين ما لا يجمع، ولكنها تبقى كلها مقبولة لدى مريديه، الذين اختلفوا في ميلاده، ثم اتفقوا على كل ما يعنيه:
قالوا: اشتراكي صوفي يحب مساجد الله، وأحب أوقاته وهو يمشي مستندًا على ذراع أحد مريديه يجوب شوارع مصر الفاطمية، تلك التي عرفها صغيرًا، وعاش فيها يدرس مع والده، هو في مدرسة «خليل أغا»، وأبوه في «الجامع الأزهر».
ليس له محل مختار، فمصر هي عنوانه، وعموم الديار المصرية هي محله المختار، يعرف قراها ومدنها، كأنه مولود في كل بقعة فيها، ويعرف تاريخها تفصيلةً، تفصيلة، كأنه عاصر كل زمن مرًّ عليها.
في بيته كانت المساءات تجمع خليطًا من قلب وعقل مصر، كتاب وأدباء وفنانين وقيادات عمالية، وطلابية، ونقابيين مشهورين، ظل على الدوام شخصية جامعة مجمعة، لا يُفرق بين أحدٍ من محبيه، مهما اختلفت مشاربهم.
**
الدكتور «عبد الوهاب المسيري»، يرى أن لكل مرحلة تاريخية رموز فكرية تعبر عنها، وأن «أهم رموز مرحلة ما بعد ثورة 1952 نجيب محفوظ، وزكي نجيب محمود، وحامد ربيع، ومحمد شاكر، ومحمود أمين العالم، وأنور عبد الملك، ومحمد حسنين هيكل»، وكان يقول: «لا شك في أن أستاذنا محمد عودة من أهم رموز تلك المرحلة».
في بلاط صاحبة الجلالة تعرفت عن قربٍ بكبار في عالم القلم والأوراق، كان لكلٍ منهم بصماته على جيلنا الذي التحق بالصحافة، ولكنه وحده محمد عودة الذي كان بالنسبة لنا «الأسطى»، الذي لقننا أن القلم انحياز للتقدم، وأن الحرف مسئولية تجاه الوطن، وأن الصحافة هي بالأساس صوت الشعب، وليست صوتاً للحاكم، تعلمنا على يديه أن صحافة السلطان دعاية و«بروباجندا»، وأن صحافة الشعب وعي وفكر واستنارة.
أستاذية «محمد عودة» لم تقتصر على جيلنا، امتدت إلى أجيال متعددة، يكفي أن نذكر ما كتبه المستشار «طارق البشري»، من أن شباب جيله تعلموا من «محمد عودة»، حتى «محمود السعدني»، صديقه المقرب لا يتورع عن اعتبار «عودة» أستاذه الأول الذي لم يكن يقابله إلا وهو يحمل معه مجموعة من الكتب والمجلات الأجنبية، وأنه كان أحد أهم مصادر معرفته، وغير هؤلاء كثيرين، كانت «أستاذية محمد عودة»، تفيض عليهم فيضان الماء السهل في جداول منسابة بالرِي والنماء.
**
يربط بين كل كتب وكتابات «محمد عودة»، خيط متين يتمثل في إعادة كتابة تاريخ مصر على مسطرة واحدة، كان يرى أن مهمته هي تخليص التاريخ من الزيف، ودائمًا ما كان يوجهنا ـ ونحن في بدايات الطريق ـ إلى أن الاستعمار وأعوانه ـ والذين التحقوا بالعمل وفق رؤيته ـ حاول ـ وحاولوا معه ـ تقديم تاريخنا إلينا مشوهًا ومزيفًا، وكان يشير في هذا الصدد بما فعله الإنجليز في مصر والهند وهو الأمر الذي دفعه إلى تأليف كتابه «كرومر في مصر».
لقننا منذ بدايات التعرف عليه، أن «من لا يعرف التاريخ لا يمل من تكراره»، وكان يردد: «هذا الذي لا يعرف ما وقع قبل مولده يبقى طفلاً طوال عمره»، وكان لا يمل من التأكيد على أن قارئ التاريخ لا تتوه بوصلته، ومن موقعه وموقفه هذا كان شديد التفاؤل بالآتي، عميق الإيمان بقدرة الشعب في اللحظات الحاسمة على وضع البوصلة في الاتجاه الصحيح.
**
حين كانت شياطين اليأس تجتمع عليَّ، وتحوم حول رأسي غربان التشاؤم، كنت أبادر بالذهاب إلى مولانا «محمد عودة»، في شقته المتواضعة بعمارات الأوقاف بحي «الدقي»، كان ـ يرحمه الله ـ يمتلك مقدرة فطرية على التفاؤل، قادرًا على بث الأمل، وبعثه من جديد، وكان تفاؤله بتغيير الأحوال يفوق قدرتنا على فهم دواعيه وأسبابه الخفية التي يحتفظ بخلطتها السرية لنفسه.
لم أجده خارج منطقة التفاؤل، في أصعب اللحظات، وأحلك الظروف، وأسوأ الأحوال، كنتَ تجد «محمد عودة»، قادراً على رؤية الجانب الآخر، ذلك الذي لا تراه العين العادية، ولا تدركه العين التي لم تدرب على التقاط أشعة الأمل، تلك التي لا تُرى بالعين المجردة، ولا يمكن قياسها بالأجهزة العادية لقياس الأشعة، ولكن عين «محمد عودة»، الجاحظة المدربة على التقاط بصيص الأمل من بين ظلمات الواقع وظلاميته كانت دائمًا ترصد لنا النور الآتي من بعيد.
المفتاح الذي احتفظ به «محمد عودة»، ليفتح أبواب الأمل إذا أوصدت في وجه النخبة السياسية التي سرعان ما تفقد الأمل في إمكانية التغيير في ساعات الظلمة، أنه كان يؤمن بثقة في قدرات هذا الشعب، كان يؤمن بعظمة الشعب وجدارته، ولا زلت أذكر كيف كان يأخذني بدون مقدمات ليطوف بي في شوارع مصر «الفاطمية»، أو يدفعني دفعًا إلى التجول معه مستندًا على كتفي في حواري «بولاق الدكرور».
كأنه كان يتلقى الوحي من أنفاس الذين عاشوا داخل أسوار القاهرة القديمة، وكأنما كان يتلقى الأمل من الذين يعيشون في حواري الأحياء الأكثر شعبية والأشد فقرًا، كان يحسب نفسه عليهم، لم أره ينظر من بلكونة شقته التي تطل على شارع «حديقة الأورمان»، ولكني رأيته عشرات المرات وهو يتطلع إلى الجانب الخلفي لشقته، ذلك الذي يطل على بيوت «داير الناحية»، كأنه يطمئن على أهلٍ له هناك، ولا يمل من النظر في وجوه أتعبتها مشقة البحث عن لقمة العيش.
**

نعمة لا يعرف قدرها إلا من ذاق حلاوتها، أن تقترب من مثقف رفيع المستوى ظل منحازًا للفقراء، يأخذنا إلى بيوت ثرية، ويلفتنا إلى ثراء النفوس قبل ثراء الفلوس، ويعلمنا أن نعيش كما نكتب، وأن نكتب ما نؤمن به، وأن يكون إيماننا هو ناس مصر.
وأحسب أنه كان في زمانه كبير المتصوفة في حب مصر، وصوفيته هي مفتاح شخصيته.
صوفية «محمد عودة» التي هي فوق العشق، وقاب قوسين أو أدنى من الوله، جعلت منه نسيجا وحده، وبوًّأته مكانة خاصة بين مجايلييه، هو بينهم واسطة العقد، فيه ما هو مشترك بين كل أفذاذ هذا الجيل، ويزيد عليهم أنه يمسك بتلابيب الأمل، لا يغادره في أحلك اللحظات حتى صار التفاؤل إدمانه.
منابع الأمل عنده تأتي من وعيه بالتاريخ، ومن إحساسه بالناس، بالبسطاء من الناس، وقناعته بأن مصر قادرة وقتما تشاء، على أن تُولد من جديد.
صوفي صاحب طريقة، وطريقته هي محبة مصر وأهلها.
ذلك هو «مولانا محمد عودة».






