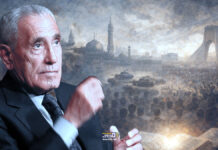كتب الزميل المحترم أنور الهواري على موقع “مصر 360” تحت عنوان “عقدة الهزيمة” يقول: “هذه الدولة العربية، ولدت مرة ثانية مصحوبة بعقدة الهزيمة التاريخية المتكررة أمام المشروع الصهيوني والدولة الصهيونية، انهزم العرب أمام الصهيونية، وهي مجرد فكرة، ثم انهزموا أمامها، وهي مجرد عصابات، ثم انهزموا أمامها في الحرب، وهي دولة، ثم انهزموا أمامها في المفاوضات، وهي تبحث عن السلام”.
المرة الوحيدة التي انتصر فيها مقاتل عربي، كانت يوم عبر المقاتلون المصريون قناة السويس قبل أكثر من نصف قرن، مثلما المرة الوحيدة التي استرد فيها العرب أرضا محتلة من إسرائيل، هي استعادة شبه جزيرة سيناء”.
ثم يقرر ويحكم دون نقض أو إبرام أنه “باستثناء هاتين الحالتين المصريتين، لم ينتصر مقاتل عربي على مقاتل صهيوني، ولم يسترد العرب شبرًا من أرض عربية، سبق أن اغتصبتها الصهيونية”.
ثلاث فقرات تحوي عددًا من “الفرضيات” التي لم تثبت على أرض الواقع، يتحدث عنها المقال، باعتبارها “يقينيات”، لا يأتيها باطل من خلف ولا من أمام، وهذا النموذج من الخطاب، يمثّل حالة ذهنية قائمة في الكتابات العربية، تستحق أن تُقرأ، وتُفكك، لا لتفنيدها فحسب، بل لفهم منطقها، ومن أين تستمد هذا النفس الانكساري رغم أن الوقائع الكبرى تقول غير ذلك.
الفقرات المنقولة عن كاتبها تسير على نمط لغوي وفكري شاع بعد 67: أسلوب يعمم الهزيمة، ويستدعيها كتفسير شامل لكل شيء، أسلوب يستخرج لحظة واحدة من التاريخ، ويحوّلها إلى قانون دائم، ويؤسس لما يمكن تسميته “الوعي القابل للهزيمة”، وعي يبدو واقعيًا، لكنه- على الحقيقةـ محمّل بالاستسلام المُقنّع.
أي تحليل لمقولة: هذه الدولة ذاتها، ولدت مرة ثانية مصحوبة بعقدة الهزيمة التاريخية المتكررة أمام المشروع الصهيوني”، يفترض أن كل ما قامت به الدولة، وكل ما تحقق، كان مجرد انعكاس لهزيمة داخلية متجذّرة، وهذا أول تعميم خطر: يحول الهزيمة من واقعة تاريخية إلى جين وطني، فيصبح أي فعل لاحق، حتى لو كان فيه انتصار أو استقلال أو مبادرة، مشكوكًا فيه؛ لأنه- حسب هذا المنطق ـ “صادر عن ذات مهزومة”.
حيث يجدون أنفسهم أمام فرضية غير مثبتة، وفي مواجهة سردية يراد تكريسها (العرب “انهزموا” أمام الصهيونية، وهي مجرد فكرة، ثم “انهزموا” أمامها، وهي مجرد عصابات)، نلاحظ استخدام تعبير انهزموا بدلًا من هُزموا، الانهزام فعل داخلي، وهُزموا فعل خارجي، وهي سردية سلبية متتالية، تبدأ من الفكرة وتنتهي بالدولة، تُظهر العرب في كل محطة أقل من التحدي منهزمين على الدوام.
هذا في الحقيقة إصرار على تقديم الهزيمة، ليست مجرد نتيجة لصراع خارجي، بل حالة ذهنية، تراكمت عبر الزمن، مما يرسّخ صورة للعجز المستمر، ويؤكد أن المشكلة لم تكن فقط في القوة العسكرية، بل في القدرة على مجابهة التحدي نفسيًا وسياسيًا.
هذا النوع من الخطاب يكون له تأثير كبير في تشكيل الوعي السياسي والشعور العام، ويكرس مفهوم أن الهزيمة باتت جزءًا من مسار العرب وسيرورتهم، وليس مجرد حدث طارئ أو مؤقت، يزول بزوال أسبابه.
ما يُغفل هنا هو، أن “الصهيونية” نفسها لم تكن مجرد فكرة حالمة، بل كانت وما تزال مشروعًا استيطانيًا مدعومًا استعماريًا، تناوبت عليه القوى الكبرى، وحظي بالحماية، والدعم المالي، والتواطؤ السياسي الغربي، ومع ذلك، فقد واجهه العرب، وبكل النقص الذي كان في استعدادهم، إلا أنهم لم يسقطوا بلا مقاومة.
ما ينساه البعض أو يغفله- لغرض في قلم الكاتب- أن الصهيونية لم تكن يومًا نبتًا شيطانيًا في أرض العرب، ولا كانت مشروعًا ذاتيًا مستقلًا عن سياق عالمي، بل كانت- وما تزال- أداة فعالة في مشروع استعماري غربي طويل الأمد، بدأ قبل وعد بلفور بزمن، حين تقرر أن يُجزّأ هذا الشرق، ويُستنزف، ويُعاد تشكيله، حسب مصالح الخارج، لا حسب إرادة أهله.
لقد تعاملت القوى الكبرى مع المنطقة العربية، لا بوصفها خريطة سياسية فحسب، بل بوصفها “جغرافيا استراتيجية”، يجب أن تبقى دائمًا تحت السيطرة، تُمنع من التوحّد، تُضعف قدراتها، تُستنزف ثرواتها، ويُزرع في قلبها كيان وظيفي، يقوم بدور الوكيل العسكري والسياسي والاقتصادي.
المعركة ليست مع إسرائيل فقط، المعركة مع الذين يريدون أن يظل هذا الوطن ممزقًا، وموارده مهدورة، وشعوبه خاضعة، لكن أصحاب “عقيدة الانهزام” لا يرون من الصورة إلا رأس السهم، لا من أطلقه.
يركّزون على العدو الظاهر، ويتغافلون- عن عمد أو تقصير- عن البنية العالمية التي صنعت هذا العدو، وتمدّه، وتحميه، وتُعيد هندسة الإقليم لصالح بقائه.
حين يرددون “هُزمنا أمام الصهيونية”، يُغفلون أن المعركة ليست مع “إسرائيل” وحدها، بل مع مشروع تفكيك الأمة منذ الحملة الفرنسية إلى احتلال العراق، ومن احتكار قناة السويس إلى اغتيال بغداد، ومن التقسيم الأول منذ قرن إلى موجات الاستباحة الجارية على كل الأراضي العربية اليوم.
تُهزم الصهيونية، حين تنهار وظيفتها، وتُكسر حين تُبنى قوة ذاتية عربية، حين يُعاد تعريف الوعي القومي، حين يُفكك العقل الذي صدّق طويلاً، أننا عاجزون ومنهزمون.
ومن أسفٍ، أن يأتي ذكر “نصر أكتوبر” لا لتثمينه، بل للإشارة إلى “فرادته” وتأكيد عزلته، كأنه الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، ولا ينفيها، ويرسخ عقيدة الانهزام لا لينقضها.
ثم تأتي أسوأ عبارات المقال المذكور، حين يقرر “باستثناء هاتين الحالتين المصريتين، لم ينتصر مقاتل عربي على مقاتل صهيوني”، وهي عبارة حادة رغم عدم دقتها، وهو قول ثقيل حين يتشابه المقاتل العربي الذي يدافع عن أرضه وكرامته وهويته، مع ما يسميه المقال “المقاتل الصهيوني” المعتدي غاصب الأرض والساعي إلى تدمير الحجر والبشر، ومحو الهوية، وسحق الوجود من ذاكرة التاريخ قبل إبادته من على أرضه.
هذا تجاهلٌ مقصود لصورة أكثر تعقيدًا من ثنائية “النصر والهزيمة”، صحيحٌ أن السياق العربي العام شهد تراجعًا سياسيًا وعسكريًا، لكن قوى المقاومة، والتحولات التكتيكية، وعمليات الردع، كلها تمثل حالات نصر نسبي، وصمود نوعي، بل واستنزاف متبادل، وهو ما تعترف به التقارير الإسرائيلية نفسها.
هذه الصورة التي يرسم ملامحها المقال المذكور، لا يعترف بها الخطاب الإسرائيلي نفسه، ولا يُقرها عتاة الصهيونية إلا على سبيل الدعاية، وفي سياقات الحرب النفسية، وهم يوقنون أنها ليست الحقيقة بأي حال.
مثل هذا الخطاب لا يقدم معرفة، بل يقدم مشروعًا لتثبيت أركان اليأس، وما أخطر أن يتحول القلم إلى أداة للإحباط لا أداة لاستنهاض الفهم، مهمة الكاتب ليست أن يُخبر الناس بما يهزمهم داخليًا، بل بما يُنير أمامهم الطريق، حتى إن بدأ بالاعتراف بالعثرات.
قديمُا كتبتُ، وما زلتُ أردد ـ لمن يقرأون الوقائع بعين عوراء ـ إن التاريخ ليس سطرًا واحدًا، ولا هو مشهد ثابت، بل مشاهد متعددة، متتابعة، فيه لحظات انكسار، نعم، لكن فيه أيضًا لحظات عبور، لا تحدث فقط، عندما يُرفع العلم على الضفة الشرقية للقناة، بل كلما رُفع العقل فوق التكرار العقيم للهزيمة.
هذا النموذج من الخطاب الذي يرفع رايات الانهزام، ويُنكس أعلام أي انتصار فشا في الأمة العربية منذ هزيمة يونيو 1967، واستقر في كثير من الكتابات، حتى تكونت لدى كثير من الكتاب “عقيدة الانهزام” التي لا يُصرّ أصحابها على التذكير بالهزيمة، بل على تثبيت ما لا يجب أن يُبنى عليه وعيٌ ولا مستقبل.
هذه النوعية من الكتابات التي تتبنى خطاب الانكسار، تُخفي سكينًا داخل وردة، تبدو موضوعية، لكنها منحازة بالكامل للهزيمة كخيار ذهني، تُجيد عدّ الإخفاقات، وتتجاهل أي لحظة مقاومة، أو استرداد، أو حتى صمود.
أخطر ما في هذا الخطاب، أنه لا يُنكر النصر فقط، بل يسلب الناس حقهم في الفخر، وفي استدعاء لحظات الانتصار كجزء من سرديتهم الوطنية.
هذا الخطاب لا يعارض “تزييف التاريخ”، بل يستبدله بتزييف آخر أكثر إحباطًا، يعتمد على فرضية كلية: أن الهزيمة ليست حدثًا عارضًا في تاريخ العرب الحديث، بل هي السردية الوحيدة الممكنة.
هذه الفرضية ليست بريئة، لا تكتفي بكسر صورة الذات العربية، بل تلمّع في المقابل صورة الصهيوني؛ ليبدو كأنه قدَر تاريخي، لا يُهزَم حيث “العرب انهزموا أمام الصهيونية وهي مجرد فكرة، ثم وهي عصابات، ثم وهي دولة، ثم وهي مشروع سلام” في سرد متدرج، لا هدف له سوى إظهار أن الهزيمة ملازمة للعرب في كل الأطوار، والانتصار حليف الصهيونية في كل الحالات.
وهذا الترتيب ـ أيضًا ـ ليس بريئًا، إنه يُحوّل التدرج التاريخي الطبيعي للصراع إلى سردية فشل عربي لا ينتهي.
هي قراءة لا تُجيد التحليل، بقدر ما تُجيد التقاط اللحظات التي تخدم الانكسار النفسي، فالصهيونية لم تكن مجرد فكرة بريئة، بل مشروعًا استعماريًا عالميًا، مدعومًا منذ بدايته من القوى الإمبريالية، وقد فُرض بالدم، والمجازر، والسياسة، والسلاح والمؤامرات، نعم بالمؤامرات..
في المقابل، لم تكن المقاومة العربية، حركة موحدة، بل محاولات متفرقة، وفي ظروف صعبة، أنجزت ما لم يكن متوقعًا.
يكفي أن نذكر، أن العصابات الصهيونية، لم تستطع أن تصمد طويلًا أمام حرب استنزاف بدأت عقب الهزيمة مباشرة، ولا استطاعت أن تمنع العبور المصري في أكتوبر، ولا أن تُجهض انتفاضات الحجارة في فلسطين، ولا أن تبقى في جنوب لبنان، ولا أن تكسر إرادة المقاومة في حرب 2006، ولا تمكنت من كسر شوكة المقاومة الفلسطينية في الضفة، وفي غزة التي ما تزال تقاتل منذ قرابة عشرين شهرًا متواصلة في أقسى وأبشع ظروف، يمكن أن تعمل فيها أي مقاومة للاحتلال في العالم طوال التاريخ.
بدلاً من دراسة ميزان القوى، وتعقيداته، وأدوار الأطراف الدولية، يجري اختزال المشهد إلى ثنائية بدائية: عربي عاجز مقابل صهيوني خارق.
إن هذا التهويم المزدوج، الذي يُجَرِّد العرب من أي لحظة فاعلية، ويمنح الصهيونية هالة القدر الغالب، ليس سوى وجه آخر للهزيمة النفسية.
كتب هنري كيسنجر في مذكراته: لقد فاجأنا المصريون، ليس فقط عسكريًا، بل سياسيًا، فقد فرضوا علينا أن نخرج من موقف المتفرّج إلى موقف المفاوض، وتغيّرت كل قواعد اللعبة في الشرق الأوسط بعد 6 أكتوبر.”
يبدو أن الذين يتبنون “عقيدة الانهزام” لا يريدون لأكتوبر أن يكون مرجعًا للفعل، بل يريدونه أن يُضاف إلى المتحف، تحت لافتة “حدث جيد، لكنه لا يغيّر القصة”.
أخطر حلقات خطاب الهزيمة تتبدى في تجاهل فعل المقاومة، بكل تجلياته، في الماضي والحاضر، وكأن الهزيمة ليست فقط حدثًا تاريخيًا، بل قدرًا يجب أن يبتلع أي فعل نضالي، ويُفرغه من معناه.
يُكتب تاريخ الصراع الطويل ـ منذ كانت الصهيونية فكرة إلى ما بعد الدولة ـ كأن العرب لم يحركوا ساكنًا، منذ النكبة ثم بعد النكسة، لا حاربوا، ولا انتفضوا، ولا فجّروا الحجارة في وجه الدبابة، ولا أسقطوا الطائرات بصواريخ الكتف، ولا كسروا أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، لا في قناة السويس ولا في جنوب لبنان.
لكن الحقيقة، أن فعل المقاومة لم يتوقف وربما صار أنضج بعد النكسة وأكثر تأثيرًا وحضورًا، وأشد تنوعًا، وأكثر احتكاكًا بالعدو وجهًا لوجه، من حرب الاستنزاف، إلى عمليات فدائية في عمق سيناء، إلى مقاومة اجتياح بيروت، إلى صمود الجنوب اللبناني، إلى المقاومة المسلحة في غزة، إلى انتفاضات متتالية في الضفة الغربية.
لن أذكر كل التفاصيل، ولكني أسأل: كيف يمكنك تجاهل هزيمة إسرائيل في حرب تموز 2006، حين عجزت آلة الحرب الأشد تطورًا عن تحقيق هدف واحد من أهدافها؟
كيف بمكنك أن تُغفل ما جرى، وما يزال يجري على مدار عشرين شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى اليوم، تحت نظر وتشجيع وتأييد وإمداد من العالم المتحضر للقتل اليومي والتدمير المكثف، ومحاولات التهجير والتطهير العرقي التي تجري على قدم وساق، والشعب ما يزال صامدًا، ومقاومته ما تزال تقاتل، ولم ترفع الراية “السوداء”، راية الانهزام؟
صدق من قال، إن الخطاب الذي يتجاهل المقاومة ليس محايدًا، بل يضع نفسه- ربما بدون قصد- في خدمة الرواية التي تريد لها إسرائيل أن تسود”.
إنكار فعل المقاومة، ليس حيادًا موضوعيًا، كما يدّعي أصحابه، بل انحيازًا واعيًا إلى سردية الهزيمة، حتى ولو بدا نقديًا، أو تبدى في صورة عقلانية؟
لم تعد الهزيمة “عقدة” عند البعض، بل صارت إيمانًا داخليًا، بأننا لا نُحسن شيئًا، وأن عدونا دائم التفوق، وأن التاريخ يسير باتجاه واحد: هزيمتنا.
وهو تصور يتناقض تمامًا مع حقائق الصراع، إذ إن الكيان الصهيوني نفسه- رغم كل قوته العسكرية والاستخباراتية- يعيش أسوأ أزماته البنيوية، الأمنية، والاجتماعية، منذ نشأته.
وقد نشرت صحيفة هآرتس تقريرًا في عام 2023، جاء فيه: “إن تهديد الكيان اليوم لم يعد من العدو الخارجي فقط، بل من الداخل الممزق، والمجتمع المنقسم، والعجز عن ترميم صورة الجيش بعد إخفاقات متتالية.”
لكي نفهم طبيعة هذا الصراع، لا يكفي أن نبدأ من الخامس من يونيو 1967، ولا من الخامس عشر من مايو 1948، ولا حتى من وعد بلفور 1922، بل يجب أن نعود خطوة أبعد، إلى اللحظة التي تقرر فيها تفكيك العالم العربي وتجزئته، إلى الخريطة التي رُسمتها اتفاقية “سايكس بيكو”، إلى اللحظة التي خُطّت فيها الحدود بالمسطرة، لا بالتاريخ.
العرب، منذ أن خُطّت حدود سايكس بيكو، وهم في معركة دفاع عن الذات: عن وجودهم السياسي، عن سيادتهم، عن أرضهم، عن معنى أن يكونوا “أمة”، لا فرادى في جغرافيا مستباحة.
الصهيونية لم تكن البداية، بل حلقة في سلسلة طويلة من الاستهداف.
والمقاومة، لم تكن رد فعل على ضياع فلسطين فقط، بل على مشروع كامل لتفكيك العرب.
ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف البنادق، ولا الأقلام، ولا القلوب، ولا الإيمان بـ: «انتصار الدم على السيف».
في هذا السياق، فإن أي نكسة ليست أكثر من نقطة انكسار ضمن خط مقاومة طويل، لحظة يجب أن تُفهم في سياقها، لا أن تُحوّل إلى مرآة دائمة نرى أنفسنا فيها منهزمين إلى الأبد.
إن التاريخ- في الأغلب الأعم- ليس ما جرى، بل ما يُروى عما جرى، والهزيمة لا تتحوّل إلى قدر، إلا إذا كتبناها بأيدينا، ولا يُسرَق الوعي، إلا إذا سلّمناه طوعًا، لمن يصوغ لنا روايتنا.
إذا لم نربح معركة السردية، فلن نربح بعدها أي معركة، لأن من يُهيمن على الرواية، يملك أن يُعيد تعريف النصر والهزيمة، كما يشاء.
وفي النهاية، من يربح المعركة، تكون سرديّتُه هي التاريخ.