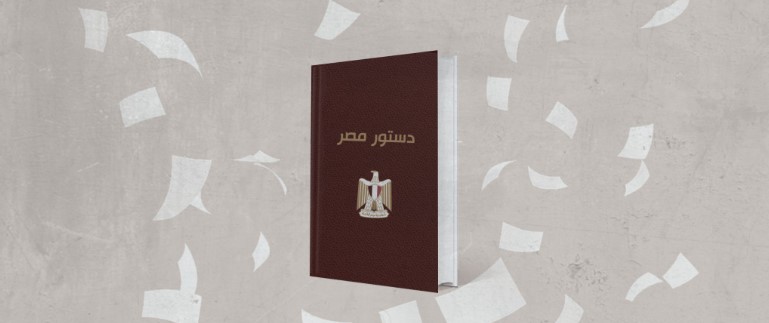من دستور 1923، حتى يومنا هذا في صيف 2025، ومصر تعيش تناقضاً مُبكياً، فهي على الورق دولة دستورية، دولة يسودها حكم القانون، وحكم القانون يسري مفعوله فوق الجميع دون استثناء واحد، بما في ذلك أعلى موقع سياسي في السلطة، هي دولة مؤسسات، والمؤسسات فوق الأشخاص والشلل والمحسوبيات وجماعات الانتفاع، هذا على الورق فقط، لكن في الواقع فإن البنية التحتية للديكتاتورية الموروثة من أحقاب زمنية بعيدة والمتجذرة في بنية العقل والشعور والوجدان الجمعي، بقيت هي سيدة الموقف، بقيت هي الخزان التاريخي الذي يملأ جعبة الديكتاتوريات الجديدة التي نجحت في ممارسة الطغيان تحت مظلة الدستور، مائة عام أو أكثر قليلاً من التحايل على الدستور والالتفاف من حوله وتفريغه من مضمونه، والانتصار لشخص الحاكم؛ ليكون هو بذاته الدستور والقانون من الناحية العملية، يحلفون على احترام الدستور والعمل به، وفي الوقت ذاته لا يتوقفون عن التفلت من ضوابطه وأحكامه، مائة عام والمسيرة واحدة من الملك فؤاد الذي وقع عليه الدستور كالصاعقة، فكيف يتقيد بدستور، وهو مالك البلاد، وكيف يخضع للقانون، وهو سيد الشعب، وكيف يُرَد له حكم، وهو ورث مصر وشعبها عن أبيه إسماعيل عن جده إبراهيم عن جده الأكبر محمد علي باشا، كيف يخضع الملك لسيادة الشعب؟ هذا التحول الذي ترتب على ثورة 1919، كان فوق قدرة السلطان، ثم الملك فؤاد على الفهم والاستيعاب، ثورة 1919 أعلنت ميلاد الشعب المصري كصاحب للبلد ومالك لها، وهو معنى جديد يتصادم مع المستقر لدى الحكام من سلالة محمد علي باشا، أنهم أصحاب البلد وملاكها عن أصالة وجدارة، فقد امتلكها جدهم الأكبر بحد السيف، ولا شيء غير السيف، صحيح أن الباشا جاء للحكم 1805 باختيار المصريين، لكن هذا الاختيار فقط وضعه على أول الطريق، أما البقاء في موقعه هذا رغم أنف السلطنة العثمانية لمدة تقارب نصف قرن، فكان الاعتماد فيه على سيفه ودهائه معاً، بالسيف والدهاء تجاوز الشرعية العابرة التي منحها له المصريون 1805، بل وتجاوز أحلام وآفاق وأبعد ما في خيالات المصريين المعاصرين، وذهب يؤسس إمبراطورية، تكاد تكون هي إمبراطورية تحتمس الثالث 1481 قبل الميلاد- 1425 قبل الميلاد، وقد عاشت هذه الإمبراطورية الأعظم في تاريخ الشرق القديم، حتى 1070 قبل الميلاد، محمد علي باشا- كقائد عظيم- كان قريباً من أفق تحتمس الثالث، أما خلفاؤه فكانوا من الضعف وسوء الإدارة وانحطاط ملكات القيادة، بما يجعلهم في مصاف نظرائهم من القادة القاجاريين الذين أخذوا إيران في طريق الاضمحلال، كما في مصاف معاصريهم من السلاطين العثمانيين الذي أخذوا بناصية الإمبراطورية نحو الانحلال، والحكام الثلاثة في مصر وإيران والأستانة، أفلسوا خزائن بلادهم من سوء التدبير ومن كثرة الديون والقروض، ثم دمروا مناعتها الذاتية، فانفتحت من كل حدب وصوب أمام اختراق المصالح والمطامع والأهداف الأوروبية الخبيثة، هذا هو السياق التاريخي الذي تكونت فيه الحركات الوطنية الحديثة في أهم بلاد الشرق: مصر، إيران، تركيا.
وكان الشاغل الأول لهذه الحركات الوطنية هو الحكم الدستوري الذي يقيد سلطات السفهاء من الحكام، ويحمي المال العام من سوء التدبير، ويغل يد الحكام عن الاستدانة، ويحفظ الأوطان من تسلل المطامع الأوروبية الخبيثة، ولك أن تعلم أن مصر عندما أعلنت إفلاسها، كانت الأستانة قد سبقتها إلى إعلان الإفلاس، كما كان الحال كذلك في إيران وفي تونس، لهذا لم يكن المطلب الدستوري هيناً ولا يسيراً؛ لأن فساد الحكام واستبدادهم في الداخل، تستفيد منه طبقات مقربة منهم، تتمسك بهم وتدافع عنهم، وتحارب أي مطالب بحكم الدستور، كما أن فساد الحكام واستبدادهم في الداخل يتلازم معه ضعفهم وهوان شأنهم ومذلتهم أمام القوى العظمى في الخارج، وهذه القوى العظمى وشعوبها وشركاتها واقتصادها، تكون لها مصالح أكيدة في استمرار ضعف وهوان هؤلاء الحكام، تلعب بهم، وتستبدل أحدهم بالآخر، وتضع يدها على مقادير البلاد وثرواتها، وهؤلاء السفهاء من الحكام إما مغيبون وإما فاقدو الرشد وإما متواطئين، ومن يدرس حكام مصر وإيران وتركيا في القرن التاسع عشر، يقف على حقيقة التشابه التام بين البلدان الثلاثة، ولماذا تزامنت في وقت متقارب دعوات ومطالب الحكم الدستوري.
مصر حالة عجيبة في التاريخ المعاصر: توافق عجيب بين حكامها على عدم احترام الدستور، لا فرق في ذلك بين العهد الملكي والجمهوري، هنا تسقط الحدود، بين من هو ملك ابن ملك، ومن هو ضابط ابن فلاحين وناس بسطاء مساكين، كما هنا تسقط التقسيمات والحدود بين عصر الاستعمار وعصر الاستقلال، كما هنا تسقط الحدود بين عصر الملكية وعصر الجمهورية، كما هنا تسقط الحدود بين عصر الارستقراطية وعصر الجماهير، كما هنا تسقط الحدود بين عصر المصاطب وعصر السوشيال ميديا، كل حكام مصر في المائة عام الأخيرة، المائة عام التي فُرض فيها الدستور والحلف باليمين المقدس على احترام الدستور، كلهم عطلوا الدساتير، وعدلوا الدساتير ولعبوا في الدساتير، كلهم لديهم حنين غريزي جارف وساحق وماحق وسابق ولاحق؛ لأن يحكموا كطغاة جبابرة طلقاء متحررين من أية قيود، يفرضها عليهم الدستور، كلهم سواء ملك أو رئيس جمهورية، أراد نظام حكم على مقاسه وعلى راحته وعلى مزاجه، وكلهم اجتهد في ذلك قدر المستطاع، وكلهم وجد من القوى السياسية ذات المصالح، من يدعمه ويبرر له مسلكه، وكلهم نجح في تشويه وتعويق وتعطيل مسيرة الحكم الدستوري، وكلهم دون استثناء واحد، دفع الثمن وانتهى نهاية مخزية مهينة. فهذا الملك فؤاد، ثم نجله الملك فاروق، لم يدخرا جهداً على مدى ثلاثين عاماً في محاربة الدستور، ومن يناضلون من أجل الدستور تحت راية الوفد وغيره من القوى الوطنية، وكانت الخلاصة هي سقوط الملكية ذاتها وزوالها إلى الأبد، لم تكن لدى الرجلين أدنى بصيرة، لإدراك أن تعميق الحكم الدستوري يضمن احترام الملك، ثم يضمن بقاء الملكية ذاتها. وباتت هذه النهاية المخزية هي قانون الديكتاتوريات المتعاقبة في مصر، بلا فرق بين ملكي وجمهوري.
فقد كان الرئيس عبد الناصر يكتب الدساتير بيده، ويضع نتائج الاستفتاءات الرئاسية بيده ويهيمن- بصورة لم تتوفر لحاكم من قبل- على كل دقائق وتفاصيل السياسة المصرية، بما فيها أنفاس المواطنين وهمساتهم تحت الحائط أو “جوا” الحائط أو خلف الجدران المغلقة، كان عبد الناصر طاغية من نوع مخصوص، يمتاز في تاريخ الطغيان، أنه طاغية محبوب، عاشت معه الجماهير في مصر والعالم العربي أعظم لحظات المجد، يوم أعلن تأميم قناة السويس لينتصر لكافة شعوب المستعمرات في القارات الثلاث ضد أعتى إمبراطوريات الاستعمار الأوروبي، وعاش معه المصريون ملحمة السد العالي التي لا ينجزها غير حاكم من مقاس كبير، وعاش معه الفقراء لحظة إنصاف واحترام واعتراف غير مسبوقة في التاريخ، ثم انتهى ذلك كله بهزيمة مخزية، أثبتت أن هذا الطاغية العظيم الذي كان يعلم همسات المواطنين تحت الحائط و”جوا” الحائط وخلف الجدران المغلقة، لم يكن على علم كاف بحقائق الوضع في أهم مؤسسات الدولة التي انفصل بها المشير عبد الحكيم عامر ورجاله والمتعاطفون معه، عبد الناصر من زاوية الرؤية الاستراتيجية، كان رجل دول موهوباً بالسليقة والفطرة والغريزة، بموهبته يبقى- كان وما زال- في صفوف العظماء مثل محمد علي باشا، لكن الممارسة الطغيانية الزائدة عن الحد والزائدة عن الضرورة، انتهت به مثلما انتهت بمحمد علي باشا إلى نهاية مؤسفة، مع فارق، أن الباشا جاءته الضربة من الطموحات الإمبراطورية المفرطة، بينما عبد الناصر جاءته الضربة من أخطاء تكتيكية، اعترف هو ببعضها أو كلها من عجلة الوحدة مع سوريا إلى حرب اليمن حتى حرب النكسة.
وتتوالى القاعدة ذاتها مع الرئيسين السادات ومبارك، فهما فترة واحدة، مثلما أن عهدي الملكين فؤاد وفاروق فترة واحدة، كلاهما- السادات ومبارك- تلاعب بالدستور؛ ليبقى في السلطة مدى الحياة، وزاد مبارك تقليداً جديداً، وهو تعديل الستور؛ ليتمكن النجل، من أن يخلف والده، وانتهى العهدان بثورة بعضها احتجاج شعبي حقيقي، كان قد سبقه بعشر سنوات؛ استعداد أمريكي مكشوف للتخلي عن مبارك، ثم أنجزها الجيش، بمجرد أن أرسل إشارات واضحة بالتخلي عن مبارك والانحياز إلى الجماهير المحتشدة في كافة ميادين البلاد.
وعلى خطى السادات، ثم مبارك، صارت السلطة الحالية في عملية تعديل الدستور، حيث مددت فترات الرئاسة الي فترة ثالثة.. لتعود مصر الي المربع الأول: الحاكم هو الدستور، وأعاد هندسة كافة مؤسسات الدولة أكثر من مرة، ونجح – كما لم ينجح رئيس من قبل، بما في ذلك الرئيس عبد الناصر- في فرض هيمنة كاملة، بحيث لا تسمع همساً، وعادت مصر إلى المربع الأول: الحاكم هو الدستور، والدستور هو ما يراه الحاكم، والشعب والدولة والمؤسسات تدفع الثمن، وتسدد الفواتير وتتحمل كافة الأعباء.
المعضلة المصرية الكبرى، كانت وما زالت في عدم احترام الحكام للدستور.