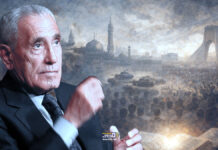التجاوزات الأخلاقية تقومها الأسرة، ويستنكرها الجيران في نميمتهم، والمعصية يحاسب عليها الله، ومخالفة القانون تتصدى لها الدولة.
فكما قال الإمام محمد عبده: “الإيمان الصحيح لا يُفرض بالقوة، وإنما يرسخ بالاقتناع.”
لكن تعالوا نتخيل مؤسسات الدولة تحاسبنا على الندالة، قلة الأصل، انعدام الذوق، التجشؤ أمام الآخرين، أو إخراج الريح أمام الزوجة والأبناء!
أو يعاقبنا القانون على ترك الصلاة أو إفطار رمضان!
فكما يقول أرسطو: “الفضيلة هي وسط بين رذيلتين، وهي عادات مكتسبة بالاختيار.”
أو تخيلوا أن يحاسبنا الله على مخالفات الرادار، والتهرب الضريبي!
إنه الخلط بين القانون والدين والأخلاق الذي ابتلينا به في هذه الأيام التعيسة، مثل ما حدث من القبض على البلوجر ياسمين بتهمة أخلاقية، وذلك الخطاب الإعلامي الذي ربط القضية بكون المتهم “ذكر”، مما كشف ازدواجية في التعامل مع قضايا مشابهة.
إن ارتداء الملابس النسائية في حد ذاته ليس جريمة في القانون المصري، ما لم يرتبط بفعل مجرَّم بنص واضح (مثل انتحال صفة، أو خداع لتحقيق غرض غير مشروع، أو فعل فاضح علني وفق التعريف القانوني الضيق).
هذا يرتبط بمبدأ مهم جدًا في القانون الجنائي اسمه “مبدأ المشروعية”، أو كما يُختصر في القاعدة:
“لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”
أي أنه لا يمكن اعتبار فعل ما جريمة، أو توقيع عقوبة عليه، إلا إذا كان هناك نص قانوني صريح يجرّمه ويحدد عقوبته.
هناك أمثلة كثيرة على أشخاص قاموا بنفس الفعل منهم فنانين نحبهم جميعا مثل:
عبد المنعم مدبولي في أكثر من عمل كوميدي ارتدى ملابس نسائية (في مسرحية ريا وسكينة).
عادل إمام في فيلم حنفي الأبهة وفيلم الواد محروس بتاع الوزير.
محمد هنيدي في جاءنا البيان التالي وفول الصين العظيم.
أحمد حلمي في مطب صناعي.
أحمد زكي في مشاهد كوميدية في البرنس.
الجمهور ضحك وتقبل، لأن السياق كان فنيًا أو تمثيليًا، ولم يجرّمه القانون أو يلاحقه أحد.
إذًا، لو شخص ارتدى ملابس نسائية في حياته الخاصة أو في سياق فني أو ترفيهي، ولم يقترن ذلك بفعل مجرَّم قانونًا، لا يمكن اعتباره جريمة أو معاقبته عليها.
أما عن تهمة “هدم قيم الأسرة المصرية” في القانون المصري فهى تُعتبر من التهم الفضفاضة لأنها:
غير محددة بدقة:
القانون لا يضع تعريفًا واضحًا أو معايير موضوعية، لما هي “قيم الأسرة المصرية”، مما يترك الأمر لتقدير واسع من القاضي أو جهة التحقيق.
قابلة للتأويل السياسي والاجتماعي:
يمكن استخدامها ضد أفعال أو أشخاص لا يتفق معهم المجتمع أو السلطة، حتى لو لم يرتكبوا جريمة بنص محدد.
تصطدم بمبدأ المشروعية:
في القانون الجنائي، يجب أن تكون الجريمة مُعَرَّفة بدقة، وإلا فإنها تخالف القاعدة الأساسية:
“لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد”.
المشكلة في النص الفضفاض هي أنه يسمح بإدخال أفعال كثيرة جدًا تحته، من محتوى على الإنترنت إلى سلوكيات شخصية، حتى وإن لم تسبب ضررًا ماديًا أو اعتداءً على الحقوق.
صحيح أن في بعض الدول، تُحدَّد القوانين الأخلاقية بأفعال محددة (مثل التحريض على العنف أو نشر مواد إباحية للأطفال)، لكن لا يُجرَّم السلوك العام غير المتفق عليه اجتماعيًا إلا إذا أضر مباشرة بالغير.
هذه الحادثة تضعنا أمام سؤال أوسع: ما حدود القانون، وما دور الدين، وأين تقف الأخلاق؟
—
القانون– القاعدة الملزمة للجميع
القانون: هو مجموعة قواعد تضعها الدولة لضبط السلوك وحماية الحقوق. في النظرية، هو محايد ويعامل الجميع بالتساوي، لكن في الممارسة، قد يتأثر بالضغوط السياسية أو المجتمعية أو الإعلامية.
كما قال مونتسكيو: “القانون مثل الموت، لا يستثني أحدًا.”
في قضية البلوجر ياسمين، يُفترض أن تكون المحاكمة وفق القانون وحده، لا وفق الانطباعات المسبقة أو الموروثات الجندرية.
—
الدين– الحكم الروحي والأخلاقي
الدين يقدم منظومة أخلاقية وروحية، تحدد الحلال والحرام، وتوجه السلوك الفردي والمجتمعي. لكن حين يتدخل الخطاب الديني في القضايا، قبل أن يقول القضاء كلمته، تتحول القضية إلى محاكمة دينية شعبية.
كما قال الإمام محمد عبده: “الإيمان الصحيح لا يُفرض بالقوة، وإنما يرسخ بالاقتناع.”
هنا، المشكلة ليست في وجود قيم دينية، بل في استخدامها لإصدار أحكام قبل استكمال مسار العدالة.
وقال تولستوي: *”الدين الحقيقي هو الذي يجعل الإنسان يتغلب على نفسه، لا على الآخرين.”*
—
الأخلاق– المعيار الاجتماعي المتغير
الأخلاق: هي قيم المجتمع وعاداته وتصوراته، عما هو صواب أو خطأ. وهي أكثر مرونة من الدين والقانون، وتتغير بمرور الزمن.
قال أرسطو: “الفضيلة هي وسط بين رذيلتين.”
في حالة ياسمين، الأخلاق العامة التي تداولها الناس والإعلام تأثرت بالنوع الاجتماعي، حيث أُضيف عنصر الصدمة؛ لأن الضحية تصفه الأوراق الرسمية، بأنه رجل، وكأن التهمة في حد ذاتها مرتبطة بصورة “الرجولة” المتوقعة اجتماعيًا.
—
التداخل الخطير بين الثلاثة
حين تختلط حدود القانون والدين والأخلاق، يصبح المتهم محاصرًا بثلاث محاكم في وقت واحد:
1. **محكمة القانون** التي تحدد العقوبة القانونية.
2. **محكمة الدين** التي تصدر حكمًا أخلاقيًا روحيًا.
3. **محكمة الأخلاق** التي تدين اجتماعيًا حتى قبل ثبوت الجريمة.
وهذا الخلط ليس جديدًا في مصر؛ فقد ورثناه من تاريخ طويل لتوظيف الأخلاق والدين كأدوات سياسية، منذ العهد العثماني ومحمد علي، مرورًا بـ”دولة العلم والإيمان” في عهد السادات، وصولًا إلى اليوم.
—
القضية تكشف، أن النقاش لا يدور فقط حول الفعل محل الاتهام، بل حول هوية الفاعل، والخطاب الإعلامي، وحدود تدخل الدولة بين القانون والدين والأخلاق.
ففي دولة القانون الحقيقية، لا تُستعمل الأخلاق كسلاح، ولا الدين كغطاء للانتقائية، ولا الإعلام كمحكمة شعبية.
—
الدولة الحديثة، في أصلها، تقوم على الفصل بين القانون الدنيوي والتصورات الدينية الخاصة، مع السماح للأفراد بحرية المعتقد ما داموا لا يضرون بحقوق غيرهم. لكن في القضايا الأخلاقية، غالبًا ما نجد الخطاب العام يخلط بين القانون والدين، فتُقدَّم القضية وكأنها محاكمة دينية علنية قبل أن تبت فيها المحاكم المدنية.
هذا الخلط يُربك الرأي العام ويؤدي إلى محاكمات شعبية قبل المحاكمات القانونية، ما قد يضر بمبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
—
الأخلاق ليست نصًا جامدًا، بل منظومة قيمية تتغير عبر الزمن والمكان. المشكلة تظهر حين تُفرض تصورات أخلاقية انتقائية على المجتمع كله، أو حين تتحول الأخلاق إلى أداة لتصفية الحسابات أو لإثارة الرأي العام.
والإعلام في هذه القضية لعب دورًا مزدوجًا: من جهة أثار فضول الجمهور عبر العناوين المثيرة، ومن جهة أخرى أطلق أحكامًا قيمية تستبطن أفكارًا عن “كيف يجب أن يكون الرجل”، وكأن الأخلاق هنا مرتبطة بالنوع الاجتماعي وليس بالفعل نفسه.
—
حين تتعامل الدولة مع قضايا الأخلاق من منظور رقابي-قمعي، فهي تقترب من نموذج “الدولة الأخلاقية” التي ترى نفسها وصيًا على سلوك الأفراد في حياتهم الخاصة. أما الدولة المدنية، فهي تضع القانون فوق القيم الشخصية، وتحصر تدخلها في حماية الحقوق والحريات ومنع الأذى المادي أو المباشر، لا فرض الفضيلة بالقوة.
الخلط بين النموذجين يفتح الباب لاستخدام القانون أحيانًا كسلاح سياسي أو اجتماعي، ويُربك حدود الحرية الشخصية.
—
حادثة البلوجر ياسمين تكشف مرة أخرى أن الجدل في مصر – وربما في المنطقة – ليس فقط حول الأفعال محل الاتهام، بل حول هوية الفاعل، وخطاب الإعلام، وحدود تدخل الدولة بين القانون والدين والأخلاق.
كما قال جون لوك: “القوانين وضعت لا لتقييد الحرية، بل للحفاظ عليها.”
المطلوب ليس فقط تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، بل أيضًا إصلاح الخطاب الإعلامي ليكون قائمًا على الحقائق لا الأحكام المسبقة، وعلى احترام كرامة الأفراد حتى في ظل اتهامهم.
ففي دولة القانون، لا يجب أن تتحول الأخلاق إلى ساحة للمزايدة، ولا الدين إلى غطاء للانتقائية، ولا الإعلام إلى محكمة شعبية.
وفي هذا قال مونتسكيو: “القانون مثل الموت، لا يستثني أحدًا.”