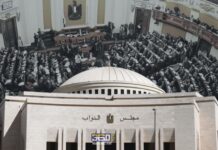في الفترة الأخيرة تم إلقاء القبض على عدد من صناع المحتوى، أو من يطلق عليهم بلوجر، وهو الأمر الذي زاد انتشاره في الفترة الأخيرة، كذلك فقد تم تداول واقعات القبض عليهم عبر العديد من المواقع الإلكترونية والصحف، وإن كانت هناك اتهامات متعددة، تم مواجهة كل من قبض عليها بها، إلا أن أغلب الاتهامات تقع في خانة مخالفة القيم الأسرية.
وهذه الجريمة قد استحدثت بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018، وقد جاء النص على تلك الجريمة في المادة 25 من هذا القانون، والتي تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وقد أفردت المادة 25 من هذا القانون نموذجا متفرداً لتجريم أمور أو أشياء، تخالف وتعاكس المنطق القانوني السليم، وهذه الصفة قد زادت عن حدها في التشريعات المصرية في السنوات الأخيرة، فقد اتسمت التشريعات الجنائية بالتشدد العقابي والتوسع التجريمي الغير مبررين، إذ أنها تعد نموذجاً قياسياً للتوسع في سلطة التجريم، ذلك من ناحية أولية، إذ أن القيم عبارة عن تصورات من شأنها أن تفضي إلى سلوك تفضيلي، كما أنها تعتبر بمثابة معايير للاختيار من بين البدائل السلوكية المتاحة للفرد في موقف ما، ومن ثم، فإن احتضان الفرد لقيم معينة، يعني توقع ممارسته لأنشطة سلوكية، تتسق مع تلك القيم. “فالقيم محددة ومرشدة للسلوك، وهي التي توجه اختياراتنا من بين بدائل السلوك في المواقف المختلفة، وتحدد لنا نوع السلوك المرغوب فيه في موقف ما، توجد فيه عدة بدائل سلوكية، كما يُرى بأن التعدد في مجالات الحياة والسلوك يؤدي إلى تعدد في نظم القيم الموجهة لسلوك الفرد.
ويتضح من النص المُعنوَن بحماية حرمة الحياة الخاصة، أن المُشرِّع قد حدد أربع صور لأشكال الجريمة التي من الممكن أن تُمثِّل انتهاكًا للحق في الخصوصية، وهو ما يعني أن نص المادة 25 “جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية” لا يُمكن تفسيره بأي حال خارج سياق حماية الحق في الخصوصية، التي هي من المفترض، أن تكون الهدف الرئيسي من إقرار ذلك القانون، كما أشارت المذكرة الإيضاحية والتقرير البرلماني المُشترك، وللسياق الخاص الذي تم تناول الجريمة من خلاله، فالفصل الثالث من القانون رقم 175 لسنة 2018، ونص المادة 25 من القانون ذاته مُخصصين بالأساس لحماية الحياة الخاصة، وهو ما يعني أن المُشرع أراد التوسع في صور حماية هذا الحق؛ خشية التطور التكنولوجي وظهور صور مختلفة للأفعال التي قد تكون غير قانونية، والتي التي يصعب حصرها، لذلك جاء نص المادة محتويًا على صور عامة للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتي استخدم المُشرع خلالها لفظ “الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.
وإذ أنه من المعروف، أن أية نصوص قانونية بما في ذلك النصوص الجنائية تُصبُ في قالب لغوي، يحمل المعنى المراد وضعه في شكل قانون، أو أن أي صياغة قانونية فهي لا تخرج في أساسها البنائي عن كونها استخدام للغة في بناء النص القانوني أو القاعدة القانونية، ولكن هل من الممكن استخدام أية طريقة أو أي شكل أو قالب لغوي وقت صياغة التشريع، أم أن للتشريعات وضعية ملائمة لخصوصيتها، فيجب استخدام أنماط معينة من اللغة، وطريقة محددة في التعبير عن القوالب القانونية، لا بد منها حين استخدام اللغة للتعبير عن التشريع، بحسب أنها تُشكل المُخرج النهائي الذي تخاطب به السلطة التشريعية المواطنين، و أن يتم ذلك في أطر محددة، حتى تصبح المعاني القانونية المراد إيصالها للأفراد قاطعة الدلالة، سهلة المعنى، بحيث لا تكون عصية على الفهم، لا تحتمل التأويل لأكثر من معنى، ومن أهم الخصائص المتطلبة في اللغة التشريعية، تكمن في بساطة اللغة التعبيرية للقانون، وأن تكون في جمل بسيطة، وهو ما يعني البعد عن الجمل اللغوية المعقدة أو الطويلة، أو التي تحتمل التأويلات المتعددة أو المتناقضة.
وفي الأصل العام، تقوم كل الفلسفات القانونية العقابية على أساس افتراض البراءة، وأن التجريم وحظر الأفعال هو الاستثناء، كما استقرت جميع التشريعات العقابية على أصل مهم، يتضافر مع تلك الأصول التشريعية، وهو مبدأ عدم جواز معاقبة غير المتهم، وألا يُعاقب المتهم بغير ما اقترفت يداه، وهو المبدأ الذي استقرت عليه معظم التشريعات الجنائية، وأقرته كذلك مجموعة من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مثل ما جاء النص عليه في المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها إن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة، أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا“. وقد سبقت الشريعة الإسلامية الأنظمة الوضعية بعدة قرون في تأكيدها على مبدأ شخصية العقوبة، فقد جاء النص عليها في القرآن الكريم، والذي يمثل أصل التشريع الإسلامي في قول المولى سبحانه: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، وهو ما أُطلق عليه اصطلاحا مبدأ «شخصية العقوبة»، وهو ما عبرت عنه العديد من الأحكام بقولها: الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أُدين بها كمسئول عنها، كما يجب أن تتوازن العقوبة في وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوع الحماية القانونية، مؤمما مؤداه أن شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية متلازمتان. كما أنه تتوجه سياسة التجريم بشكل رئيس إلى حماية المصالح الاجتماعية، والتي تقتضي حماية المجتمع والإنسان من الاعتداء عليه، وتتضمن سياسة التجريم أيضا بيان القيم والمصالح الجديرة بالحماية العقابية، ومنع إلحاق الضرر بها بإهدارها وتدميرها كليا أو جزئيا أو التهديد بانتهاكها؛ لأن الأضرار الجنائية ما هي إلا نشاط مخل بالحياة الاجتماعية، وكل مجتمع يحتفظ بقواعده وأفكاره وقيمه التي تضبط النظام الاجتماعي، فالقواعد الاجتماعية تنظم سلوك الأفراد والجماعات التي تمثلهم، وبعض هذه القواعد تهتم بها سياسة التجريم، فتنقلها إلى قانون العقوبات، وفي هذا الإطار تباشر الدولة وظيفتها الجزائية من خلال تشريعاتها لحماية المصالح الاجتماعية التي تسود المجتمع، وبالتالي وجب عليها أن تختار الجزاء الأكثر صلاحية والأقرب إلى التعبير عن المصلحة المجتمعية. وهذا ما يبين أن هذه الجريمة على النحو المبين في نص المادة المعاقبة عليها لا يتوافق مع السياسات التجريمية أو العقابية المتطورة، أو أسس التشريعات الجنائية.
ونحن هنا فقط نحاول أن نبين للقارئ، أن هناك حدودا يجب مراعاتها عند وضع النصوص القانونية التي تعالج حقوق أو حريات تعود على المواطنين، ولا بد وأن نؤكد أننا بذلك لا ندعم أن تكون هناك تعديات على أية حقوق أو حريات لمواطنين آخرين من خلال ترويج محتوى، أيا كان نوعه، بل فقط يجب أن تتم المعاقبة وفق أسس قانونية تحترم الأساسيات الدستورية الحاكمة لكيان الدولة.