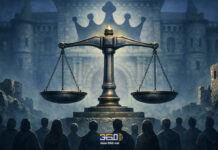ا- مذهب مصر أولا… واللحظة الخليجية!!
وفقا لمذهب مصر أولا القائم على افتراض التناقض أو تباين المصالح بين مصر والدول العربية الأخرى، أو القائم على ما يسمى بخيار الكمون الاستراتيجي لبناء القوة الذاتية المصرية، فلتكن نقطة البدء في هذه السلسلة من المقالات، هي الأمن القومي المصري، بمفهومه الجيوبوليتيكي المجرد من أية اعتبارات أيديولوجية ،سواء كانت عروبية، أم إسلامية…أم حضارية بمعنى ثقافة وقيم الشرق بدوائره المختلفة في مواجهة الغرب، وامتداده الإسرائيلي، وفقا لنظرية صراع الحضارات المشهورة.
يقول لنا التاريخ، إن مصطفى النحاس باشا رئيس حكومات الأغلبية الشعبية في مصر قبل يوليو ١٩٥٢- وزعيم الأمة- حذر الحكومة البريطانية مبكرا، من أن مصر لن تسمح بوجود قوة كثيفة التسلح وجيدة التنظيم على حدودها الشرقية على نحو ما تفعل المنظمات اليهودية في فلسطين.
كان ذلك عقب توقيع معاهدة ١٩٣٦ التي نظمت العلاقات المصرية البريطانية، وحددت مكان وأجل تواجد القاعدة العسكرية البريطانية في البلاد، وأدت إلى تمصير قيادة الجيش المصري، وسحبت من بريطانيا حق الدفاع عن مصر طبقا لتصريح ٢٨ فبراير لعام ١٩٢٢، لتصبح هذه مسئولية وطنية مصرية خالصة، ومن المفهوم، أن هذا التحذير من النحاس باشا وجه إلى بريطانيا بوصفها دولة الانتداب على فلسطين، ولأنها ملتزمة بموجب وعد بلفور، وبموجب صك الانتداب الصادر من عصبة الأمم بإقامة الوطن القومي اليهودي على أرض فلسطين.
من المعروف كذلك، أن مصر شاركت في مؤتمر المائدة المستديرة بلندن لبحث مستقبل فلسطين، في أعقاب الثورة العربية الكبرى هناك عام ١٩٣٦، وكانت الحكومة المصرية وقتها حكومة قصر، (كما كان يقال في ذلك الوقت) برئاسة علي ماهر باشا، ولم تكن جامعة الدول العربية قد تأسست، بل كانت العروبة عند الطبقة السياسية والنخبة المثقفة مجرد مفهوم ثقافي بحت، ولم يكن للعروبة السياسية، وكذلك لم يكن للإسلام السياسي، أثر يذكر في البلاد.
وفي الواقع لم يشذ أي سياسي مصري كبير عن هذا الوعي بالخطر الصهيوني على الأمن القومي المصري، (بغض النظر عن مشاركة لطفي السيد وطه حسين في افتتاح الجامعة العبرية، فهما لم يكونا من كبار الزعماء السياسيين على أية حال، ولذا غلبت اهتماماتهما وارتباطاتهما الثقافية على حسهما السياسي والاستراتيجي).
بالطبع اختلفت رؤى الزعماء المصريين في كيفية مواجهة ودرء هذا الخطر الذي ينمو في شرق بلادهم، ولكن الشاهد هو أن مصر- مثلها مثل أي دولة طبيعية في العالم، وعبر التاريخ كله- أدركت منذ البداية وجوب عدم التساهل مع وجود جيران أقوياء، إلى حد يهدد التوازن الاستراتيجي في الإقليم، حتى لو كان هؤلاء الجيران عربا أو مسلمين، أو بتعبير غير أيديولوجي حتى لو كانوا من الشعوب الأصلية في هذا الإقليم، وليسوا مقحمين من الخارج بقوة الإمبراطورية العالمية المهيمنة وقتها، ومغتصبين لأرض شعب آخر مثل الإسرائيليين، بما يحتم عليهم التسلح الكثيف والاستعداد الدائم للحرب الهجومية باسم الدفاع، والارتباط الدائم بقوة حماية أجنبية، فضلا عن الشهية المفتوحة دائما للتوسع على حساب الجيران، باعتباره من ضرورات الأمن، والطمع في ثروات هؤلاء الجيران.
قلنا فيما سبق، إن الطبيعي لأي دولة في العالم في حجم وموقع وأهمية وتاريخ مصر، ألا تسمح باختلال التوازن الإقليمي على حسابها، وقد كان هذا الوعي مثلا هو دافع الملك فاروق للدخول في حرب فلسطين عام ١٩٤٨، رغم معارضة الحكومة أولا، إذ أن الملك وقتها تخوف من انحسار نفوذ ودور ومكانة مصر وأسرتها المالكة في المشرق العربي، إذا انفردت الأسرة الهاشمية في العراق والأردن وقتها بفضل وفخر إنقاذ فلسطين.
من المهم عند هذه النقطة التأكيد على أن العقيدة الأمنية أو الاستراتيجية المصرية في إسرائيل والمشروع الصهيوني بوصفه تهديدا مستمرا، بقيت سارية وفاعلة، بل وحاكمة، رغم كل النكسات والهزائم، ابتداء من حرب ١٩٤٨، فكانت هذه العقيدة من أسباب استيلاء ضباط يوليو على السلطة عام ١٩٥٢، وكان مبدأ إقامة جيش قوي هو أحد المبادئ الرئيسية لحركة الضباط، كما كانت تلك العقيدة هي السبب الأول والأخير في التوجه إلى الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي للتسلح، أو لكسر احتكار السلاح- كما سميت هذه السياسة آنذاك- عندما امتنع الأمريكيون عن تسليح مصر.
وبرغم هزيمة ١٩٦٧– وليس هنا مجال الجدال حول مقدماتها وأسبابها ونتائجها كمأساة، بل وفضيحة وكارثة وطنية وقومية- فإن مصر رفضت التسليم بالعجز عن الصمود والمقاومة واستعادة التوازن الاستراتيجي، وليس استعادة الأرض فقط، فأعادت بناء الجيش، وخاضت حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، على رأس جبهة عربية موحدة من المحيط إلى الخليج، بالفعل وليس بالشعارات.
وليس هنا أيضا مجال الجدال حول تطورات العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد حرب أكتوبر، وإعلانها آخر الحروب، ثمّ اتفاقية السلام، وخروج أو إخراج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي، إذ أن ما يهمنا في سياق هذا المقال هو، أن العقيدة الاستراتيجية المصرية في إسرائيل كتهديد دائم لأمنها القومي لم تتغير ، ولم تضعف لا على المستوي الشعبي، ولا على مستوى الدولة العميقة، ومن ذلك، ما سماه الإسرائيليون أنفسهم بالسلام البارد، وقرارات كل المنظمات المدنية رفض التطبيع مع إسرائيل لأجل غير مسمى.
ومن الناحية الرسمية، لا بد ألا تغيب عن أذهاننا بعض المواقف المهمة الدالة على رسوخ وعي الدولة العميقة أيضا بالخطر الإسرائيلي، وبالاحتفاظ بإمكانية استعادة التوازن، أو تحدي التفوق الإسرائيلي، عندما تواتي المتغيرات الدولية والإقليمية، ومن هذه المواقف رفض مصر الانضمام للمعاهدة الدولية لحظر إنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية، ما لم تنضم إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، باعتبار أن الكيماوي هو نووي الفقراء، كما هو معروف، وهذه تحسب للرئيس الأسبق حسني مبارك الذي قاوم الضغوط الأمريكية لهذا الغرض، كما قاوم الضغط الشخصي للرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران لحضور مؤتمر باريس لإقرار تلك المعاهدة، كما يجب أن نذكر باعتزاز المعركة العالمية التي قادتها الدبلوماسية المصرية ضد مد معاهدة حظر الانتشار النووي إلى ما لا نهاية، إلا بعد أن تنضم إليها إسرائيل، وبالرغم من أن ضغوط الدول الكبرى أسفرت في النهاية عن تمديد المعاهدة إلى ما لا نهاية، فإن الدبلوماسية المصرية نجحت في انتزاع تنازل مهم، وهو عقد مؤتمر دولي كل خمس سنوات لمراجعة حالة الانتشار النووي في العالم، وفي كل دورة كانت مصر تتقدم بمشروع، يقره المؤتمر بدعوة إسرائيل للانضمام للمعاهدة، و كان هذا الإنجاز ولا يزال دليلا على رسوخ الاعتقاد لدى الدولة المصرية بجدية التهديد الإسرائيلي، وهذه بدورها تحسب لوزير خارجية مصر وقتها السيد عمرو موسى، ولإدارة نزع السلاح بالوزارة، التي كان يرأسها آنذاك السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حاليا.
من الشواهد أيضا في ذلك السياق قصة المشروع الثلاثي المجهض بين مصر والعراق والأرجنتين لإنتاج الصاروخ كوندور، وأخيرا الجهود المستمرة لتنويع مصادر تسليح الجيش المصري، أو بمعنى آخر كسر الاحتكار الأمريكي لتسليح مصر.
غير أن الدلالة الأعمق والأهم هي أن مصر تملك من عمق تجربتها الحداثية ومن الخبرات المؤسسية، ومن ارتفاع المستوى الحضاري الشامل لشعبها (رغم السلبيات الكثيرة منذ بعض الوقت) ما يجعلها مؤهلة دائما للخروج من حالة الكمون أو الحصار أو الاستضعاف.
توالت وتتوالى تلك الشواهد على قوة الوعي المصري المستقر والدائم بالتهديد الإسرائيلي للأمن القومي، في ظل أوضاع عادية أو شبه عادية للعلاقات بين البلدين، بمعنى أن ذلك التهديد لم يكن حالاً، أي لم يكن ماثلا أمام الأعين في التو واللحظة، أو في كل تو ولحظة، كما صارت إليه الأحوال منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يصاحبها من مشروعات إسرائيلية معلنة ومؤيدة أمريكيا لترحيل سكان القطاع إلى دول عديدة بالتهديد والتجويع وبالقتل المباشر، وتأتي مصر والأردن في مقدمة تلك الدول، ويخطط لحالة مصر بالذات إعادة توطين الفلسطينيين المهجرين أو بالأحرى المطرودين بالقوة في إجزاء من سيناء، وكذلك خطط ومشروعات ضم الضفة الغربية لإسرائيل، وتبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا لمشروع إسرائيل الكبرى، التي تضم أراض مصرية أيضا وسط تعهدات متوالية من جانبه بتغيير الشرق الأوسط، وإعادة رسم خريطته، ومع تفويض أمريكي لإسرائيل، بما سماه مبعوث البيت الأبيض في سوريا ولبنان توم براك بتغيير حدود سايكس بيكو حول إسرائيل، كيفما تريد ووقتما تريد.
هنا نحن إذن وجها لوجه ودون مواربة أمام تهديد مباشر لحدود مصر الشرقية، ولهيبتها وكرامة حكومتها، وتهديد غير مباشر لمصر أيضا- كدولة كبيرة في الإقليم- بمزيد من إضعاف وزنها النسبي، وبعزلها عن مجالها الحيوي الجيوبوليتيكي وموارده، ومشروعاته للتكامل الاقتصادي (ولا نقول العمق القومي ولا الحضاري)، وهو أيضا تهديد بمزيد من القوة والهيمنة لإسرائيل، والانفراد بالمشرق العربي سياسيا واقتصاديا، وتهديد باحتكار أولوية المشاركة الرابحة مع دول الخليج بمواردها الضخمة من الغاز والبترول، وبسوقها الاستهلاكية الشرهة، وكل ذلك يحجم مصر ويحاصرها.
في هذه اللحظة جاءت الضربة الإسرائيلية للعاصمة القطرية بذريعة اغتيال قادة حماس، وبعلم الولايات المتحدة أو بعدم ممانعة أمريكية، لتكون أهم نتائجها هي نسف نظرية المشاركة المتساوية بين إسرائيل ودول الخليج، بدءا بالإمارات وانتهاء بالتطبيع مع السعودية، ثم نسف نظرية اللحظة الخليجية في قيادة المنطقة العربية أو النظام الإقليمي العربي على أنقاض القيادة المصرية السورية المتداعية لذلك النظام، تلك النظرية التي استندت إلى غرور الثروة الريعية، والتفويض الأمريكي لأطراف خليجية بالتدخل هنا وهناك لأدوار محددة، مثل إجهاض الربيع العربي، وتمويل شبكات إعلامية وبحثية ضد مبدأ وتنظيمات المقاومة العربية للصهيونية، أو تمويل عملاء في إفريقيا، أو للاتصال بالخصوم لعقد الصفقات مثل دور قطر مع طالبان الأفغانية وحماس الفلسطينية.
طبعا يستحيل تصور قدرة الخليجيين وحدهم- بعد الإفاقة من وهم أو سكرة اللحظة الخليجية لقيادة الأمة- على تحقيق التوازن الاستراتيجي الشامل مع إسرائيل، لأسباب كثيرة أهمها قلة عدد السكان وانعدام العمق التاريخي للحداثة شعبيا وحكوميا، ثم إنهم أصلا لجأوا إلى إسرائيل لموازنة الخطر الإيراني……… فما هو البديل؟
قبل الإجابة يجب أن نتساءل هل الخليجيون جادون في فهم ومواجهة مأزقهم العميق بين إيران وبين إسرائيل والولايات المتحدة من ناحية، ومأزقهم ضمن كل دول الإقليم في مواجهة مشروع إسرائيل الكبرى؟
الإجابة أو الإجابات في مقالنا التالي إن شاء الله.