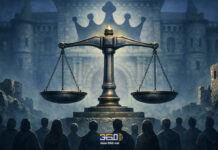وسبب طرح التساؤل من نحن (؟)، أنه هناك من يثير موضوع هويتنا، أهي فرعونية مصرية أم عربية أم إسلامية، كتبرير لاستبعاد قضية من القضايا من أهداف أمننا القومي- وإن كنت أرى، أن وصف إسرائيل بالعدو بلفظ صريح- بعد مرور 47 عامًا على معاهدة كامب ديفيد– وفق ما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر القمة العربية الإسلامية في قطر، قد حسم جانبًا مهما من النقاش.
وعلى أي حال، فإن الحديث المهم والضروري عن الأمن القومي المصري ومسئولياته، يحتاج لاستطراد تاريخي مناسب، لمعرفة أبعاد هويتنا، التي تتخذ ذريعة لتحديد أبعاد نظريتنا للأمن القومي. فرغم أن مصر من أقدم الدول في التاريخ، إن لم تكن الأقدم، إلا أنها فقدت دولتها لمئات السنين، منذ سقوط الدولة المصرية القديمة عام 525 ق.م على يد الفرس، والذين خرجوا على يد اليونان عام 332 ق.م، وبدورهم الرومان هم من أخرج اليونان عام 30 ق.م، واستمروا حتى الفتح الإسلامي عام 641 م.
وقد ذكر مسيو فورييه Fourier، أحد علماء الحملة الفرنسية، في دراسته التي وردت في موسوعة وصف مصر، أن “مصر تشغل بموقعها بين أوروبا وآسيا، وباتصالها الميسور بأوروبا”. ويضيف فورييه: “لم تنشأ قوة كبرى لم ترنُ ببصرها نحو مصر، أو لم تنظر إليها باعتبارها إقطاعية طبيعية بالنسبة لها، كما أن الأحداث الكبرى التي كان لها تأثيرها على تقاليد وتجارة وسياسة الإمبراطوريات، قد صحبت معها الحروب إلى ضفاف النيل، ويمكننا أن نلاحظ أن الفرس واليونان والرومان والعرب والعثمانيين، قد استقروا بمصر بمجرد، أن تفوقوا على الشعوب التي كانت معاصرة لهم”.
ويقول المؤرخ الكبير محمد شفيق غربال في كتابه تكوين مصر عبر العصور: “ولما اعتلى البطالمة والقياصرة الرومان عرش (فرعون)، تفككت عُرى المجتمع المصري، فالمجتمع في الظاهر كما هو، وفي الباطن شيء آخر. فقد استقر الأغراب من الإغريق واليهود في القرى والمدائن هنا وهناك، ومارسوا التجارة، تجارة السلع وتجارة الفكر، ومبادلتها مع البلدان الأخرى، وفقًا لمبادئ غير مصرية. واستُنزفت دماء الأهلين إلى آخر قطرة.. وجاءت المسيحية بشيرة بالخلاص، بشيرة- على الأقل– برفع نير اليأس، ودان لها الحاكمون البيزنطيون، والمحكومون المصريون على السواء، ولكن الفرج لم يأت بعد، فالحكام أجانب، وأجانب لا يستغلون الموارد فحسب، ولكن يعملون أيضًا على فرض مذهب ديني معين، ونظام كنسي معين على الرعية. وانتصر المصريون، فاحتفظوا بشخصيتهم، وشادوا بأنفسهم- ولأنفسهم فقط- صروح الفن واللغة والآداب والكنيسة. ولكن مجتمعهم انتقل من النظام الموحد الذي عرفه آباؤهم، إلى مجتمع يقوم على الطوائف والهيئات: سكان القرى، وسكان المدن والطبقة المتوسطة، والقساوسة والرهبان، تربطهم جميعًا رابطة الدين والتقاليد”. ويضيف الدكتور غربال: “إن المسيحية قد لاءمت في مصر بين خصائصها وخصائص الدين القديم الأساسية، لمدى أوسع مما شهده أي بلد آخر، باستثناء اليونان، فقد أصبح أكثر المصريين عند منتصف القرن الرابع الميلادي مسيحيين”.
من جهة أخرى، يقول الدكتور شفيق غربال: “في عام 640 م غزت جيوش الخلافة الإسلامية مصر، وقطعت العلاقة التي كانت تربطها بالإمبراطورية الرومانية الشرقية، إلا أن العملية التي أصبح بها المصريون مسلمين، يتكلمون العربية، تمت بالتدريج، مع انتشار الإسلام عن طريق اعتناق سكان البلاد المسيحيين الإسلام، إلا أن انتشار اللغة كان أشمل من انتشار الديانة، فأصبحت لغة المسلمين والمسيحيين على السواء”.
ظلت مصر ولاية في الخلافة الإسلامية أو دولة انفصالية عنها، ثم تحولت إلى الحكم المملوكي، فالإمبراطورية العثمانية. وعلى مدى التاريخ، منذ سقوط الدولة المصرية القديمة، لم يسمح للمصري بحمل السلاح أو المشاركة في الحكم. وظل متعايشًا مع هذا الواقع، في ظل الفضاء الإسلامي، منذ القرن السابع الميلادي، وحتى نهاية القرن الثامن عشر. مع قدوم الحملة الفرنسية حيث انطلقت مقاومة شعبية بقيادة مشايخ الأزهر، آلت في نهاية المطاف إلى حكم محمد علي بمساندة المشايخ، لكنه تخلص منهم بعد ذلك، ووضع أساسا لكيان سياسي توسعي، كبحته معاهدة لندن عام 1840، منه انطلقت الحركة الوطنية التي تبلورت من خلالها هوية وطنية، كافحت من أجل استعادة الدولة المصرية.
حاولت ثورة عرابي 1881-1882 وضع أساس لحكم دستوري، لكن الخديوي توفيق استعان بالاحتلال البريطاني للقضاء عليها. ولكن في العقد الأخير من القرن التاسع عشر، انطلقت حركة يقودها شباب الحقوقيين بزعامة مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطني، ويتوازى معه حزب الأمة، وتستمر حتى الحرب العالمية الأولى. وبعدها تنطلق حركة تكوين الوفد المصري بزعامة سعد زغلول لعرض مطالب إنهاء الحماية، ثم نفي سعد زغلول وثلاثة من أعضاء الوفد إلى جزيرة مالطا يوم 8 مارس، لتنطلق ثورة الشعب المصري العارمة في 9 مارس 1919. ولكن قادة الثورة يفشلون في تحقيق أهدافها، بقبول تصريح 28 فبراير 1922، والاعتراف باستقلال شكلي وملكية دستورية بدستور منحة من الملك فؤاد، الذي يعطله ثم يغيره. فيتواصل الكفاح الوطني بموجة ثورية ثانية عام 1935، تنتج عنها عودة دستور 23، ومعاهدة 36. لكن قوات الاحتلال ترفض الانسحاب من قواعدها بالقاهرة والإسكندرية، وفقًا للمعاهدة، فتنطلق موجة ثورية ثالثة عام 1946، وبرغم نجاحها في دفع قوات الاحتلال للانسحاب إلى قاعدة قناة السويس، لكنها انقسمت بين شيوعيين وإخوان مسلمين. ثم جاءت حرب فلسطين عام 1948، والهزيمة وقيام دولة إسرائيل لتضيف بعدًا جديدًا للقضية الوطنية.
وفي المفاوضات الأخيرة بين حكومة الوفد والاحتلال البريطاني، يعلن مصطفى النحاس إلغاء المعاهدة من طرف واحد في أكتوبر 1951، وينطلق الكفاح المسلح، لكن جيش الاحتلال يقوم باعتداء وحشي على مديرية أمن الإسماعيلية في 25 يناير 1952، يقتل فيه خمسين من أفرادها، ويجرح ثلاثين ويأسر الباقي. وفي اليوم التالي، تنطلق أحداث حريق القاهرة، فيطلب الملك فاروق من النحاس إعلان حالة الطوارئ، ثم يقوم بإقالته وحل البرلمان المنتخب. وخلال الستة أشهر التالية يعين ويقيل أربع حكومات. ليقوم مجموعة من شباب الضباط بانقلاب في 23 يوليو 1952، بتولي السلطة.
والجديد هنا، ليس فقط أنهم نجحوا في التخلص من الاحتلال البريطاني فقط، ولكن في رؤية جديدة للعلاقات الخارجية ومدى تأثيرها على المصلحة الوطنية المصرية. وربما إشارة لكتاب صدر عام 1949 لضابطين من ضباط الصف الثاني للثورة، وهو ” كتاب الشرق الأوسط في مهب الرياح” للنقيبين صلاح محمد نصر وكمال الدين الحناوي. مما يبين اهتمام القادة الجدد بقضايا أوسع من العلاقات المصرية البريطانية، والعلاقات المصرية التركية.
هذا بجانب توالي الأحداث بعد ثورة 1952، فبجانب تزايد الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد توقيع معاهدة جلاء القوات البريطانية عام 1954، كانت أمريكا التي ساعدت في التوصل للاتفاق، تتطلع لضم مصر في حلف لمنطقة الشرق الأوسط. بل حضر جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا عام 1953 لهذا الغرض، وعرضه على عبد الناصر، الذي طرح عليه بديلا آخر موجود بالفعل، وهو اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وقد حاول عبد الناصر بالفعل بذل جهود مع القادة العرب، لكنهم لم يهتموا، فلم يكن له وزن بينهم حتى ذلك الحين.
كانت مصر تسعى لتسليح جيشها لدى بريطانيا، ثم لدى أمريكا، ولكن ذلك لم يلق استجابة، بل هاجمت إسرائيل معسكر الجيش المصري في غزة في 28 فبراير 1955، وقتلت نحو 40 من أفراده، بما فيهم قائد المعسكر الرائد أحمد صادق شقيق الفريق أول محمد صادق. وبعد أن ذكر عبد الناصر في خطاب سابق على الاعتداء “نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب”، قال في خطاب لاحق: “لست مستعدًا؛ لأن أبني مصنعا أو مستشفى لتأتي إسرائيل وتهدمه”.
وتصادف أن ذهب لحضور مؤتمر باندونج في إبريل 1955، والتقى برئيس وزراء الصين شو آن لاي، فعرض عليه مشكلة التسليح، فاقترح عليه الاتصال بالاتحاد السوفيتي، وقام بالفعل بدور في الوساطة. فكانت الصفقة الأولى التي عرفت بالصفقة التشيكية. والتي تعد التأسيس الحقيقي للجيش المصري الحديث، فجيش محمد علي قد حَلَّه الخديوي توفيق عام 1882، وقام اللورد دوفرين بتأسيس جيس صغير يدلًا منه، تعداده 6 آلاف وبقيادة إنجليزية مهمته الحقيقية الأمن الداخلي. ولم تصبح قيادته مصرية سوى بعد معاهدة عام 36، دون اهتمام بتسليحه أو تدريبه، وكان الاهتمام فقط بتكوين ضباط لاحتياج الإنجليز لهم في الحرب العالمية. ولذلك عندما دخل الجيش المصري حرب فلسطين، لم يكن مستعدًا لها. فكما جاء في مذكرات كمال الدين حسين في 10 مايو 48، “أنه عندما سأل النقراشي باشا اللواء أحمد المواوي قائد قوات العريش، عن حالة الجيش وإمكانية دخول الحرب، فأجاب المواوي: الجيش لا يصلح مطلقًا للدخول في أي معركة، مهما كانت، ومهما قيل عن اليهود وضعفهم. فالجيش تنقصه جميع المعدات، ولم يتيسر للجيش تدريب ضباطه وجنوده التدريب السنوي الكامل، فأجرى تدريباته بعشر طلقات، بدلًا من مائة طلقة، وليس للأسلحة المساعدة كخدمة الجيش وحدات تكفي لتحريك نصف كتيبة مشاة. والبعثة العسكرية البريطانية وضعت هدفًا للجيش، أن يكون للأمن الداخلي وليس للحرب”.
كذلك يقول الدكتور ثروت عكاشة: “لم تستطع القيادة المصرية، أن تعد نفسها للمعركة في فلسطين، فكانت القوات المشاركة عبارة عن (مجموعة لواء مشاة)، تعاونها بعض الوحدات المدرعة، لأن سائر القوات في الجيش منوط بها حفظ الأمن الداخلي وحماية القاعدة وخطوط المواصلات في أنحاء البلاد. وكانت الذخيرة التي كانت بين يدي الجيش، حينذاك خمسة عشر يومًا للمدافع، وشهرًا للبنادق والرشاشات، وكان نحو ستين في المائة من مركبات الجيش غير صالحة، ولا تفي بمطالب مجموعة اللواء. ووحدات الجيش لم تكن قد شاركت من قبل في مناورات على مستوى مجموعة لواء. وكانت القوات الجوية على حال لم يسمح لها، بأكثر من معاونة مجموعة اللواء، للقيام بأعمال الاستطلاع ومهاجمة الأهداف الأرضية الحيوية، وكانت القوات البحرية ما تزال في بدء نشأتها”.
بعد عقد صفقة السلاح السوفيتية لمصر- والتي اعتبرها نيكسون في كتابه “1999 نصر بلا حرب”، أنها الخرق الأول للحصار الذي أحاط الغرب بها الاتحاد السوفيتي، والمتمثل بسلسلة من الأحلاف- ردت أمريكا على ذلك، بالتراجع عن دعم تمويل مشروع السد العالي. فكان رد عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس، وكان العدوان الثلاثي.
من جهة أخرى، عندما حدثت الثورة على الإخوان وإقصائهم عن الحكم في 30 يونية عام 2013، وترتب على ذلك صدام بين النظام الجديد والولايات المتحدة الأمريكية ووقف المعونة العسكرية، قامت مجموعة من كبار الاستراتيجيين الأمريكيين وهم: صمويل بيرجر، وستيفن هادلي، وجيمس جيفري، ودينيس روس، وروبرت ساتلوف بتقديم نصيحة في تقرير للرئيس أوباما عام 2015. نشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير بعنوان:
” Key Elements of a Strategy for the United States in the Middle East”
جاء فيه “لا يُمكن لأي استراتيجية مُصممة لتعزيز مصالحنا في الشرق الأوسط، أن تُحقق بدون علاقة فعّالة بين الولايات المتحدة ومصر. وقد كانت إعادة الإدارة للمساعدات العسكرية خطوةً صائبةً نحو إعادة بناء علاقة مُتصدعة- علاقة اتسمت بشكل متزايد بموقف مُتحدٍ تجاه الولايات المتحدة. ونحن بحاجة إلى استخدام نفوذ دول الخليج للتأثير على السياسات الاقتصادية لمصر”.
“No strategy designed to bolster the state system in the Middle East is possible without a functioning U.S.- Egypt relationship. While not sufficient, little is possible if we do not repair the relationship. Military-to-military ties must remain a pillar of our relationship, particularly if we want to regain any capacity to influence Egyptian behaviour. The administration’s restoration of military assistance was the right step toward rebuilding a fractured relationship—one that was increasingly defined by a defiant attitude toward the United States. We need not hold back criticism of Egyptian domestic behaviours that we see as wrongheaded and counterproductive, but such positions will be more effective in the context of an ongoing U.S.-Egypt relationship. There is no state system in the Middle without Egypt, and we do not want Egypt to pursue self-defeating policies domestically. We need to use the Gulf states’ influence to affect Egypt’s economic policies”.
*****
من هذا الاستعراض التاريخي يتضح، أنه يستحيل الحديث عن نظرية للأمن القومي لمصر قبل 1954. لأنه لم تكن هناك دولة مصرية أصلًا لمئات السنين. وحتى خلال الـ150 سنة الأخيرة في أعقاب الحملة الفرنسية، بدأت تتشكل حركة وطنية، تشكلت خلالها عناصر الهوية والثقافة الوطنية، وأضافت لمصر نفوذًا جديدا على العالم العربي والإسلامي، يطلق علماء السياسة جيو ثقافي Geo -Culture، وذلك بجانب مركزها الجيو استراتيجي Geo -Strategy المعروف.
هذا من جهة، من جهة أخرى، لم تعد أهداف الدولة في العالم، بعد الحرب العالمية الثانية، تقتصر على الأمن فقط (الأمن الداخلي والخارجي والعدالة)، فقد أضيفت التنمية كهدف ثانٍ للدولة، ومن ثم أصبحت تتفاعل مع كافة عوامل الأمن. فنظرية الأمن القومي هي الإطار الفكري والسياسي، الذي يحدد كيفية حماية الدولة لوجودها ومصالحها الحيوية، في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية. وهي ليست مجرد حماية عسكرية أو حدودية، بل مفهوم شامل لأبعاد متعددة، يمكن تفصيلها كما يلي:
1- البعد الجغرافي/ الاستراتيجي: قناة السويس (شريان عالمي للتجارة)- الحدود الغربية (ليبيا– فوضى وسلاح)- الحدود الجنوبية (السودان، النيل، سد النهضة)- الحدود الشرقية (سيناء، غزة، إسرائيل)- البحر الأحمر + البحر المتوسط (أمن الطاقة والممرات البحرية).
2- البعد العسكري/ الأمني: جيش قوي وحديث + عقيدة دفاعية هجومية عند الضرورة- مكافحة الإرهاب في سيناء وحماية الحدود- تطوير القدرات السيبرانية والاستخباراتية.
3- البعد المائي: نهر النيل وهو مسألة حياة أو موت- إدارة ملف سد النهضة (دبلوماسية + ردع محتمل)- تحلية مياه البحر وإدارة الموارد المائية الداخلية.
4- البعد الاقتصادي: أمن غذائي (زراعة، صوامع قمح، سلاسل إمداد)- أمن الطاقة (غاز شرق المتوسط + طاقة متجددة)- تنويع الاقتصاد (صناعة– تكنولوجيا– خدمات).
تقليل الاعتماد المفرط على الخارج.
5- البعد الاجتماعي/ الثقافي: وحدة النسيج الوطني (مسلم/ قبطي– ريف/ حضر)- التعليم والتأهيل للثورة الصناعية الرابعة- مكافحة الفقر والبطالة لتفادي هشاشة الداخل- تعزيز الهوية الوطنية في مواجهة الغزو الثقافي.
6- البعد التكنولوجي/ المعرفي: بناء قاعدة علمية وطنية- الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الفضاء، والأمن السيبراني- ربط البحث العلمي بالصناعة والإنتاج.
7- البعد الإقليمي/ الدولي: الدائرة العربية: الخليج (أمن النفط ــ العمالة– الاستثمارات)- الدائرة الإفريقية: النيل– القرن الإفريقي– الاتحاد الإفريقي- الدائرة المتوسطية: غاز شرق المتوسط– شراكات مع أوروبا- التوازن الدولي: علاقات مع أمريكا، روسيا، الصين، أوروبا.