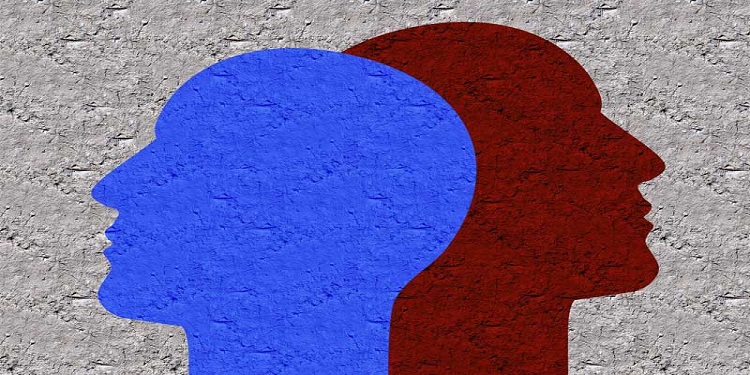“مع من تتحدثين؟”، سألتها.
ردت بهدوء، “مع الله”.
تمتمتُ بصوت خافت، “ونعم بالله”.
وصمتنا برهة.
ثم برفق أمسكت بيدها، وقلت لها، “اتركيه الآن، وكوني معي”.
تململت قليلا.
ففَعلتُ ما اعتدت على فعله منذ عقود عديدة. نظرت في عينيها، أغرس نفسي في مقلتيها، اذُكّرها بوجودي.
“أنا هنا. معك. عودي إلي.”
وهي تأخذ وقتها، تنفر بوجهها قليلا، ثم تعود، ترمقني بتردد، تتحسس ملامح وجهي بعينيها، فيعود الدفء إليهما، وتتذكر.
دائما ما تتذكر.
تعرفني.
ابنتها.
ولأنها تتذكرني. لأنها تعرفني، ولأنها تبتسم لي ابتسامتها تلك الطيبة الطاهرة، أظل إلى يومنا هذا ممتنة.
كل شيء يغيب في الضباب لديها. إلا وجهي.
ووجه أخي. ابنها.
أمي.
لولاها، وقصتها، ما أصبحت نسوية.
قصة طويلة.
كتبتها نثرا في صدى الأنين، وأنا في الواحدة والثلاثين.
وسأكتبه رواية يوما. سيأتي حتما. عندما أفرغ من كتبي البحثية.
مريضة نفسيا. أمي.
ورغم أني تعرفت على مرضها وأنا في الثالثة عشرة من عمري، لم أعتد قط على مرضها.
أقبله. لكني ألعنه في سري. صباحا مساءً.
تعويذة. اعتدت على ترديدها وأنا أنظر إليها، وهي تعوم في الضباب.
خطف مني أمي.
كانت تتركه أحيانا. لعدة شهور، وفي فترة رائعة، عدة سنوات. ثم تنتكس. لتعود إليه. تغيب معه في طيف وراء السحاب. وأنا ألحق بها. أجرى لاهثة. لا تتركيني. أريدها كما عرفتها وأنا طفلة.
تلك التي غرست في حب الخير، وفعله، من أجل الخير نفسه.
لا تنتظري مردودا.
كانت تؤكد علي.
فانتظار المردود يبُطل مفعول الخير.
يجب أن يكون خالصا صافيا لذاته.
كانت لا ترى سوى الخير في الإنسان.
أقول كانت. لأن مرضها اليوم يجعلها تشك في كل من حولها.
إلا أنا، وأخي. الحمد الله على ذلك.
وأبي، كان يسميها بالطاهرة.
لكنه دأب على تنبيهي، أن للإنسان وجوه عديدة. الخير واحد منها.
ولم يغب عني ما يقوله. فالبشر معادن. وإلى اليوم تُدهشني مقدرة الإنسان على الكذب والأذية.
ثم أنى تعلمت منذ صغري ألا أتوقع الكثير من الغير. أتوقع الكثير من نفسي.
وإذا أردت شيئا أسعى إليه، وأفعله لنفسي.
بيد أني لا أنتظر من غيري الكثير.
أليس هذا محزنا؟
ولذا لا يخيب ظني كثيرا. كيف يخيب وأنا لم أتوقع شيئا بدءا؟
هو التخلي الذي يجعلك تسمو، لا تعاليا بل استغناء، وإن كنت في حاجه له راغبا فيه.
وأدركت مبكرا أن طريقتها تريح النفس. فمشيت فيه.
من يتصرف بغير الخير، أو الحب، أبتعد عنه.
غير أني أخذت على نفسي عهدا، ألا أتردد في أخذ موقف واضح، عندما أرى فعلا يؤذي الإنسان.
أسمى الأشياء بأسمائها.
الصمت كان سبب مرضها.
لذا أقسمت على عدم الصمت.
—-
تعلمت إذن أن أعيش معه. المرض.
أتعايش معه.
سمة الإنسان. أن يتأقلم.
وأقبلها هي، كما هي. بمرضها. وأحبها.
يا الله كم أحبها.
ولعلي أتنفسها حبا.
ولذا رغم تعايشي مع المرض، أجدني إلى يومنا هذا أكرهه.
سرقها مني.
عليك اللعنة أيها المرض.
——
قلت لكما أنى أكره مرضها.
لكني لا أخجل منه.
في عمر آخر، كنت أشعر أنى منكسرة به. اليوم أقول بصوت واضح، “أمي مريضة نفسيا.”
ليس في المرض ما يخجل.
لو انكسرت ذراع، سنقول انكسر الذراع.
لو أصيب الجسد بالملاريا، سنقول مرض بالملاريا.
ولو مرضت النفس، نقول مرضت نفسيا.
ليس في المرض ما يخجل، لولا أن مجتمعاتنا تخجل من المرض النفسي والعقلي.
مجتمعاتنا تخجل من المرض النفسي والعقلي.
سمعت عن حالات تخفي فيها أسر أبناءها وبناتها خجلا من المرض النفسي أو الإعاقة الذهنية.
وسمعت عمن يتحدث عن المرض النفسي والعقلي كأنه ابتلاء، يعاقب به الرحمن الإنسان أو ذويه. أو يمتحنهم.
ولو كان الأمر كذلك، لكانت كل الأمراض، التي عرفها الإنسان، بما فيها السرطان والملاريا والكورونا ….، ابتلاءً من الرحمن.
كيف نتصور الرحمن؟ بعبع يستمتع بالأذية؟
كلنا نمرض. كلنا سنموت. هو مسار الحياة. نمرض، نصح، ونموت.
الأمراض وجدت مع وجود الزمن والبشرية.
مثلها مثل كل الظواهر الطبيعية في أرضنا المعمورة.
أما الرحمن، فلا داع لإقحامه في المرض.
أؤمن أكثر بالطب والعلم في إمكانية إيجاد علاج للأمراض التي نعاني منها. أو التخفيف منها.
هما سلاح الإنسان في مواجهة المرض. وكم من أمراض تمكن العلماء والعالمات من دحرها باكتشافهم/ن أدوية ومضادات ولقاحات لها. وجائحة كوفيد لازالت طرية في الأذهان.
لا أقحم الرحمن في الموضوع.
المسألة في الأغلب تتعلق أكثر بجينات الإنسان، واستعداده للمرض، ولذا توقفت عن الغضب من الرحمن.
لا أقحمه في الموضوع.
وكم دعوت لها بالشفاء، ولم يستجب، ورغم ذلك لم يخب ظني.
لأني أدرك أن دعوتي تريحني أنا أكثر من توقعي بمعجزة شفاءها. فالطب ظل إلى يومنا هذا عاجزا أمام مرضها.
ولذا تعايشت مع المرض وأنا ألعنه في سري.
عليك اللعنة أيها المرض.
——
هذا الصيف قضيت أغلبه في رحلة بحثية في بلدين شرق أوسطيين.
ووجدت نفسي مع أمي، حيث تعيش مع خالتي الطيبة الحبيبة، مع رعاية طبية ضرورية.
تنفست الصعداء، لأني تمكنت من رؤيتها من جديد. حرمتني الجائحة العام الماضي من السفر إليها كعهدي كل عام.
لكني عوضت حرماني بصيف عمل. كنت اذهب لعقد لقاءاتي كل يوم، ثم أعود إليها وخالتي.
ورغم صمتها، كنا نتحدث.
كل بطريقته.
وأدركت بقلبي أن تقبيلي لها يُفيقها. فكنت أقبلها على جبينها، خديها ويديها. فترد علي بقبلتين متعثرتين على خديي. يا الله كم أحبك.
ليلة سفري، وعودتي إلى سويسرا، دخلت عليها، وجلست. كنت قد هيأتها لسفري.
وتوقعتها غائبة في الضباب. كعهدها.
لكنها استفاقت فجأة. نظرت إلي وطلبت مني أن أتمدد بجانبها في الفراش.
فعلت كما طلبت.
وجدتها تكلمني. وهي تنظر في عيني. تشكرني. على “كل شيء”.
قالت لي أشياء لم أدرك أنها واعية بها. ووجدتها تدعو لي دعوات من القلب، ولم أنتبه إلى أن الدموع كانت تنهمر على وجهي طوال حديثها، سريعة غزيرة. أذوق ملوحتها حتى وأنا أدون هذه الكلمات الآن.
لحظة. انقشع فيها الضباب عن عينيها، تلمعان، وعادت إلي، أمي، متجلية. واعية. كما عرفتها. تنظر إلي. تحدق في مقلتي، وتحدثني. وتماهينا معا. في تلك اللحظة. معا.
وكما بدأت اللحظة انتهت.
صمتت. ووجدتها تغيب من جديد. أمامي. ككل مرة.
وتركت دموعي تسيل، لا أمنعها. وشكرتها، أمي، من كل قلبي، على تلك اللحظة، على كلماتها، وعلى تجليها.
كأنها أرادت أن تقدم لي هدية وداع قبل سفري.
فأخذتها برهبة، ممتنة، وأقفلت عليها حنايا قلبي.
قبلت يديها، وجبينها، وخديها. وهي ردت بقبلتين متعثرتين على خدي.
وغادرت الغرفة.
عليك اللعنة أيها المرض.
ألف ألف مرة.