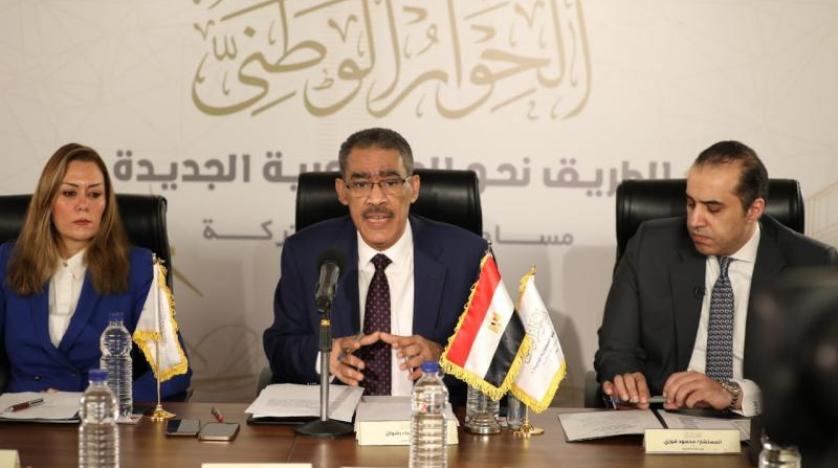لا أبالغ إذا قلت إن قسمًا مهمًا من حماس الشعب المصري للحوار الوطني ومشاركة قواه الحية في تفاعلاته إنما يتوقف إلى حد كبير على المسار العام الذي سيتخذه خاصة على ضوء نتائج جلسات مجلس أمناء الحوار المقبلة والتي ستضع آلياته ومحاوره الأساسية.
وحتى العالم الخارجي الذي تحتاج مصر تفهمه ودعمه في أزمتها الحالية سُيقيم مدى جدية الحوار وتوجهاته بناء على مخرجات اجتماعات مجلس الأمناء والتي بدأت عمليًا الثلاثاء الماضي.
اقرأ أيضًا.. تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني: الإيجابيات والسلبيات
أقول هذا لأنه منذ انطلاق دعوة الحوار نهاية أبريل الماضي، جرت مياه كثيرة تحت جسور الحوار طوقته بمناخ عام، القليل منه إيجابي والكثير منه سلبي، وهذا الكثير أراه يهدد بقسوة فرص نجاح الحوار نفسه.
ولهذا فإن قدرة اجتماعات مجلس الأمناء المقبلة على تغيير العناصر السلبية الموجودة في هذا المناخ وتعظيم العناصر الإيجابية لصالح مستقبل قائم على المشاركة وليس الإقصاء وعلى التوافق الوطني وليس على الاستئثار، هو خط فاصل في فرص نجاح الحوار.
سبب الحوار:
دون التعامل مع الحقائق العارية وبلا مواربة لن يتقدم الحوار نحو غاياته وأهدافه، وأول هذه الحقائق هو الإقرار بأن الدعوة إلى الحوار الوطني بعد ما يزيد عن 8 سنوات من القطيعة بين الدولة والمعارضة كان سببها الرئيسي هو أن مصر تواجه أزمة اقتصادية خانقة زادت منها ولم تنشئها أو تخلقها حرب أوكرانيا، ومن قبلها تداعيات وباء كورونا، وأن قدرة الدولة والحكومة على مواجهتها بعيدًا عن المجتمع وعن المعارضة بات مستحيلًا، وأن الحاجة إلى توافق وطني يتبعه اصطفاف وطني على برنامج للحل يجعل الحوار الخيار السلمي المتاح للإصلاح.
للأزمة الاقتصادية بعد خارجي هو من الحقائق أيضًا، ولا يقل أهمية بسبب تبعية الاقتصاد المصري واعتماده المفرط على العالم وليس على التنمية المستقلة. وهو نفسه يقود أيضًا إلى حتمية الحوار، فالدول الغربية لا تتحمل هز الاستقرار في مصر أو أن تتحول أزمتها الاقتصادية إلى مصدر توتر اجتماعي، خاصة وأن الحاجة الجيوسياسية إلى مصر والعالم العربي صارت أساسية في الحشد الأمريكي العالمي لهزيمة روسيا في هذه الحرب.
بعبارة أوضح يريد الحكام في الغرب الحصول على الحسنيين، الأولى هي مساعدة دولة صديقة ومحورية في منطقة مصالح حيوية في العالم، والثانية عدم تعرضهم عند تقديم هذه المساعدة لهجوم حاد من الإعلام الغربي ومنظمات حقوق الإنسان في بلادهم والمجتمع الدولي، ومن شأن انطلاق حوار وطني وتخفيف القيود على المعارضة والإعلام والإفراج عن سجناء الرأي في مصر مساعدة الغرب وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الموافقة دون حرج على طلبات مصر لقروض جديدة لسد الفجوة الدولارية الهائلة.
المشكلة الحقيقية هي أن هناك من حاول الالتفاف حول هذه الحقيقة لكي يعطي انطباعًا أن الحوار منحة وليس واجبًا، وأن فكرة التفاوض وتقديم تنازلات وتعديلات في سياسات وأولويات قائمة هو أمر غير وارد، وقد حاول ذلك عبر مجموعة من المداخل كلها للأسف لا تساعد على حوار صحي ومتكافئ.

المدخل الأول
يمكن وصفه بحالة “الإنكار”، أي رفض الاعتراف بأن هناك أزمة أصلًا وأننا في أفضل حال، وهذا حال بعض أحزاب الموالاة وبعض الإعلام، وفي حديث هؤلاء أنه إذا كان هناك من أزمة فهي إخفاق الإعلام في الترويج والتوعية الكافية بما تحقق من عمل شاق في الفترة الماضية. هذا الإنكار يمتد إلى قول آخر غير حقيقي يزعم أن مصر وهي تقرر الحوار لم تضع في حسبانها أي عوامل أو قوى خارجية ستتأثر مواقفها من دعم القاهرة بوجود انفتاح سياسي وحقوقي يوحي أو يبشر به الحوار الوطني.
يمكنك التعرف على تجذر هذا المدخل من رد الفعل القاسي على تصريحات محلل اقتصادي ليبرالي هو هاني توفيق، لمجرد أنه وضع بوضوح صارم وعبر أرقام وأحصائيات محايدة أبعاد الأزمة، أو من حالة السخرية من تيار اليسار كله لأنه يعيد طرح سياسات تقييد جوهري للواردات وتصنيع وطني بدلًا منه يقوم على إحلال الواردات والتصدير للخارج.
المدخل الثاني:
هو مدخل «التعميم» الذي وإن كان يعترف بالأزمة بشكل صريح إلا أنه يبعد الرأي العام وصناع القرار عن معرفة أصل الأزمة، وبالتالي يبقيه بعيدًا عن إمكانية حلها من الجذور ويمنع تكرارها في المستقبل.
هذا التعميم وضح في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي انعقد في شهر مايو الماضي وفي تصريحات وزراء الحكومة وتعليقات البرامج الإعلامية ومفادها بأننا بخير وأننا كنا نسير في الطريق الصحيح لولا أن دهمنا العالم بحرب أوكرانيا فتأثرنا بها مثلما تأثر بها بقية العالم.
هذا المدخل في أكثر التقييمات إنصافًا لا يمثل إلا نصف الحقيقة ونصف الحقيقة مضلل كما هو معروف، فالحقيقة تقول إن هذه الأزمة بحذافيرها هي أزمة دورية خانقة تتكرر بدون أي تغيير له قيمة -اللهم إلا ربما في الزيادة المضطردة في أرقام الديون وعبئها وفي تدهور قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية- قد حدثت أربع مرات على الأقل منذ سياسة الانفتاح الاقتصادي.
سبب الأزمة الحقيقي باختصار أرجو ألا يكون مخلًا هو الاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد المصري في الأربعة عقود ونصف الأخيرة التي تجعله «هشًا» أمام المتغيرات الخارجية إذ يعتمد نموه على 4 موارد عملات حرة متقلبة لا تخضع لأي سيطرة وطنية عليها «تحويلات المصريين في الخارج، البترول والغاز، السياحة، عائدات قناة السويس»، في وقت أُهملت فيه القطاعات السلعية من صناعة وزراعة فصرنا نستورد ضعف ما نصدر.
وبالتالي فإن مصر تعاني من عجز مزمن في ميزانها التجاري -تستورد بالعملة الصعبة أكثر مما تصدر- وبالتالي تقترض من الخارج عملات صعبة لسد هذا العجز، ولهذا فإن دينها الخارجي والمحلي أيضًا تتزايد أعباء فوائده وأقساطه لتلتهم كل إيرادات الدولة الحالية فتعود مجددا وفي دائرة مفرغة لاستدانة قروض جديدة لتمويل الإنفاق العام.
والسطر الأخير هو الذي يرد علي فكرة أننا تأثرنا كما تأثر باقي العالم فالواقع يقول أن تضرُرنا كان أكثر من تضرر باقي الدول، وأننا رغم بعدنا آلاف الأميال عن الحرب كنا أكثر اقتصاد أصابه الأذى، وهذا هو بالضبط ما يقود إليه بشكل دوري اقتصاد «ريعي» تم تأسيسه منذ السبعينيات على حساب الاقتصاد الإنتاجي.
المدخل الثالث الذي يخلق بيئة سياسية غير مواتية لحوار جاد حول حقائق وليس حول تهويمات هو مدخل «التبرير»، فهذا المدخل كذلك يعترف بقوة الأزمة ولكنه يهرب مرة أخرى من مواجهة أسبابها الحقيقية، هذا التبرير يضيع الوقت الثمين لمواجهة جادة مع الأزمة في إلقاء المسؤولية على مرور مصر بثورتين وما يسميه بالفوضى بعدهما وبسبب فشل النظم السابقة في مواجهة تحديات التنمية والبنية التحتية والتركة الثقيلة التي تمت وراثتها، وفي كل ذلك بعض ما يستحق المناقشة ولكنه لا يصلح أبدا للتعامل مع أزمة دورية تصيب الاقتصاد المصري بسهولة كما يصيب المرء «دور البرد» في كل شتاء.
المدخل الرابع:
وهو اقتراب «الاعتراف المتأخر في بكاء غير مفيد على اللبن المسكوب»، مثل الاعتراف المتأخر لأعضاء في الحكومة -لما بح صوت الاقتصاديين الوطنيين في الصراخ به عقودًا دون أن يلتفت إليهم أحد- بأنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة في التنمية وأنه لابديل عن الصناعة والزراعة والاعتماد على الذات إذ هرب نحو 20 مليار دولار من مصر خلال أسبوعين فقط بعد الأزمة.
الدليل على أن الاعتراف جاء مجرد محاولة لسد أفواه المتخصصين الذين رفضت نصائحهم من قبل وتهدئة وامتصاص الانتقادات، هو أن الموازنة الجديدة التي أقرها البرلمان والتي يفترض أن تكون بداية لمواجهة الأزمة لم تتضمن انتقالًا في التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، وهو ما جعل نوابًا في أحزاب ليبرالية وليست يسارية مثل الحزب المصري الديمقراطي منهم النائبة مها عبد الناصر يرفضون الموازنة بغضب وأسى لأنها لا تتضمن أي تغيير في سياسة إهمال القطاع الإنتاجي السلعي في الصناعة والزراعة، أي أن الموازنة تتنكر لاعتراف حكومي صريح وتعيد الدوران في نفس السياسة المنتجة للأزمة في الـ48 عامًا الماضية دون جدوى.
في الجزء الثاني من هذا المقال نناقش باقي المداخل المعاكسة للحوار الوطني وكيفية التعامل معها.