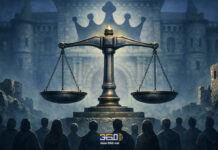قبل أن تقرأ عزيزي القارئ أول مقال في هذه السلسلة، أحب أن أوضح دوافعي وراء كتابتها. فقد كان السؤال الذي ألحّ علي كثيرا بعد محرقة غزة هو: ما هي البنية العميقة التي تجعل مثل هذا العنف الجماعي ممكناً؟ فقد تملكني شعور مؤلم بالعجز عن إيقافها، امتزج بأن البشر جميعا مع هذه البنية ليسوا محصنين منها، وأن العنف دوار، وقد يكون سمة لصيقة لهذا القرن كما كانت في القرن الذي سبقه.
في هذه السلسلة من المقالات، نتجاوز الوصف السطحي لـ”الشر”، وننغمس في تشريح الآليات الهيكلية والنفسية لـ”صناعة التوحش”، الهدف ليس إدانة الفعل فحسب، بل فهم كيفية صنع الفاعلين للقتل الجماعي.
المقالات الأربعة التي تضمها هذه السلسة، تبحث في الجذور المشتركة للإبادة والقتل الجماعي، متتبعة خيطا رفيعاً يربط بين الدوافع المبتذلة للناس العاديين، وبين أقصى درجات العنف، لنكشف كيف أن الانغماس في العنف الجماعي لا يقتصر على وحوش استثنائية، بل يُصنَع اجتماعياً من خلال بنية تحتية أيديولوجية ونظامية، تستفيد من دوافع تبدو “عادية”، مثل المصالح المادية، والتقدم الوظيفي، والضغط الاجتماعي، بينما يتم في الوقت نفسه تحييد القدرة الأخلاقية عبر آليات نفسية وبنيوية محكمة.
سنستكشف دور مفاهيم مثل “إزاحة المسئولية”، و”نزع الإنسانية”، و”اللغة الملطفة” في تعليق القيود الأخلاقية لدى الأفراد، مما يسمح لهم بالمشاركة في مشاريع التدمير الكبرى.
إن فهم هذه الآليات عالمية الانتشار- من معسكرات الإبادة إلى عنف السجون ومعسكرات الاعتقال- هو خطوتنا الأخيرة نحو تفكيك الجذور البنيوية للعنف في عالم ما بعد غزة، وإضاءة الجانب المظلم من السؤال: كيف يمكن للبشر العاديين، أن يفعلوا شراً شديداً؟ وكيف يمكن لبُنى السلطة وهياكل الاقتصاد، أن تنتج هذا الحجم من التوحش؟
تصنيع الوحوش البشرية: تعريف الآخر كتهديد
إن ظاهرة القتل الجماعي، التي أسفرت عن مقتل ما يتجاوز الملايين في القرن الواحد والعشرين، والذي لم نتجاوز حتي الآن ربعه الأول، وما بين ثمانين مليون ومائتي مليون إنسان في القرن العشرين، تشكل لغزاً عميقاً: كيف يبدأ البشر العاديون، ويشاركون في ويدعمون الفظائع ضد الرجال والنساء والأطفال العزل؟
لقد أثبتت الدراسات العلمية بشكل قاطع، أن مرتكبي هذه الجرائم نادرًا ما يكونون مرضى نفسيين أو ساديين أو أفرادا يتملكهم الغضب الأعمى؛ بل إن القتل الجماعي هو في العادة “فظاعة سياسية”، ينظمها ويدعمها “أناس عاديون”. إن الإجابات الفعّالة على كيفية حدوث هذا العنف المنظم، يجب أن تُحلل دور الأيديولوجيات- التي تُعرّف على نطاق واسع، بأنها رؤى عالمية سياسية مميزة، تُوجّه الفكر والفعل- في صناعة “العدو” أو “الآخر”. كما يجب أن نشير في هذا التحليل لطبيعة الدولة الحديثة التي ادعت احتكار العنف المشروع، لتعيد استخدامه بكثافة ضد مواطنيها أو ضد جموع من البشر خارجها.
إن عملية خلق هذا “العدو المميت” متجذرة بعمق في الهندسة السياسية والنفسية، حيث يتم بناء العدو كتهديد وجودي للهوية الإنسانية والأمن والنقاء العرقي. تعتمد هذه الصناعة بشكل كبير على نزع الصفة الإنسانية، وتحويل المجموعة المستهدفة إلى “وحوش بشرية”، لا ينبغي القضاء عليها فحسب، بل يُعتبر ضرورة استراتيجية وأخلاقية.
ستشرح هذه المقالة بالتفصيل، كيف يحدث هذا البناء، وتدرس الأدوار الأساسية التي تلعبها الدولة والأيديولوجية والقومية العرقية.
أولاً: الأسس الأيديولوجية: تعريف “الآخر” كتهديد
الأيديولوجية هي أحد المحاور الرئيسية لتفسير أسباب وقوع عمليات القتل الجماعي، وتحديد من هو المستهدف، ومنطق العنف المستخدم، وكيفية تنظيم القتل وإضفاء الشرعية عليه علنًا. إن الأساس الأيديولوجي الحاسم للقتل الجماعي لا يكمن عادةً في الطموحات الطوباوية أو الكراهية غير العادية، بل في استغلال الأفكار الاستراتيجية والأخلاقية التقليدية وتطرفها، وخاصة تلك المرتبطة بالأمن والحرب والنظام السياسي.
تعريف الأيديولوجيا
تُفهم الأيديولوجيات، عندما يتم تعريفها على نطاق واسع، على أنها وجهات النظر السياسية المميزة للأفراد والجماعات والمنظمات، والتي توفر مجموعات من الأفكار التفسيرية والتقييمية المستخدمة لتوجيه الفكر والعمل السياسي.
يرى هذا المفهوم، أن الأيديولوجيات هي سمات شائعة وعادية للحياة السياسية، مما يعني أن معظم الناس والمجموعات والمنظمات تعتمد عليها لفهم بيئاتهم السياسية وحشد العمل الجماعي وتنسيقه ودعمه.
يتناقض هذا المفهوم الواسع مع التعريفات الأضيق التي تصور الأيديولوجيات كأنظمة اعتقادية متسقة بشكل صارم، تتميز برؤى مفصلة لنظام اجتماعي مثالي أو أهداف “طوباوية”. يرفض الرأي العام الافتراض القائل، بأن الأيديولوجيات يجب أن تتجاهل بشكل صارم المخاوف العملية مثل السلطة أو الأمن أو المصلحة الذاتية لصالح المثل العليا النهائية.
وتشمل الجوانب الرئيسية للتعريف الواسع ما يلي:
• الأطر التفسيرية والتقييمية: تقدم الأيديولوجيات روايات ومعتقدات واقعية مزعومة حول العالم، بالإضافة إلى التفضيلات والقيم والمثل العليا الأساسية. إنها أنظمة أفكار، تربط بين فهم كيفية عمل العالم والمبادئ الأخلاقية والمعيارية التي توجه العمل الفردي والجماعي.
• أشكال التعبير: تأتي الأيديولوجيات المحددة على نطاق واسع في أشكال عديدة: عقائدية أو برجماتية، منهجية أو غير مكتملة، مهيمنة أو متمردة، دقيقة أو مشوهة. تُعتبر هذه الأنظمة “أنظمة فكر سياسي، سواءً كانت فضفاضة أو جامدة، مقصودة أو غير مقصودة، يبني الأفراد والجماعات من خلالها فهمًا للعالم السياسي الذي يعيشون فيه، ثم يتصرفون بناءً على هذا الفهم”.
• التأثير على الفعل: بهذا المعنى الواسع، فإن التأكيد على أن الفعل “أيديولوجي” لا يعني بالضرورة دوافع عقائدية أو مثالية؛ بل إنه يؤكد أن الدوافع والمبررات متجذرة بشكل أساسي في مجموعات مميزة من الأفكار حول السياسة، والتي بدونها لا يمكن فهم الفعل بشكل صحيح أو تفسيره سببيًا.
الواقع النفسي: يُعتبر هذا النهج الواسع أكثر اتساقًا مع علم النفس المعاصر، إذ يُدرك أن الناس نادرًا ما يلتزمون بهياكل معتقدات منهجية للغاية. بل تعمل الأيديولوجيات كـ”مزيج أكثر فوضوية من النصوص الثقافية، والنماذج العقلية، وأطر المعنى، والروايات عن العالم، والقيم العاطفية”، والتي مع ذلك مُنَمَّطة وذات عواقب.
يسمح المفهوم الواسع بفهم أن الأيديولوجيات منتشرة وذات صلة بجميع الجهات الفاعلة السياسية، على النقيض من الرأي المحدود القائل بإن “المؤمنين الحقيقيين” فقط هم أصحاب الأيديولوجيات. كل جماعة منظمة تشارك في العنف السياسي، على سبيل المثال، تعمل على أساس أيديولوجية. إن الأيديولوجية، في هذا الإطار الأوسع تؤثر بشكل حاسم على التفكير الاستراتيجي، وتشكل تصورات التهديدات، وتحدد تقييمات السياسات المناسبة والفعالة لمعالجة تلك التهديدات.
والأيديولوجية المتشددة، ترى العالم يحتوي على العديد من الأعداء الخطرين الذين يعملون غالبًا من خلال مجموعات “مدنية” مزعومة. يتجلى هذا المنظور المتشدد في عقيدة أمنية أيديولوجية تحدد ثلاثة عناصر أساسية: النظام السياسي الذي يجب تأمينه، والتهديدات المحتملة الرئيسية لهذا النظام، والطابع الأخلاقي المقبول للعنف اللازم للدفاع عنه. هذه العقائد إقصائية، وتصور باستمرار بعض المجموعات الاجتماعية على أنها تقع خارج المجتمع السياسي الرئيسي.
يتطلب تصنيع العدو من المجموعة المهيمنة- بمساعدة النخب السياسية والثقافية في كثير من الأحيان- تحديد ما إذا كان من الممكن ظهور “سردية مبررة للقتل الجماعي” قادرة على ربط تحالف الجناة واستدامته. تشكل هذه الرواية بشكل أساسي كيفية إدراك العنف، مما يجعل الأفعال المتطرفة، تبدو مبررة استراتيجيًا وأخلاقيًا.
باختصار، الأيديولوجيات: هي آليات قوية تقنع الجهات الفاعلة برؤية العنف الجماعي كوسيلة ضرورية للدفاع عن النظام السياسي ضد أولئك الذين يُعتبرون تهديدات سامة.
الدولة كمورد نهائي
دور الدولة في خلق العدو بالغ الأهمية. فالدول، وهي أسوأ مرتكبي جرائم القتل الجماعي، قادرة على ترسيخ أفكار متشددة في مؤسساتها وأعرافها وخطاباتها، مما يخلق بنية تحتية أيديولوجية. وعندما تصبح الأيديولوجية راسخة في بنيتها التحتية، فإنها تولد ضغطًا هيكليًا، يجبر الأفراد على الامتثال لمطالبها، حتى لو لم يؤمنوا بصدق بمبادئها.
تمارس الدولة سلطتها من خلال المبادرة إلى سياسات العنف وتفويضها وتنظيمها. إن هذا الفرض من أعلى إلى أسفل يشكل تصورات النخبة، مما يضفي الشرعية على اختيار القتل الجماعي كاستراتيجية قابلة للتطبيق، وخاصة في أوقات الأزمات السياسية. حتى عندما تكون النخب غير ملتزمة أيديولوجيًا، فإن الهياكل الأيديولوجية للمؤسسات السياسية السائدة مهمة، حيث تحدد معايير ما يُعتبر “قانونيًا” أو “شرعيًا” أو حتى “ضروريًا”. إن سلطة الدولة في منح السلطة والشرعية قوية للغاية، لدرجة أن “الطاعة للسلطة” غالبًا ما تصبح دافعًا أساسيًا للمشاركة بين الجناة من ذوي المستوى البيروقراطي المنخفض.
في جوهرها، توفر الدولة الإطار القانوني والمعياري الذي يعيد تعريف، ما يشكل السلوك الأخلاقي. من خلال التحكم في إنشاء القانون وتنفيذه، تُرسّخ الدولة نفسها، باعتبارها الحكم الوحيد على الشرعية، وتُعرّف الجريمة والانحراف. تسمح هذه القدرة للدولة بتعريف فئات مدنية معينة، على أنها إجرامية أو تخريبية أو خارجة عن نطاق الالتزام الأخلاقي، مما يضفي الشرعية على العنف العقابي أو الوقائي.
ثانيا: سيكولوجية الإقصاء: نزع الصفة الإنسانية وصناعة الوحوش
إن نزع الصفة الإنسانية هو الخطوة النفسية الحاسمة التي تسهل ارتكاب الفظائع من خلال تحويل “الآخر” المحدد إلى “وحش”، يكون تدميره مقبولًا أخلاقيًا أو إلزاميًا. إن نزع الصفة الإنسانية، كموقف، هو فعل تصور الآخرين كمخلوقات دون البشر. غالبًا ما تكون هذه المخلوقات حيوانات غير بشرية (القمل، والفئران، والقردة) أو كائنات خارقة للطبيعة (الشياطين، والوحوش).
إن نزع الصفة الإنسانية يعمل كأداة قوية لتبرير العنف والقمع من خلال تعطيل الموانع القوية التي يمتلكها البشر ضد ارتكاب العنف ضد جنسهم البشري بشكل انتقائي. ويتم تحقيق ذلك من خلال عملية فك الارتباط الأخلاقي التي تزيل الضحايا من “عالم الالتزام” للجاني، حيث الالتزام هو المجال الذي تطبق فيه القيم الأخلاقية والعدالة.
ويتم تحقيق ذلك من خلال نشر ثلاث آليات تبريرية رئيسية، تتعلق بهوية الضحية:
1. إزالة الهوية: تتضمن هذه الآلية إنكار أو قمع روابط الهوية المشتركة بين الجناة والضحايا، والتأكيد على انفصالهم عن المجتمع الأخلاقي ذي الصلة للمجموعة الداخلية. وهذا يزيد من “المسافة الاجتماعية” بين المجموعات، ويؤدي إلى تآكل التعاطف. إن الشكل الأكثر تطرفًا لإلغاء الهوية هو التجريد الجسدي من الإنسانية، حيث يُوصف الضحية، بأنه يفتقر إلى الإنسانية المشتركة، مثل وصف التوتسي في رواندا بـ”الصراصير” (inyenzi) أو اليهود بـ”الحشرات” أو الفلسطينيين بالحيوانات.
2. بناء التهديد: يتم تصوير مجموعة الضحايا، على أنها تشكل تهديدًا وشيكًا وغالبًا وجوديًا لمجموعة الجاني، مما يحول أي عنف إلى عمل من أعمال الدفاع عن النفس أو الحفاظ عليها. غالبًا ما يبالغ هذا البناء في تقدير التهديد- حتى الجماعات المدنية غير المسلحة، يتم إعادة تعريفها، على أنها أعداء عسكريون. على سبيل المثال، صوّر النظام النازي اليهود، على أنهم خطر بيولوجي خبيث وجزء من مؤامرة دولية، تتطلب القضاء عليهم للدفاع عن المجتمع السياسي، كما تم تصوير أهل غزة، باعتبارهم كلهم متطرفين أو ينتمون إلى حماس لتبرير القتل الجماعي.
3. نسب الذنب: يتم اتهام الضحايا بارتكاب جرائم شنيعة في الماضي أو الحاضر، مما يجعلهم أهدافًا مشروعة للعقاب أو الانتقام. هذه الصفة تسلب الضحية الحماية الاجتماعية والمؤسسية، مما يسمح بمعاملته كـ”مجرم” أو “أعداء الشعب” أو “خونة”.
ومن خلال الاستخدام الفعال لهذه الآليات النفسية، يعمل الإطار الأيديولوجي على تأطير المشاركة، باعتبارها ضرورة للحماية الجماعية. يتم إعادة تعريف فعل القتل، ليس باعتباره جريمة قتل، بل باعتباره واجبًا شجاعًا أو جديرًا بالثناء مرتبطًا بفضائل مثل الوطنية والولاء والانضباط، مما يجعله يبدو مشروعًا وحتى بطوليًا.
خلق الوحش البشري
الأمر الحاسم هو أن نزع الصفة الإنسانية غالبًا ما يؤدي إلى خلق وحش- وهو كائن يُنظر إليه، على أنه مرعب وغريب، ويشكل تهديدًا ميتافيزيقيًا. يحدث هذا لأن الجناة غالبًا ما يكون لديهم حالة ذهنية متناقضة: فهم يتصورون الضحية، على أنها إنسان ودون الإنسانية في نفس الوقت.
منطقيًا، من المستحيل أن يكون الكائن إنسانًا بالكامل وأقل من إنسان بالكامل، لكن علم النفس البشري غير مقيد بالمنطق. إن هذه المفارقة مستمرة؛ لأن العقل يحجب التمثيلات المتناقضة: التصنيف الإدراكي للضحية على أنها إنسان يتعايش مع التصنيف الفكري لها، على أنها دون البشر، والذي غالبًا ما يتم اكتسابه من خلال الاحترام للسلطات الأيديولوجية. عندما يعجز العقل عن التوفيق بين هذين المفهومين المتعارضين، يُنظر إلى الضحية، على أنها تجاوز للحدود أو “رجس”.
هذه الحالة الشاذة تغرس في الضحية قوة خبيثة محسوسة، وتحوله من مجرد حيوان حقير إلى كائنات شريرة. وغالبًا ما يُنسب إلى الضحايا قدرات خارقة للطبيعة- مثل كونهم أذكياء بشكل شيطاني (اليهود في ألمانيا النازية)، أو أقوياء وعنيفين بشكل خارق للطبيعة (الرجال السود في الخطاب العنصري الأمريكي)- مما يضخم التهديد الجسدي المتصور الذي يشكلونه لمضطهديهم. هذا التضخيم يفسر لماذا تعتبر المجموعة المجردة من إنسانيتها، على الرغم من ضعفها الموضوعي من قبل الجناة، على أنها “خطيرة للغاية”.
الهدف النهائي من نزع الصفة الإنسانية هو إنزال “الآخر” إلى مرتبة أدنى للسماح بالأذى، لكن عدم القدرة على إنكار إنسانيتهم بالكامل يحولهم بشكل مأساوي إلى وحوش، مما يبرر القسوة الشديدة والتدمير.
ثالثًا: صناعة العدو اللدود: القومية، والعرق، والنقاء
إن القومية العرقية التي ترعاها الدولة والأيديولوجيات الشمولية توفر العناصر الأساسية اللازمة لبناء “الآخر”، باعتباره “عدوًا مميتًا يشكل تهديدًا كبيرًا للهوية الإنسانية والأمن والنقاء”.
لقد أرست الثورة الفرنسية الأساس للطموح العالمي والعلماني والشمولي للدولة القومية الحديثة، والتي تطالب باحتكار مطلق للسلطة والتماسك الاجتماعي داخل أراضيها. هذا السعي نحو التجانس الاجتماعي والثقافي، يعني أن الدولة تُخضع جميع الولاءات السابقة (العشيرة، القبيلة، المجتمع) لنفسها، ولا تعترف إلا بـ”المواطن المجزأ”.
القومية التي تُعرف بأنها أيديولوجية، تثير مطالبات مجتمع معين ضد مجتمعات أخرى، وتعمل كمسار أساسي للمذبحة. وعندما يتم حشد الهوية الوطنية من خلال القومية، يتم استخدامها غالبًا لتحديد المجتمع الوطني بطريقة عرقية أو عنصرية حصرية. في ألمانيا، على سبيل المثال، عزز مفهوم حق الدم (المواطنة القائمة على النسب) الاعتقاد بأن المجتمع الوطني يتألف فقط من أولئك الذين يستطيعون إثبات روابط الدم الخاصة بهم فيه، مما أدى إلى استبعاد الآخرين. إن الرغبة في جعل إسرائيل دولة يهودية فقط يعني إقصاء كل المكونات الأخرى التي تتكون منها الدولة كالعرب والدروز.
إن الأيديولوجيات الشمولية، مثل تلك التي دعمت النازية والستالينية ونظام الخمير الحمر والصهيونية اليهودية في إسرائيل، تستغل هذا الدافع القومي من خلال الترويج لمفاهيم النقاء المتطرفة. على سبيل المثال، دافعت النازية عن Volksgemeinschaft (مجتمع آري عرقي) يتميز بالنقاء، بينما سعى الخمير الحمر إلى إنشاء مجتمع خمير نقي عرقيًا. وأي مجموعة تقاوم هذه القوى المتجانسة- أو يُنظر إليها، على أنها تقاوم- تُوصف بأنها “منبوذة، دخيلة، مثيرة للمشاكل”.
التهديد للأمن والنقاء
إن مفتاح خلق العدو اللدود هو ترسيخه كتهديد لـ”هوية المجموعة وأمنها ونقائها”:
1. التهديد الأمني: تفسر الأيديولوجيات المتشددة الأزمات السياسية والصراعات العسكرية من خلال عدسة تضخّم التهديدات الداخلية. وتُتهم الجماعات المستهدفة مرارًا وتكرارًا، بأنها عملاء جماعيون لقوى أجنبية؛ هدفها الوحيد هو تقويض مساعي الدولة المزعومة نحو الاستقلال والخلاص. على سبيل المثال، تم تشجيع الصرب على اعتبار الكروات والمسلمين مسئولين عن ترك “آخر بقايا الأمة الصربية” في كوسوفو، وتصويرهم كتهديد خارجي.
وبالمثل، في الأيديولوجية النازية، ارتبط اليهود باستمرار بالشيوعية الدولية والتمويل، حيث صاغوا الهولوكوست كإجراء أمني ضروري، وفي فلسطين، إن استمرار الفلسطينيين على أرضهم وتمسكهم بها تهديد وجودي لليهود والدولة التي تضمهم.
2. التهديد للنقاء والهوية: غالبًا ما تكون الأنظمة الشمولية مدفوعة بشعور الضحية والرغبة في حل المظالم التاريخية. يتجلى هذا في قناعة مرضية، بأن العدو الخارجي (أو العدو الداخلي المصطنع) يهدد جوهر الأمة أو نقائها. في ألمانيا النازية، اتُهم اليهود، من خلال وجودهم، بـ”تشويه” شعور الشعب بالرفاهية الجماعية والتسبب في “انحطاط البشرية”، واللغة المستخدمة لوصف هذا التلوث، غالبًا ما تكون طبية- يُشار إلى الأعداء باسم “الحشرات الناقلة للأمراض” أو “الميكروبات” أو “الفيروسات” التي يجب التخلص منها لاستعادة الصحة الوطنية.
وهكذا، يُعاد تأطير العنف، باعتباره عملية “تطهير”- وهو إجراء ضروري “لتطهير” الجسم السياسي وضمان وجود الهوية الوطنية النقية.
هذه العملية تحول الاختلاف (العرقي أو الديني أو الطبقي) إلى أمر خبيث، ويصبح الهدف هو اتهام الآخر بارتكاب “جريمة شنيعة، تُعتبر تهديدًا مباشرًا للدولة و”للشعب”، مما يُبرر تصفيته بغض النظر عن عمره أو جنسه أو نشاطه السياسي الفعلي.
رابعًا: تفعيل الإبادة: النشر والتنفيذ
لا يصبح بناء العدو فعالاً، إلا عندما يتم نشر الرواية بشكل منهجي ومؤسسي، وتعبئة تحالف من الجناة. ويتم نشر الأيديولوجيات من خلال “جهاز إعادة الإنتاج” الذي قد يشمل التعليم الصريح والممارسات المؤسسية طويلة الأمد وحملات الدعاية قصيرة الأجل. يلعب المثقفون والأكاديميون ووسائل الإعلام دورًا حاسمًا في توفير المفاهيم والشرعية اللازمة لتحويل التحيز المجرد إلى سياسة.
في رومانيا وصربيا، عمل المثقفون القوميون بشكل منهجي على تعزيز الخصائص العرقية لتحديد هوية أممهم، وبنوا “الآخر” الديني والعرقي، باعتباره تهديدًا مميتًا. زود المثقفون الصرب سلوبودان ميلوسيفيتش بالمواد اللازمة لخلق شعور واسع النطاق بانعدام الأمن والخوف، مؤكدين على التهديد الذي يشكله الكروات والمسلمون، باعتبارهم يخططون لإبادة جماعية مستمرة.
وبالمثل، استبدل الفلاسفة الرومانيون القومية الثقافية بالتركيز على الأرثوذكسية، باعتبارها العنصر الأساسي للروح العرقية الرومانية، ووصفوا اليهود بأنهم “الجسم الغريب” المعادي والتهديد الديني.
تعمل وسائل الإعلام كساحة معركة قوية لرواية الدولة. تُستخدم الدعاية لتوليد أو تغيير التوقعات البنيوية حول المعايير الأيديولوجية، مما يؤدي إلى تشبع الخطاب العام وتوليد إجماع متصور، من خلال جعل الادعاءات التي لا أساس لها، معقولة في السياق الأيديولوجي الصحيح، يمكن لوسائل الإعلام الجماهيرية أن تصوغ بشكل عميق المستويات الفعلية للعنف.
على سبيل المثال، روجت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في عهد ستالين بانتظام لخطاب “المؤامرة المضادة للثورة” و”التخريب” لتبرير القمع. وفي رواندا، تم نشر أيديولوجية الإبادة الجماعية من خلال وسائل الإعلام التي قدمت سردًا متشددًا، باستخدام التعبيرات الملطفة والكلمات المشفرة التي عززت تصور التوتسي كتهديد خطير وشامل.
هذا النشاط الأيديولوجي المستمر، المتضخم عبر أشكال إعلامية مختلفة، يحول المجموعة المستهدفة إلى كتلة متجانسة منزوعة الهوية، تُعرّف فقط بأنها “العدو”.
تحالف الجناة والتبرير
وتتضمن الخطوة الأخيرة في تصنيع العدو الحفاظ على تحالف الجناة، الذي يتألف من النخب السياسية، وعناصر القاعدة الشعبية، والدوائر الانتخابية العامة، ومنتسبي الأجهزة الأمنية.
بالنسبة للعامة، يتم تمكين المشاركة من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك الانتهازية المادية (النهب، والتقدم الوظيفي) وديناميكيات المجموعة (الإكراه، والطاعة، والتوافق). ومع ذلك، فإن حتى الدوافع غير الأيديولوجية عادة ما تكون مغطاة باللغة الأيديولوجية، وتعتمد على الرواية التبريرية السائدة.
الإطار الأيديولوجي يسهل ارتكاب الجرائم من خلال آليات نفسية أساسية:
1. التبرير الأخلاقي: توفر الأيديولوجية مبررًا أخلاقيًا، مما يجعل القتل في بعض الأحيان “ضرورة أخلاقية صريحة” من أجل الصالح العام للمجتمع.
2. الانفصال الأخلاقي: آليات مثل نزع الإنسانية والتباعد الاجتماعي والنفسي، تجعل المشاركة أسهل نفسياً من خلال إزالة الضحايا من الحسابات الأخلاقية. إن المسافة الجسدية والاجتماعية والعاطفية التي يخلقها تقسيم العمل تسمح للجناة بتقليص الضحايا إلى “أهداف” أو “رموز” مجردة.
3. الروتين البيروقراطي: يتم تنظيم الإبادة الجماعية كمهمة تنظيمية وبيروقراطية، وتحويل الأفعال المروعة إلى وظائف روتينية. وبما أن المهام يتم تحليلها وظيفيًا، فإن الجاني الفرد يكون مسئولاً فقط عن جزء فني صغير من التدمير، مما يؤدي إلى نقل المسئولية إلى السلطة أو توزيعها عبر المجموعة. هذا “الإهمال” في الالتزام الصارم بالقواعد والإجراءات، يسمح للأفراد بالتصرف بقسوة باسم الكفاءة دون التعرض لأذى أخلاقي.
تعتمد العملية برمتها، بدءًا من التصور المجرد للتهديد، وصولًا إلى الإبادة الآلية للبشر، على البناء الأيديولوجي لـ”الآخر” ككيان يجب تدميره من أجل بقاء الجماعة ونقائها وأمنها. هذه الآلية بالغة الخطورة؛ لأنها تسمح “للناس العاديين” بإعادة تعريف الواقع، واعتماد المذابح الجماعية كهدف سياسي مشروع، بل ومجيد.
خاتمة
إن خلق العدو، وما يتبعه من تحويل الضحية إلى “وحش بشري”، هو الشرط الأساسي للقتل الجماعي المنظم الحديث. هذه العملية ذات طابع أيديولوجي في جوهرها، مدفوعة بأشكال إقصائية من القومية العرقية والشمولية، وتنفذها الدولة بعنف.
تعمل هذه الأيديولوجية من خلال ست آليات تبريرية رئيسية: بناء التهديد، وإسناد الذنب، وإزالة الهوية، والتخطيط للمستقبل، والتثمين، وتدمير البدائل، والتي تجعل القتل الجماعي مفهومًا للناس العاديين. ومن خلال تعريف المجموعة الضحية كتهديد وجودي للأمن والنقاء، واستخدام نزع الصفة الإنسانية لكسر الحدود بين البشر ودون البشر، تخلق الدولة بيئة داخلية، حيث لا يكون العنف مسموحًا به فحسب، بل ضروريًا لتحقيق غرض عظيم وخلاصي.
وهكذا، تصبح الإبادة الجماعية والقتل الجماعي أو الانتهاكات ضد المعارضين عملاً من أعمال السياسة الأمنية المتطرفة أيديولوجياً، حيث يكون القضاء على العدو المصطنع هو التعريف النهائي، وإن كان منحرفاً، للدفاع عن النفس أو سبيلا لحفظ الدولة أو بقاء واستمرار النظام. ويؤكد السجل التاريخي المأساوي، أنه بدون هذه البنية التحتية الأيديولوجية وقوة الدولة لفرضها، فإن القسوة الوحشية للإبادة والقتل الجماعي واستباحة المعارضين ستظل، بالنسبة لمعظم الناس، غير قابلة للتطبيق نفسياً وسياسياً.
أهم المراجع:
1. Timothy Williams, The Complexity of Evil: Perpetration and Genocide (Rutgers University Press, 2021)¹⁸.
2. David Livingstone Smith, Making Monsters: The Uncanny Power of Dehumanization (Harvard University Press, 2021)¹⁹.
3. Mark Levene, Genocide in the Age of the Nation State I: The Meaning of Genocide (I.B. Tauris & Co., 2008)²⁰.
4. Uğur Ümit Üngör (Editor), Genocide: New Perspectives on its Causes, Courses, and Consequences (Amsterdam University Press, 2016)²¹.
5. Terry Stafford, Deadly Dictators: Masterminds of 20th Century Genocides (Self-published, 2010)²².
6. Pankaj Mishra, The World After Gaza (Juggernaut Books/Fern Press, 2025)²³.
7. Omar El Akkad, One day, everyone will have always been against this (Alfred A. Knopf, 2025)²⁴.